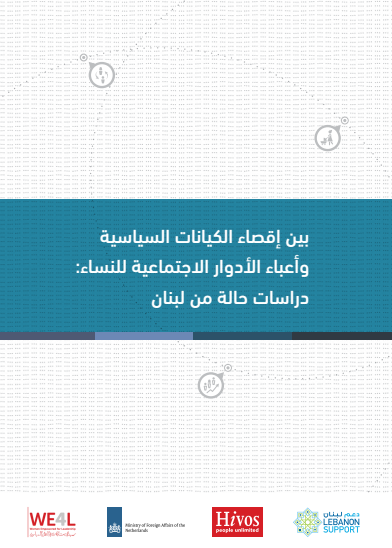
بين إقصاء الكيانات السياسية وأعباء الأدوار الاجتماعية للنساء: دراسات حالة من لبنان
ملخّص
في إطار النظام السياسي اللبناني الذي يقوم على المحاصصة الطائفية والعائلية السياسية والزبائنية المتمثلة في نظام الزعامة، والذي يعزز من الأبوية القائمة علىالقرابية، تسعى هذه الدراسة إلى فهم وتحليل مشاركة النساء في مواقع قيادية وقاعدية في أربعة كيانات في لبنان تتضمن حزب سياسي، نقابة، منظمة مجتمع مدنيوحركة اجتماعية.تفحص الدراسة الهياكل والبنى المؤسسية لتلك الكيانات ومواقفها من قضايا النساء، والديناميات التي تعتمدها للتفاعل مع محيطها، وذلك من خال تحليلوثائقها الرسمية، خطابها العام، ممارساتها، وأخيراً تجارب النساء المنتميات لها وما عايشنه من تحديات ضمن هذا الإطار.
فريق العمل
باحثات ومستشارات دعم لبنان
منار زعيتر وسارة المصري
مساعدي البحث
إحسان إسماعيل ومصطفى عاصي
مديرة المنشورات
ليا يمين
مديرة
د. ماري نويل أبي ياغي
تصحيح لغوي وترجمة
فيفيان قصرملّي سلّوم
تخطيط وتصميم
ميرنا حماده
مركز دعم لبنان يشكر الزملاء والزميلات أدناه مشاركتهم/ن في إنتاج هذه الدراسة:
د. إصلاح جاد، دورين خوري
سيّدات مشاركات في العمل السياسي)سمع( هو برنامج لمنظّمة هيفوس مع شركاء
محليّين في ٥ دول: ماوي، زمبيا، زمببوي، الأردن ولبنان.
تعبر وجهات النظر الموجودة في هذه المطبوعة عن آراء المؤلفات ولا تعكس بالضرورة
وجهات نظر دعم لبنان أو شركائه.
Lebanon Support © Beirut, ٢٠١٨
لا يجوز نسخ أي جزء من هذه المطبوعة أو توزيعها أو نقلها بأي شكل أو وسيلة، وهذا يتضمن النسخ الضوئي أو التسجيل بالوسائل الميكانيكية أو الإلكترونية، من دونإذن خطي من الناشر، إّلا في حال الإقتباس الموجزأو الإشارة المرجعية في المقالات والمجات والمنشورات النقدية، والاستخدامات غير التجارية الأخرى المجازةبموجب قانون حقوق النشر.
مقدمة
اهتمّت أدبيات عديدة بدراسة الفجوة بين مستويات المشاركة السياسية للرجال والنساء، وكذلك العقبات والتحديات التي تواجهها النساء في المشاركة السياسية خاصة فيالسياق الأوروبي ونظيره الأمريكي، وكذلك في سياق الديمقراطيات الناشئة في أمريكا الاتينية. يمكن تقسيم أهم التفسيرات التي خلصت إليها تلك الأدبيات إلى مجموعةتتناول العوامل المتصلة بالفرد مثل الفرق في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والوظيفي )فمثلاً غالباً ما يمكن للرجال الحصول على وظيفة بدوام كامل ممايزيد من مواردهم الاقتصادية الضرورية للترقي في العمل السياسي، في حين يصعب ذلك على النساء بشكل عام( 1؛ ومجموعة ثانية تفصّل الأسباب الهيكلية والمؤسسي المرتبطة بالأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية مثل نوع النظام السياسي، مستويات التصنيع والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى العوائق الثقافية التي تؤثرعلى التصورات الاجتماعية للمرأة وأدوارها 2
ولكن يقل وجود دراسات مماثلة في سياق دول الشرق الأوسط وبالأخص في لبنان، نظراً لصعوبة توافر البيانات المسحية الدقيقة بشكل دوري. وبالرغم من إحرازالمرأة في لبنان معدلات عالية في التحصيل العلمي والمشاركة الاقتصادية 3 واكتسابها العديد من الحقوق السياسية 4 والاقتصادية والاجتماعية 5، إلا أن مؤشراتالمشاركة السياسية للمرأة في لبنان 6 تشير إلى أنها ما زالت غير قادرة على اختراق “السقف الزجاجي” 7 في السياسة. وتبعاً لذلك، فقد برزت الحاجة لدراسة هذهالظاهرة في العقود الأخيرة، ولكن جاءت معظم الدراسات تركز على موضوعات مثل ترشح النساء في الانتخابات البرلمانية أو البلدية 8 من خال الأحزاب السياسيةالمتشكلة هوياتها طبقاً للنظام السياسي الطائفي، من دون التوسع لدراسة مشاركتهن السياسية من خال كيانات غير حزبية أو حتى مشاركتهن في السياسية بأشكال غيرتقليدية )غير رسمية(.
من هنا تأتي الدراسة الآتية لتبني على تلك الأدبيات ولتحاول الإجابة على سؤال أساسي وهو: “ما هي التحديات والعقبات التي تواجهها النساء عند المشاركة في الفضاءالسياسي في لبنان؟”. وعليه تتبنى تعريفاً عاماً للمشاركة السياسية وهو “النشاط الذي من شأنه التأثير على عمل الحكومة بشكل مباشر بفعل تطبيق السياسات العامة أوبشكل غير مباشر عن طريق التأثير على مجموعة الفاعلين الذين يصنعون هذه السياسات” 9 يأخذ هذا التعريف – وتبعاً له الدراسة - في الاعتبار أن المشاركةالسياسية لم تعد حبيسة تعريف جامد قائم على ثنائية أنها إما أن تصير على المستوى الرسمي )مثلاً من خال الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني( 10 أو على مستوىالقاعدة الشعبية )مثلاً من خال الحركات الاجتماعية(، وتعترف أن المشاركة السياسية للنساء – بالأخص - يمكن أن تأخذ أشكالًا متنوعة بين ، ما هو تقليدي )من خالخوض الانتخابات مثلاً( وما هو غير تقليدي )من خال التظاهر والحركات الاحتجاجية( 11 لما هو “سياسي”12 كذلك تأخذ (androcentric definitions) وتتحدى التعريفات الذكورية المتحيزة ضد المرأة الدراسة بعين الاعتبار أن تنوع أشكال هذه المشاركة يتغير بحسب إختلاف خلفيات النساء الطبقية والدينية، كون النساءمجموعة غير متجانسة وتخضع تجاربها في التفرقة لتقاطعية محاور مختلفة مبنية على النوع الاجتماعي والطائفة والطبقة 13
في إطار النظام السياسي اللبناني الذي يقوم على المحاصصة الطائفية 14 والعائلية السياسية 15 والزبائنية المتمثلة في نظام الزعامة 16 ، والذي يعزز من الأبويةالقائمة على القرابية 17 ، تسعى الدراسة - بمقاربة استكشافية - إلى تحليل مشاركة النساء في مواقع قيادية وقاعدية في أربعة كيانات في لبنان تتضمن حزب سياسي،نقابة، منظمة مجتمع مدني وحركة اجتماعية. تفحص الدراسة الهياكل والبنى المؤسسية لتلك الكيانات ومواقفها من قضايا النساء، والديناميات التي تعتمدها للتفاعل معمحيطها، وذلك من خال تحليل وثائقها الرسمية، خطابها العام، ممارساتها، وأخيراً تجارب النساء المنتميات لها وما عايشنه من تحديات ضمن هذا الإطار. ينطلق هذاالتحليل من فرضية أن تواجد النساء في مواقع قيادية مهمة ومناصب بارزة بالنسبة للجماهير من الأرجح أن يزيد من إيمانهم )رجالًا ونساءاً( بأن النساء قادرات علىالحكم واتخاذ القرار السياسي 18 ، وأن يساهم ذلك في تحقيق المساواة الجندرية على المدى البعيد19
منهجية الدراسة
نظراً لما ذُكر آنفاً، إن الدراسات التي تستقصي عن المشاركة السياسية للنساء في لبنان في كيانات غير حزبية نادرة، وعليه فإن الدراسة التالية تتبع مقاربة استكشافيةتعتمد منهجية دراسة الحالة وتستخدم أساليب البحث النوعي في جمع المعلومات عن كيانات أربع تم اختيارها منها: حزب سياسي وثاثة كيانات غير حزبية منها نقابة،منظمة مجتمع مدني وحركة اجتماعية. تنوعت هذه الأساليب ومن ضمنها إجراء مقابات معمّقة )خمس وثاثون مقابلة(، وتنظيم مجموعات مركزة )سبع مجموعات( بينيوليو ٢٠١٧ حتى أبريل ٢٠١٨ . شملت المقابات عدداً من المعنيين/ات والفاعلين/ات ضمن هذه الأطر الأربعة، وكذلك مجموعة من الخبراء المختصين/ات في دراسةالنشاط السياسي والعمل النقابي في لبنان.
بشكل متوازٍ، تضمنت المجموعات المركزة على قيادات وعضوات على المستوى القاعدي في هذه الكيانات، تم اختيارهن طبقاً لمجموعة من المعايير أهمها تنوعأدوارهن داخل هذه الأطر، فئتهن العمرية، خلفيتهن الاجتماعية والاقتصادية، والمناطق الجغرافية - مثلاً شمال لبنان أو الجنوب - التي يعملن فيها من خال هذه الكيانات. كان الهدف من وراء هذا التنوع محاولة التعرف على مختلف التحديات والعقبات التي تعيشها النساء أثناء مشاركتهن السياسية والتي يفترض تباينها طبقاً لهذه المعايير. قام عمل البحث الميداني على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولي المقابات وثاثة مجموعات مركزة، أما المرحلة الثانية فشملت أربع مجموعات مركزة وكان الهدف منهاجمع معلومات أكثر تفصيلاً عن الحالات الأربعة. بعد الانتهاء من العمل الميداني، تم تفريغ محتواه بالكامل، وثم تحليله من خال عملية ترميز نوعية وتصنيف بهدفالوصول إلى أهم الاتجاهات المكررة.
أما في ما يتعلق باختيار الكيانات الأربع، فقد تم استناداً إلى تواجد عدد كبير من النساء في هيكلها المؤسسي حتى ولو على المستوى القاعدي فقط، أو ما ترفعه منشعارات وما تنادي به من دعوات لتغيير أسس المشاركة السياسية للنساء في لبنان. فأتى اختيار “حزب القوات اللبنانية” بسبب المواقف التشريعية التي اتخذها الحزبوالمتمثلة في تبني العديد من قضايا النساء داخل اللجان النيابية وتقديم اقتراحات قوانين بغرض تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في لبنان، بالإضافة إلىتعيين شخصية نسائية هي الدكتورة شانتال سركيس أمينة عامة للحزب في العام ٢٠١٦ وهو ما يندر حدوثه في السياق الحزبي اللبناني.
وفي ما يخص الحركات الاجتماعية، تم التركيز على حملة “طلعت ريحتكم” من ضمن الحمات التي شاركت في الحراك الشعبي المطلبي للعام ٢٠١٥ في لبنان، أو مابات يعرف ب “حراك المجتمع المدني”. اختيرت الحملة لحضور ومشاركة النساء بها بشكل ظاهر على الأرض وفي الإعام، وبسبب المطالب التي رفعتها بعضمجموعات الحراك حول المرأة )سنعرض ذلك بشكل تفصيلي في القسم الثاني من الدراسة(.
ومن المنظمات غير الحكوميّة وقع الاختيار على “الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً”، استناداً إلى كونه ترأسه قيادية نسائية مما يدعو إلى تحليل انعكاس ذلكعلى المنظمة. وأخيراً، اختيرت “نقابة المعلمين” بسبب التواجد الكبير للنساء في عضوية النقابة بمقابل غيابهن عن تولي مواقع في قيادة النقابة.
تفرض طبيعة منهجية “دراسة الحالة” بعض المحددات، التي يجب أخذها في الاعتبار عند قراءة الاستنتاجات المستنبطة من هذه الدراسة. أولًا، تعتمد دراسة الحالةكغيرها من أساليب البحث النوعي على ذاتية الباحث/ة وقدرته/ها على قراءة متغيرات الواقع المدروس، وغالباً ما تتسبب هذه الذاتية في اختاف تحليل أسباب ظاهرة مامن باحث/ة إلى آخر، وتصّعب من قدرة الباحثين/ات الآخرين على استخدام منهجية البحث لدراسة ظواهر أخرى. ثانياً، لا تقوم طريقة اختيار حالات دراسة الحالة علىأخذ العينات العشوائية الممثّلة – وهي الخطوة الأكثر شيوعاً في الدراسات الكمّية - مما يجعلها أكثر عرضة لاستخدام في تأكيد انحيازات الباحث/ة نظراً لاختيار عيناتأو حالات تتواجد فيها عامات الظاهرة المراد دراستها. أخيراً، هناك محدودية متأصلة في دراسة الحالة، فهي منهجية لا يمكن من خالها تعميم استنتاجاتها على عدد أكبرمن الحالات الشبيهة. ولكن الهدف من دراسة الحالة الحالية ليس التعميم بقدر ما هو الكشف عن ماهية وكيفية معايشة النساء لتحديات مشاركتهن السياسية في الكياناتالمختارة وغيرها من الكيانات التي تتبنى هياكل أو ممارسات مشابهة؛ إي أن الهدف هنا هو القدرة على التعميم التحليلي وليس التعميم الإحصائي.
أولًا: حزب القوّات اللبنانيّة: تكريس الإطار العام للسياسة اللبنانية؟
١( من العسكرة إلى السياسة: أدوار حزبيات القوات
في حين أن الأحزاب السياسية تُعد واحدة من أهم القنوات التي تمّكن المرأة لاختراق المجال السياسي 20 لم تكن الأحزاب اللبنانية - تاريخياً - مكاناً مرحباً بالنساء 21. قبل استقال لبنان، كانت عضوية الأحزاب السياسية مقتصرة على الرجال، أم بعده فبدأت مشاركة النساء تزداد في المجال العام وعلى إثرها الحياة السياسية الحزبيةنتيجة نشاط الجمعيات النسائية وأجيال من النسويات الأوائل 22 . وبالرغم من تفاعل عدداً من الأحزاب اللبنانية مع نظرائها دولياً 23 على مشارف الحرب الأهليةاللبنانية، إلا أنها احتفظت ببعض السمات، أهمها الالتزام بالنظام اللبناني السياسي المتمحور حول الطائفة وسلطة الزعماء، بالإضافة إلى تشاُرك معظم هذه الأحزاب فيالنزاع المسلح والعمل العسكري 24 ؛ على رأسها حزب القوات اللبنانية.
نشأت “القوات اللبنانية” عام ١٩٧٦ إثر قرار توحيد الأحزاب المسيحية تحت قيادة بشير الجميل ولواء تحالف “الجبهة اللبنانية”، كحركة تشكل الذراع العسكري لهذهالجبهة 25 . في نهاية العام ١٩٨٠ ، أضحت القوات أكثر. تماسكاً ككيان عسكري بعد خروج بعض المليشيات المسيحية الرافضة لسلطتها وتوسعها. مرّت بعد ذلكبتحولات عديدة أهمها التركيز على العمل العسكري حتى عام ١٩٩٣ ، ومن ثم التركيز على العمل السياسي. اعتمدت القوات على عاقتها الوطيدة مع طلبة الجامعاتوالمدارس - التي قويت عبر اللقاءات داخل الجامعات 26 - فجاء تجنيدها للطلبة من الفتية والفتيات واخضاعهم/ن لتدريبات عسكرية عامة وأخرى متخصصة حتىتخرّج من نظام تجنيدها مقاتلين ومقاتات 27 . وتزامناً مع العمل العسكري، توفر القوات اللبنانية الخدمات المدنية والاجتماعية من صحة وتعليم ونقل، الأمر الذي جعلمنها، مع مرور الزمن، حركة سياسية ذات قاعدة اجتماعية 28 - خاصة في المناطق التي تتحكم بها 29 . كان للهيكل المؤسسي للقوات وخطابها أثناء فترة العمل العسكري تأثيراً قوياً على عضواتها من النساء اللواتي عاصر بعضهن تلك الفترة، حتى انتهت الحرب وتحولت القوات إلى حزب سياسي عام ١٩٩٣
وفق تعبير الحزبيات اللواتي تمّ مقابلتهن تولّت القوات “مهمة الدفاع عن الأرض وتعزيز الارتباط بالوطن” في تلك الحقبة من تاريخ لبنان، وهي مهمة جعلت من القتالوالاستشهاد من أسس هوية القوات ومَن ينضم إليها 30 . وعليه فقد جاء انضمامهن للقوات من باب الوفاء للشهداء والجرحى، وهي قيم لطالما دعمها الحزب وثمّن عليهافي خطاباته الرسمية 31 . تصف إحدى الحزبيات هذا السياق بالقول: “عندي أقارب مستشهدين بالقوات وانا أكيد مش أحسن منهم. شبابنا واجهوا الموت وأقل شيء هواستكمال المسيرة” 32 . عزز من قيمة الوفاء للشهداء لدى أولاء الحزبيات نشأتهن في عائات انضم معظم أعضائها للقوات -كميليشيا أولًا وبعد تحولها لحزب سياسيلاحقاً - فقد عرفن هؤلاء الشهداء شخصياً، وواكب كثير منهن تولي آبائهن وأقربائهن أدوار عسكرية، فتخبر إحدى القياديات عن هذا الموضوع: “أنا اعرف القوات منذكان عمري تسع سنوات، أثناء الهجوم على زحلة عندما بدأت الناس تتسلح وأصبح بيتنا مثل الثكنة” 33 . وأخيراً، بعد أن تحولت القوات إلى حزب عام ١٩٩٣ ، جاءالتقدير الذي تحملنه أولاء الحزبيات لشخص رئيس الحزب سمير جعجع، ليكون أحد الأسباب التي حفزتهن على الانضمام للحزب والاستمرار في عضويته حتى اليوم. فمع نهاية الحرب أصبحت القوات حزباً، ولكن سرعان ما تمّ حله عام ١٩٩٤ ومنع نشاطه، واعتُقل جعجع واتُهم بارتكاب جرائم حرب، وسُجن لمدة ١١ سنة من دونسواه من أمراء الحرب في لبنان 34 . تعرُض “الحكيم” 35 لتجربة الاعتقال زاد من تقديره لدى المنتمين/ات للقوات الذين رأوا منه طوال مسيرته عدم تهاون وثبات فيمواقفه السياسية، وشكّلت تجربته أحد أبرز حوافز الانضمام والاستمرار مع القوات. فالحزبيات اللواتي تمّ مقابلتهن استذكرن تفاصيل تطال جوانب شخصية الحكيم،وكيفية تعامله مع المواقف وصموده أثناء مرحلة الاعتقال وخطاباته التي أعطتهن أماً، بالرغم من التضييق الذي تعرض له على المستويين الشخصي والعام.
وعليه فقد هيأت وقائع الحرب وما نتج عنها من العوامل السابق ذكرها - الانتماء العائلي للقوات والرغبة في الوفاء للشهداء والتأثر بتجربة جعجع - نساء القوات للقيامبأدوار في إطار العسكرة التي فرضتها المليشيات على واقعهن الاجتماعي 36 . فقد رأت الحزبيات اللواتي تم مقابلتهن أن العسكرة كانت أمراً طبيعياً و”ضرورة للدفاععن الوجود”؛ هذا الوجود اختلفت معانيه بالنسبة لهن فبعضهن ترجمه للطائفة، والبعض الآخر للدين، وعليه رأين أهمية مشاركتهن وأدوارهن في هذا الإطار 37 . وبحسبهن تنوعت هذه الأدوار من كونها رعائية وخدماتية - اتسقاً مع الأدوار التقليدية للنساء - مثل الطهي، تأمين المواد الغذائية للقرى، توفير الإسعافات الأولية، توليالاتصالات والإعام والمهام الإدارية، وإدارة دور رعاية الأطفال. تطورت هذه الأدوار تدريجياً بداية بالمشاركة في أعمال الحراسة 38 ، مروراً بتدريب النساء علىتنظيف وتذخير واستخدام الساح الخفيف أولًا لتمكينهن من الدفاع عن النفس ووصولًا إلى اشتراكهن في العمليات القتالية 39 . وتسرد الحزبيات تجربة “النظاميات” بكونها أبرز ما يميز تلك الحقبة، وهي فرقة من النساء اللواتي تدربن على القيام بالدور العسكري المباشر عبر القيام بأدوار قتالية ميدانية 40 . الجدير بالذكر في مايتعلق بالنظاميات، هو عودة معظمهن لأداء المهام التقليدية للنساء فور انتهاء الحرب، بالنسبة لهن دورهن العسكري كان “مؤقتاً” 41
نتج عن نشأة الحزب وهويته وعمله العسكري “ضعفاً في وجود النساء في المواقع القيادية” 42 ، فالعمل العسكري يربط بشكل أساسي بين فكرة “الذكورة” و”الحرب”،وكيف أن الحرب هي ساحة لممارسة العنف والقتل يصبح من خالها الذكور “رجالًا” ويلقى عليهم بمسؤولية الدفاع عن الأمة أو الطائفة أو الحزب 43 . كذلك تتجلىتصورات الحزب عن العمل العسكري في تقرير مصور يوثق الحزب من خاله تاريخه العسكري والحروب التي خاضها ودورات تخريج المقاتلين، ونجد فيه غيابتوثيق مشاركة النظاميات، بل تظهر فيه النساء كضحايا للحرب يطلبن الدعم والحماية 44 . الاستثناء الوحيد هو ما يرد عن الدور الذي لعبته السيدة ستريدا جعجع – زوجة رئيس الحزب - من أجل تماسك الحزب أثناء وجوده في السجن.
يتوافق هذا التصوير مع الصورة النمطية العامة للنساء خال الحروب والنزاعات بوصفهن “ضحايا” لا فاعات أو مؤثرات، وكذلك مع كون حزب القوات كغيره منالأحزاب اليمينية لم يسعَ لرؤية أدوار النساء في إطار بديل عن الإطار التقليدي لأدوارهن الرعائية، ولم يحاول صياغة مطالب خاصة بالنساء في ذلك الوقت، بل كانتأدوار النساء تخدم الأهداف العسكرية، وهو أمر يتفق مع الأطر العامة المحافظة التي تعمل من خالها الأحزاب اليمينية في مختلف السياقات السياسية 45
٢( “مرحلة الاعتقال”: أدوار أكبر للنساء؟
مع انتهاء الحرب الأهلية في لبنان عام ١٩٩٠ ، قامت النساء بأدوار متنوعة سواء على مستوى النضال الطابي أو العمل ضمن مؤسسات الحزب الإعامية والبحثية. كماعزز الحزب خال هذه المرحلة الانتقالية - ما بين انتهاء ١٩٩٤ ) - الوعي السياسي للحزبيات عن طريق دورات الإنماء الفكري، - الحرب الأهلية واعتقال رئيسالحزب ( ١٩٩٠ والتي اتخذت مسميات “دورات الأركان” و “دورات الطائع” 46 . ولكن لم تستمر هذه المرحلة طوياً، إذ شهد الحزب حادثاً مفصلياً في تاريخه، وهواعتقال رئيسه سمير جعجع في ١٢ نيسان/ أبريل ١٩٩٤
جاء اعتقال جعجع في إطار موجة تضييق من قبل السلطات اللبنانية على حزب القوات تضمنت توقيف رموز حزبية وإحالتها للقضاء المدني والعسكري، وماحقةعناصر مصلحة الطاب، مداهمة لمقاّر القوات وطرد الحزب من مقره الرئيسي في الكرنتينا 47 . انعكس هذا التضييق على الأدوار التي لعبتها النساء فخلق فرصاًجديدة لمشاركتهن بأدوار لم تكن متاحة أمامهن من قبل، وهو ما يتفق مع الأدبيات المتعلقة بمشاركة النساء في الحراك الثوري أو المسلح 48 . قيد التضييق الأمني قدرةالرجال على التحرك، الأمر الذي شكل العامل الأبرز في التوسع النسبي لمساحة أدوار النساء خال تلك المرحلة وفق ما تستعرضه الحزبيات 49 . فقد تولت سبعضابطات إداريات مسؤوليات عسكرية منها الحماية الشخصية لزوجة رئيس الحزب ولقاء الحزبيين في المناطق وتوزيع المساعدات على عائات المعتقلين 50 . بالتازممع ذلك، انخرطت النساء في مستويات متنوعة من العمل الحزبي منها العمل الطابي شبه السري في الجامعات والنوادي الثقافية والرياضية ودفاع المحاميات عنالمعتقلين. يضاف إلى ذلك العمل الميداني المباشر من خال توزيع المنشورات والمشاركة في المسيرات، وتنظيم تحركات الاحتجاج والمظاهرات، والمواجهة مع القوىالأمنية مباشرة في الشارع 51
لا يمكن قراءة أدوار النساء خال مرحلة الاعتقال ) ١٩٩٤-٢٠٠٥ ( خارج سياق مامح تلك الفترة التي تولّت فيها زوجة رئيس الحزب ستريدا جعجع المسؤولية الأولى في الحزب وساهمت وفق تعبير مسؤول حزبي في“الحفاظ على تماسك الحزب واستمراره” 52 . وهناك إجماع من قبل مختلف مَن التقينا بهم على امتاك السيدة جعجع كل العوامل الذاتية الخاصة التي مكنتها من القيامبهذا الدور القيادي إضافة إلى وجود بيئة حاضنة وداعمة لها من بعض الحزبيين. مقابل هذا الدعم، واجهت السيدة ستريدا جعجع تضييق من جهات رسمية ومنشخصيات حزبية رفضت تولي امرأة موقع القيادة باعتبارهم أحق بتولي رئاسة الحزب. وأدى الدور المتصاعد لبعض الحزبيات لامتداد التضييق الأمني والسياسيوالماحقة القضائية إليهن، وقد كانت تجربة اعتقال أنطوانيت شاهين - عام ١٩٩٤ - التي عذبت في سجنها المثال الرئيسي الذي أشارت إليه مَن تحدثنا معهن من نساءالحزب، فقد رأين حالتها شاهدة على التنكيل الذي لحق ببعض نساء القوات نتيجة دورهن المتزايد في تلك الفترة 53
على الرغم من الدور الذي لعبته زوجة رئيس الحزب، ومن توسع مشاركة النساء التي سبق عرضها، إلا أن هذا لم ينعكس على صعود عدد أكبر من النساء لأدوارأساسية في العمل السياسي الحزبي، وكذلك لم تحتل قضايا النساء أولوية على أجندة الحزب. يحيل مسؤولون في الحزب هذا الأمر إلى انشغال الحزب بقضايا أكثرأولوية مثل “الاحتال السوري ووجود رئيس الحزب في السجن”54 . ولكن اليوم وبعد انتهاء هذه الظروف السياسية لا تبدوا الصورة كثيرة الاختاف، ويستمر وجودتفاوت بين تصدير الحزب لنفسه حزباً داعماً ومناصراً للمرأة وقضاياها، من دون أن ينعكس هذا على أوضاع النساء داخله كما ستوضح الأقسام التالية.
٣( بنية حزبية تعرقل ترقي النساء سياسياً
أعلن الحزب برنامجه ونظامه الداخلي عام ٢٠١٢ ، الأمر الذي أعطى أماً بولادة فرصاً أكبر للتفاعل مع قواعد شعبية أوسع وربما فرصاً أكبر أمام النساء. فوفقاً لإحدىالحزبيات: “الحزب صار سياسياً، هذا يعني التواصل معكل الناس، وأن لا يبقى خارج القرار ]السياسي الوطني[”55 . ولكن حتى اليوم تظل نسبة تواجد النساء فيقاعدة الحزب لا تتخطى الثاثين في المئة، وتتفاوت مسؤولياتهن ما بين العمل ضمن مصلحة الطاب إلى تولي مسؤولية الأمانة العامة للحزب؛ وهو الموقع الأول علىالمستوى الإداري والتنظيمي. بين هذين الموقعين تتنوع فضاءات العمل داخل الحزب لتشمل قطاع المصالح الذي يضم العاملين في مهن نقابية )مثل الأطباءوالمصرفيون(، جهاز الشؤون الاجتماعية، جهاز الشهداء والجرحى والمصابين، جهاز تفعيل دور المرأة الذي تتولى النساء عضويته ومسؤوليته بالكامل. كما تتولىبعض الحزبيات مسؤوليات في بعض المكاتب وأبرزها مكتب السياسات العامة، ومكتب العاقات مع الأحزاب الخارجية. على الرغم من تولي النساء مسؤولية هذهالمواقع، إلا أن معظم هذه المواقع يكرس للصورة النمطية والأدوار التقليدية للمرأة )أجهزة ذات عاقة بأدوار النساء الرعائية مثل جهاز الشهداء، مهام تتطلب تواصلإعامي، أو توفير الخدمات الاجتماعية(، بعيداً عن مواقع “صنع القرار السياسي” )مثل المواقع ذات الصلة بالترشيحات الانتخابية ورئاسة بعض المكاتب السياسية(. لاينفي هذا أهمية تواجد النساء في القواعد والمستويات الوسيطة للإدارة، ولكن يسجل فقط غيابهن بشكل ملحوظ عن مواقع اتخاذ القرار السياسي.
كذلك يجدر ذكر ضعف تواجد النساء في المواقع التي تتطلب مهام ميدانية مثل “مسؤولة منطقة” و”مسؤولة مركز” وهى أدوار محورية لعمل الحزب وبناء قاعدتهالشعبية؛ فوفقاً للنظام الداخلي للحزب، المنطقة هي هيئة حزبية لامركزية نطاقها هو القضاء في التنظيم الإداري للدولة اللبنانية 56، أما المركز فهو يشكل الوحدةالأساسية في بنية الحزب الامركزية الجغرافية 57. تحيل الحزبيات الأمر لعدم مائمة المسؤوليات التي تقتضيها هذه المواقع مع وضعية النساء الاجتماعية والتزاماتهنالأسرية. تروي إحداهن: “كل الشغل يقع على رئيس القسم وهو على احتكاك بالناس، يدخل على المنازل، ويستقبل الأشخاص في أي وقت لتلبية طلباتهم. وهذا الموقعليس سهاً على المرأة”58 . فبالنسبة للعضوات وكذلك القيادات الحزبية، المسؤوليات الميدانية تستدعي الكثير من العمل الدؤوب مع القاعدة الحزبية في المناطق، وهوأمر يتطلب وقت وتفرغ لا يتوفر بالضرورة لدى النساء الحزبيات اللواتي يتحملن مسؤولية أسرة بجانب عملهن الحزبي. وعليه، فكثيراً ما تنسحب النساء من العملالحزبي عند الزواج وتأسيس أسرة بسبب ضعف الدعم والتضامن من جانب الأسرة وجراء الأعباء التي يفرضها الدور الإنجابي. وتخبر إحداهن “أنا أشارك بفعالية لأنيعازبة، لو كنت متزوجة لتغير الأمر”59 . تتفق تعليقات حزبيات القوات جزئياً مع ما نعرفه مسبقاً من دراسة تأثير عوامل مثل بناء الأسرة وعاقات القوة داخلها بينالأزواج والزوجات، فالأخيرة وجدت تأثيراً إيجاباً لاستقالية المادية للأزواج وما يستتبعها من استئثار في قرارات الأسرة على نشاطهم السياسية وقدرتهم على مراكمةالخبرة السياسية60
كذلك أضفن أن هذه المواقع ترتبط “بالانتخابات”، ومن المفضل أن يتواجد فيها أفراد تقبلهم القاعدة الشعبية للحزب؛ وهم في معظم الحالات من الرجال. يؤثر ذلك با شكعلى ضعف تراكم خبرة النساء السياسية، وعلى بناء أرضية سياسية تؤهلهن للعب أدوار تمثيلية في مراحل لاحقة من العمل السياسي. ولم يتخذ الحزب أية مبادراتلتعديل هذا الواقع، باستثناء وجود توجه مبدئي من الأمانة العامة يقضي “بالطلب من منسقي المناطق تعيين نساء في اللجان وإعطائهن أدواراً قيادية على مستوىالمناطق”61 ، وهو أمر لم يُشرع في تنفيذه بعد. على مستوى الانتخابات البلدية التي تشكل محطة أساسية في الحياة السياسية اللبنانية، ليس هناك رقماً واضحاً لنسبةالنساء المرشحات أو الفائزات الحزبيات الممثات للحزب 62. تزعم قيادة الحزب دعمها ترشيح النساء في الانتخابات البلدية الأخيرة، ولكن هذا الدعم كان مقيداً فيالمناطق التي غلبت عليها التحالفات بين الأحزاب اللبنانية المختلفة والتي تتم بناءً على توازنات طائفية بالأساس، حيث الأولوية للتسويات السياسية والحصول علىالمقاعد. كذلك في الدوائر التي يضطر فيها الحزب لعقد تحالفات مع قوى سياسية أخرى، إن الأولوية بحسب جميع مَن التقينا بهم هي صياغة تحالفات تنعقد لمصلحةالحزب بالدرجة الأولى إذ “لا يمكن المخاطرة بالمقعد”63
أما على مستوى التمثيل البرلماني، شارك حزب القوات اللبنانية في الندوة البرلمانية وفي غالبية الحكومات بعد خروج الدكتور سمير جعجع من السجن. ضمّت كتلتهالبرلمانية طيلة السنوات الماضية - وحتى في برلمان ٢٠١٨ الجديد - امرأة واحدة هي النائب ستريدا جعجع، فيما لم تختر القيادة أية امرأة لمنصب وزيرة في السلطةالتنفيذية. وينعكس ذلك الواقع داخلياً على مستوى تمثيل النساء في عضوية الهيئة التنفيذية التي تضم رئيس الحزب والوزراء والنواب، ويطرح سؤالًا عن مدى جدّيةالحزب والتزامه بدعم تمثيل المرأة بعيداً عن العائلية السياسية التي يشير إليها تواجد ستريدا جعجع الدائم ضمن الكتلة البرلمانية.
وفي سياق متصل لم يتخذ الحزب أية إصاحات بنيوية من شأنها تعزيز مشاركة النساء داخلياً. يبدو ذلك جلياً في عدم طرحه رؤية واضحة من الحصص )الكوتا( النسائيةعلى سبيل المثال )أو حتى تبنيها على مستوى القوانين الانتخابية البرلمانية والبلدية(. تعزي مسؤولة حزبية ذلك نتيجة الخاف داخل الحزب، فهناك موقفان: الأول رافضلتبنيها ويؤيد اعتماد الحزب على معايير الكفاءة في الترقي السياسي وليس النصاب العددي، والثاني يدعو إلى تبنيها كإحدى آليات تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة 64. ولكن يبقى موقف الحزب ثابت بالرفض على المستوى الداخلي، ومحايد على المستوى العام، فإن الحزب أعلن عدم نيّته الدفاع أو الاعتراض على الكوتا، خوفاًمن تضييع فرص التوافق والتسوية السياسية بعد امتداد الأزمة السياسية لسنوات والتمدي . المتعاقب للمجلس النيابي65
كذلك تغيب النساء عن المشاركة في صياغة الوثائق الخاصة. تعبر الحزبيات عن أن كتابة النظام الداخلي للحزب تولاه رجال كانت أولوياتهم كتابة نظام حزبي فحسبمن دون التفكير بقضايا النساء )مثل تعرض النساء للعنف أو التحرش الجنسي(. وعليه فقد جاء النظام الداخلي خالٍ من أي تدابير تكفل حماية النساء والفتيات الحزبياتفي حال حدوث أي انتهاكات مبنية على أساس النوع الاجتماعي. ولكن اختلفت الحزبيات بين مَن يؤكدن حدوث انتهاكات ووجوب توفير نص حمائي بدلًا من الاعتمادعلى قيم الدين المسيحي كضمانة لمنع حدوث حالات تحرش جنسي - وهو المسار الذي يتبناه الحزب اليوم - وأخريات ينفين وجود هذه الحوادث من الأصل داخلالحزب 66
وأخيراً، نجد داخل الحزب جهاز تفعيل دور المرأة الذي حلّ محل “لجنة المرأة”، من دون هيكلية واضحة بالرغم من وضع خطة خاصة به في العام ٢٠١٧ . يركزالجهاز عمله على التثقيف السياسي للنساء في المناطق بالتعاون مع جهاز التنشئة السياسية، كما إنه يضغط لزيادة عدد النساء في المواقع القيادية 67 . تبرز في الجهازإشكالية هامة وهي الفصل ما بين مفاهيم “النسوي” و”السياسي”، باعتبارها مفاهيم منفصلة نظرياً أو عملياً )على مستوى فصل المهمات والأدوار(، فمَن تلعب دوراًسياسي لا تنتمي إلى الجهاز، ولا ترى حاجة إلى التواجد فيه 68 . يطرح هذا النقاش تساؤلات حول ماهية الدور المتوقع للقطاع النسائي في الأحزاب وضرورة التفكيرفي نموذج مختلف 69 ، ويشير إلى أهمية أن تعي الهياكل السياسية أن لا تعزل من خال بنيتها النساء بوضعهن في فضاءات أو جيتوهات خاصة بهن وبقضاياهن 70 ،من دون إتاحة فرص لهن للتفاعل مع قضايا أعم.
٤( خطاب الحزب الخارجي وممارساته الإقصائية داخلياً
تازماً مع بنية الحزب التي لا تسهل من مشاركة النساء سياسياً داخله، ووثائقه التي لا تولي لقضاياهن حساسية خاصة، تأتي ممارسات ومواقف الحزب لتوضح تباين مايعلنه الحزب من مناصرة لمشاركة النساء في خطابه الخارجي للجماهير، وواقع ما يعشنه النساء داخل الحزب. جاء على رأس هذه الممارسات مفهوم “المصلحةالحزبية” وهو يشير الي أولوية الفوز بالمقعد النيابي والبلدي، فطبقاً للنقاش مع الحزبيات، يقوم الحزب بترشيح المرأة التي تستطيع نيل أصوات بما يؤمن للحزب الفوزبالمقعد النيابي أو البلدي. تؤكد حزبية قيادية على هذه المصلحة هي المعيار الأول: “هناك مسائل لا تصلح فيها المقاربات النسوية. رئيس الحزب ما بيفكر عند اتخاذالقرارات الرئيسية بأن الموضوع يعني إمرأة أو رجل، هو يفكر بمصلحة الحزب” 71 . وعلى هذا الأساس تحضر الكفاءة كمعيار أساسي في تحليل أسباب محدوديةأدوار النساء. وفقاً لغالبية مَن التقينا بهم إن الحزب يوكل المهمات للشخص المناسب أنثى كان أو ذكراً، ولا يمارس تمييزاً على أساس النوع الاجتماعي؛ ورددتالحزبيات أن ما يحدد فرص للنساء للترقي هو قدرتهن على “إثبات الذات”، فتعلق إحداهن: “لما تشتغلي وبتساعدي الناس وتعطيهم الثقة وبتشتغلي من كل قلبك وتعطيقد ما فيك للحزب بتاخدي مواقع”، وتخبر أخرى:”المشكلة عند المرأة نفسها. هي لا ترغب بتولي مواقع قيادية، وليس لديها شغف بالعمل السياسي. المرأة لا تحب العملالسياسية” 72 . يشير ما سردته الحزبيات إلى ترسخ الثقافة الأبوية لديهن حول مشاركة النساء ومطالبتهن بإثبات أنفسهن، وامتاك الإرادة الحقيقة والعمل الجاد قبلالمطالبة بتولي مواقع عليا، في حين لا يستخدم ذات الخطاب مع أقرانهن من الرجال. كذلك يدل على عدم رؤية بعضهن للأسباب البنيوية - المشار إليها آنفاً المسؤولةعن عدم قدرة النساء على مراكمة الخبرة السياسية، وبالتالي استدامة قلة كفاءتهن.
تتقاطع “المصلحة الحزبية” هذه مع “المصلحة الطائفية” التي تتحقق تبعاً للتحالفات السياسية التي ينضم إليها الحزب ليعلي من فرص فوزه بالمقاعد الانتخابية. حيثتستعرض الحزبيات الدوائر الانتخابية المختلطة التي تدفع بالحزب إلى التدقيق في أسماء المرشحين وإلى صياغة التحالفات بشكل يضمن المقعد “للطائفة” 73 . تسلّموتدافع الحزبيات عن أهمية المصلحة الطائفية لما ترينه فيها من ضمانة لتمثيل “حقوق الجميع ]الطوائف[”.
في سياق المصلحتين الحزبية والطائفية، تعترف الحزبيات بضعف تقدير المهمات التي يقمن بها النساء وبتهميش آراءهن وعدم أخذها على محمل الجد. تردف إحداهن: “إذا كنا ضمن مجموعة رجال أي فكرة تطرحها امرأة لا تهاجم، ولكن لا تؤخذ على محمل الجد”، وكذلك أشرن إلى مراقبة ونقد طريقة لباس وشكل المسؤولة الحزبيةبدلًا من التفاعل مع ما تطرحه من أفكار ومواقف، فتعبر إحداهن عن كون كثير من رجال الحزب يرون الحزبيات ك”نساء” فقط بمعزل عن أدوارهن “السياسيةوالقيادية” 74 . بالمقابل، تسرد إحدى الحزبيات تجربتها في الترشح لموقع قيادي - تحدياً لهذا التهميش - داخل الحزب وعدم اكتراثها بالمعارضة التي تكررت في جملة“ليش امرأة ما عاد في رجال” 75
يبدو من قراءة وتحليل هذه الديناميات أن للحزب موقف مجتزأ من قضايا النساء ومن دعمهن داخله وهو ما ينعكس على مواقفه العلنية. فقد قدم الحزب عدداً منمقترحات القوانين الخاصة بحقوق النساء بشكل خاص منها مشروع قانون لتعديل أحكام المادتين ٥٠٣ و ٥٠٤ من قانون العقوبات واللذين يتعلقان بالاغتصاب الزوجي،واقتراح قانون للحماية من تزويج الأطفال والطفات. في حين يرفض الحزب أي تعديل يطال قانون الجنسية اللبناني الذي يمنع النساء من منح الجنسية لأسرهن، “بسببخصوصية وضع لبنان والخوف من الخلل الديموغرافي ومن إخفاء مشاريع توطين” 76 ، وهو ما أيدته إحدى الحزبيات بقولها: “أنا في قضية الجنسية لا أفكر بالمرأة،أنا أفكر بوجودي. أنا أخرج من نسويتي لأن همي الأساسي وجودي الطائفي وخوفي من المس بهذا الوجود” 77
وفي النهاية، انتقل القوات من كونه ميليشيا عسكرية انخرطت من خالها قلة من نسائه في الأدوار العسكرية والأخريات في مهام رعائية متصلة بالعمل العسكري مندون تغيير منظور رؤية الحزب لأدوار النساء داخله. كذلك أثناء فترة التضييق والاعتقالات وحينما توافرت الفرصة للنساء لأداء أدوار أكبر، لم يستطعن الترقي لأدوارقيادية - باستثناء صعود ستريدا جعجع - فلم تكن الأولوية للنساء أو تمكينهن. اما اليوم فتواجه نساء الحزب عقبات بنيوية تفرضها عليهن الأدوار التي من شأنها إعدادهنسياسياً، وأخرى تتصل بالتفاوت بين خطابه العام المناصر للنساء وممارساته ودينامياته الداخلية التي توضح النظام السياسي العام في لبنان الذي يعتمد على الطائفيةوالعائلية السياسية كأدوات أساسية في الحكم. تتقبل بعض حزبيات الحزب هذا النظام وتسلم بضرورة استخدام أدواته لتحقيق المصالح الحزبية والطائفية، في حين تتحدىحزبيات أخريات - ولو بشكل فردي سلطة الرجال ضمن الحزب وتحاول اكتساب فضاءاً للترقي السياسي داخله.
ثانياً: طلعت ريحتكم: حدود التعبئة الأفقية؟
١( دورات الاحتجاج الاجتماعية في لبنان
تتنوع تعريفات الحركات الاجتماعية تبعاً لتعدد المقاربات والمنطلقات النظرية والمنهجية 78 . وعليه تتبنى الدراسة تعريفاً للحركات الاجتماعية على أنها الجهدالجماعي الرامي إلى تغيير طابع العاقات الاجتماعية المستقرة في مجتمع معيّن، ويُبذل من قِبل مجموعات من خارج النظام السياسي تسعى للتأثير في صنع القرار برفعمطالب لدى الدولة، وتتبنى أهدافاً لا تحاول تحقيقها من خال آليات العمل السياسي المباشر أو المؤسسي، كون الاستحواذ على السلطة لا يمثل لها غاية 79
شكلت هذه الحركات جزءاً كبيراً من الحراك الثوري العربي في المنطقة منذ نهاية عام ٢٠١٠ . وشهد لبنان كغيره من الدول العربية أشكالًا عديدة من الحراك فيمناسبات شتى، كان أبرزها حراك العام ٢٠١٥ ، الذي لا يمكن قراءته من دون العودة إلى عام ٢٠١١ ، حين أطلقت مجموعة تضمّ جهات عدة حملة "إسقاط النظامالطائفي" في لبنان. في مارس من العام ٢٠١١ ، سار آلاف المتظاهرين في بيروت مرددين شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي"، "الطائفية هي أفيونالشعوب"، و"ثورة، ثورة ضد الطائفية" 80 . نجح المنظمون في اجتذاب آلاف المتظاهرين إلى الشارع، واعتُبرت الحملة من أهم الحمات التي حشدت ضد النظامالطائفي في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية. ولكن لم يدم الحراك طوياً نظراً لحدوث الانقسامات بين صفوف الحركات المكونة له، والتوقف أمام قضية كيفية تناولرموز الطوائف أو كيفية إعادة تشكيل مستقبل لبنان السياسي 81
لحقت بحملة "إسقاط النظام الطائفي"، دورة احتجاجية أخرى - وهي ما بات يعرف بحراك صيف العام ٢٠١٥ حين تراكمت كمياتٍ هائلةٍ من النفايات في شوارعبيروت وجبل لبنان، وبدأ المتظاهرون يحتجون في المناطق ومن ثمّ المراكز، وأخيراً في العاصمة. أعاد حراك عام ٢٠١٥ المواجهة مع السلطة الى الواجهة، وعززفكرة القدرة على مواجهة السلطة في الشارع، لا سيما إنه تزامن مع وضع سياسي وأمني غير مستقر وضعف وفراغ في المؤسسات السياسية 82 ، وجاء ليبني على"نضالات عمالية ومدنية سابقة"، بل وليتخطاها - تحديدًا خال تظاهرات أغسطس الحاشدة - باستقطابه فئات اجتماعية وعمرية جديدة ورفعه لسقف المطالب في وجهالسلطة 83 فوفقاً لتعبير معظم مَن التقينا بهم، كان حراك عام ٢٠١٥ "مساحة غير مقيدة المطالب والأطر"، وبدا أنه يعبر عن ذاته بشكل تلقائي وعفوي 84 . إذ لم تعدمطالب الحراك إنهاء أزمة النفايات فقط، بل تعدتها إلى المطالبة باستقالة وزير البيئة آنذاك، ومحاسبة شخصيات أمنية وسياسية مسؤولة عن ردة الفعل العنيفة التيواجهت بها القوى العسكرية والأمنية المحتجين سلمياً في الشارع، لتنتهي المطالبة الشعبية بإحياء المؤسسات من خال قانونٍ انتخابي جديد وعصري يعيد رسم المشهدالسياسي في لبنان 85
٢( "طلعت ريحتكم": حركة احتجاجية عفوية؟
برزت مجموعات عديدة خال حركة الاحتجاجات في العام ٢٠١٥ ، كان أبرزها مجموعة "طلعت ريحتكم"، "بدنا نحاسب"، "شباب ٢٢ آب"، و"عكار مَنّا مزبلة" 86 . تشكلت حملة "طلعت ريحتكم" من هاشتاغ أطلقته شابة ناشطة على صفحتها على الفايسبوك، احتجاجاً على تراكم النفايات في الشوارع بعد إقفال المطمر الأساسيوالأكبر في لبنان والواقع في منطقة الناعمة، على مسافة غير بعيدة من بيروت. تحول الهاشتاغ سريعاً إلى صفحة على موقع فايسبوك، ولاحقاً إلى حملة بعدالاعتصامات المتتالية التي نظمتها المجموعة في شهر يوليو 87 . تعرّف الحملة نفسها بأنها إطار عفوي انطلق بشكل عابر للإيديولوجيا والأجندات السياسية، من العام٢٠١٥ فليس هناك "إيديولوجيات فكرية واجندات سياسية للأعضاء والعضوات" كما صرح مَن التقينا بهم من الحملة. يصف أحد النشطاء الحملة، بأنها "فضاء تشكّلبهدف السماح للمواطنين/ات للمشاركة في السياسة والضغط لتأسيس نظام جديد للحياة السياسية في لبنان، من خال تعبئة النساء والرجال لاعتراض على نهج الحكومةفي التعاطي مع القضايا العامة وتحديداً قضية النفايات" 88 . وكان أبرز ما يميزها - كما عبر ناشطيها – هو استخدامها لوسائل عمل غير تقليدية وغير معهودة - فيالسياق اللبناني - في الاحتجاج، منها على سبيل المثال اقتحام مبنى وزارة البيئة، وتصوير النفايات المكدسة بتقنيات تصوير حديثة من الجو )عن طريق طائرات باطيار(، واتخاذ مبادرات لتنظيف الأنهار من النفايات، والاحتجاج أمام منازل مسؤولين في الحكومة.
بالرغم من أنه لا يشترط في الحركات الاجتماعية تحديد برنامج عمل أن تجد بدائل سياسية أو تصورات لمنهجية الحكم، إلا أن نشطاء الحملة ممَن التقينا بهم شددوا علىضرورة تحديد - على الأقل - هوية للحركة الاجتماعية وامتاكها لجملة معايير قيمية تؤسس لمشروعيتها. وهو ما حاول نشطاء الحملة فعله من خال بلورة فكرة سياسيةخاصة بهم وعدم اقتصارهم على المطالبة بحل قضية النفايات فقط، إلا أنهم لم ينجحوا في طرح تصوراً واضحاً لتلك الفكرة، واكتفتوا بالتركيز على هدف التعبئة مندون التركيز على صياغة أهداف أو تحديد الفئات المستهدفة. وعليه بدت الحملة ذات "خطاب عاطفي، مطالب فضفاضة، تحركات استعراضية وانتصارات رمزية مندون مطالب، ومن دون برنامج سياسي موحد" 89 ، وتمثل ذلك في ما رفعته من عناوين جاذبة مثل الدعوة إلى بناء دولة المؤسسات ومحاربة الفساد، ولكنها لا تشكلمعالم مشروع سياسي أو رؤية سياسية. بجانب الإطار العفوي للحملة، ساهمت ظرفية القضية 90 التي ولدت الأحداث الاحتجاجية في تحجيم القدرة على صياغة رؤيةسياسية وأهداف واضحة. فقد ضمت الحملة مجموعات غير متجانسة سياسياً وأشخاصاً متنوعي الأيديولوجيات 91 ، اتفقوا بشكل ظرفي على أن قضية النفايات هيقضيتهم المشتركة.
٢.١ حدود اللاهيكلية على ممارسات الحملة
تبنت الحملة إطاراً أفقياً لاهيكلياً 92 ، طامحة إلى كسر صورة القائد أو الزعيم. فالأفقية والاهيكلية – بحسب تجارب الحركات الاجتماعية في سياق دول الجنوب - كاهما من العناصر الأكثر جذباً لفئات الشباب نظراً لميلهم لتجنب الهرمية والقيود التنظيمية المنتشرة في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية أو العمالية، مما يوفرمساحة أكبر لممارسة الديمقراطية المباشرة داخل الحركات 93 . يعبر أحد ناشطي الحملة عن ذلك بالقول: "إن القيادة التشاركية هي أحد أبرز خصائص الحملة وهو أمرغير معهود في الحياة اللبنانية" 94 . لم تخلُ الحملة تماماً من بعض أشكال التنظيم، فقد بدأت منذ اليوم الأول بتقسيم النشطاء إلى لجان )الإعام، المالية، واللوجستيات(،وتستمر - حتى اليوم - اللجنة التي تضم أعضاء التقوا في بدايات الحملة في الاجتماع دورياً والتخطيط لأنشطة الحملة. ولكنها لم تقرّ نظاماً داخلياً بالرغم من نقاشالأمر، وإنما كان هناك توافقاً طوعياً حسب ما عبرت به إحدى الناشطات - على "جملة قواعد عرفية تضم بعض المعايير أبرزها الاحترام، السرية، التصويت، القيادةالتشاركية والمساواة بين عضوات وأعضاء الحملة" 95
واتفقت المجموعات الشبابية والنسائية ممَن التقينا بهم/ن مع الجوانب الإيجابية لبنية الحملة، إذ ترى بعض الناشطات إن هذه البنية ساعدت في إشراك الجميع في القرار،فيما يرى آخرون إن ضعف المستويات التنظيمية سبب التشويش وضعف الالتزام بالقرارات التي تُتخذ، وطرح ذلك تحدياً كبيراً لاحقاً. فمثا "في مرات عديدة كانتالقرارات تؤخذ بالإجماع، وفجأة يأخذ ناشط قيادي قراراً فردياً يقوم على أثره بالاجتماع مع بعض أحزاب السلطة، مخالفاً بذلك قرار الأكثرية في الحملة بعدم قبولالمفاوضات الجانبية مع السلطة في أثناء فترة الحراك"، وكذلك تمّ "اتخاذ قرارات فردية في ضمّ أشخاص أو فصلهم من اللجنة التنفيذية" أو "عدم الالتزام بتوزيع المهام" 96 . بالإضافة، فقد طالت الاتهامات القائمين على الحملة من الداخل والخارج، منددة باحتكار حفنة منهم تمثيل الحملة وتغييب الآخرين، لا سيما المتطوعين، وتصديرخطاب نخبوي يحتكر المشهد من دون الرجوع إلى المواطنين الذين اقتصر دورهم على التلقي 97 . إن المثال الأبرز لذلك، هو رفض قياديي الحملة - أثناء الحراك وفيأكثر من حادثة - التصريح بالخطوات الاحقة أو إخبار المواطنين عبر الإعام بما هو مقترح أو مخطط له.
نتيجة لهذا التشوش، في عام ٢٠١٦ تمّ التوافق على انتخاب أعضاء من المتطوعين لتفعيل دورهم وتحفيزهم على المشاركة. وعليه فأفضت الانتخابات بفوز شابة منأصل ثاث، مما سبب "ارتياحاً" لدى البعض ممَن التقينا بهم/ن 98
٣( النساء في الحملة: مشاركة حقيقية أم تجميلية؟
في حراك العام ٢٠١٥ ، كسرت النساء والشابات الصورة النمطية عن انسحابهن من المجال العام وفرضن أنفسهن كفاعات رئيسيات، حيث شاركن في مجمل فعالياتالحراك من الاعتصام إلى التصدي لبطش القوى الأمنية 99 وفي ما يتعلق بحملة "طلعت ريحتكم" ليس هناك رقم ثابت ودقيق لعدد أعضاء الحملة أو المتطوعين، ولكنتشير تقديرات إحدى العضوات السابقات إلى أن نسبة وجود النساء في الحملة خال فترة الحراك لم تتعدَ العشرين في المئة. يؤكد أكثر من قيادي في الحملة إنها عملتمنذ البداية على استقطاب الشابات، ولكن 100 . في حين تؤكد بعض لم يكن مشاركات في التخطيط التنظيمي للحملة قبل المظاهرات الحاشدة في ٢٠١٥ الشابات أنهنواكبن العمل منذ اللحظات الأولى 101
اتخذت مشاركة النساء في الحملة أشكالًا متنوعة لتشمل المشاركة في إلقاء البيانات، تطوير الجوانب التقنية الخاصة بالقضايا البيئية، تولي بعض القضايا التنظيميةالداخلية، إضافة إلى دور لعبته الشابات خال المظاهرات وهو الوقوف كدرع بشري أثناء المواجهة مع القوى الأمنية، الحشد والاستقطاب، تنظيم المظاهرات، وأخيراً، تصوير وتوثيق الأنشطة المتنوعة. على الرغم من هذه المشاركات المتنوعة، ناحظ جملة من الممارسات الإقصائية التي عّبرت عنها عدة ناشطات في الحملة، سواء فيما يتعلق منها بشكل المشاركة وفاعليتها، أو ما يرتبط بالصورة التي رسمتها الحملة نفسها للنساء. فمثلاً، كان تمثيل النساء في الاجتماعات التنسيقية محدوداً من حيثالعدد، كما إن التعاطي داخل هذه الاجتماعات كان إقصائياً، فتصفه إحدى الناشطات كما يلي: "كانت الكلمة العليا للرجل الذي يرفع صوته. وعندما كنا نبادر للحديث كانيتم تجاهلنا أو اسكاتنا، وتم الاستهزاء بنا عندما اعترضنا على نبرة الصوت العالية" 102 . واعتبرت الناشطات أن أحد الأسباب هذا التعامل هو حضور بعض القياداتالسياسية لهذه الاجتماعات واستئثارهم بالحديث والتحليل، وإقصاء الشباب عموماً والشابات خاصة، بحجة ضعف تجربتهن السياسية. وفي سياق موازٍ، رأت ناشطاتعديدات سواء من داخل الحملة أو من خارجها أن تكليف النساء بإلقاء البيانات الصادرة لم يكن من ضمن مسار التشاركية كما حاول البعض إظهاره، بل لم "يتعدَ كونهأمراً شكلياً بهدف إضفاء شيء من المصداقية في ظل غياب، إن لم نقل انعدام المشاركة النسائية في صياغة البيانات" 103
في مشهد آخر، اعتمدت الحملة - والمشاركون في حراك ٢٠١٥ بشكل عام - مقاربة حمائية تجاه النساء، ويتجلى ذلك في رفض العنف الممارس من قبل القوى الأمنيةبحق النساء من باب الحاجة إلى حماية النساء وقصورهن عن حماية أنفسهن، وليس من باب رفض العنف كسلوك )سواء تجاه المرأة أو الرجل( 104 . وكذلك تم إدانةاعتقال النساء من منظور مشابه، فوردت عبارات مثل "شاطرين على البنات"، والتي تهدف إلى الانتقاص من القوى الأمنية عن طريق التأكيد على ضعف النساءوسهولة استهدافهن؛ إلى غير ذلك من الممارسات. وفي السياق ذاته، تستحضر إحدى الناشطات النسويات من الشابات اللواتي شاركن في الحراك، الشعارات والهتافاتالتي استخدمها الحراك نفسه والتي حملت معانٍ تمييزية وأبوية بامتياز تقلل من النساء، مثل "هالساحة فيها رجال" و"سنبكي على الوطن كالنساء"؛ فالشعار الأول يغذيمن فحولة وذكورية الرجال ويغيب من تواجد النساء اللواتي تتسمن بالضعف، والثاني ينتقص من الجوانب العاطفية للنساء 105 . والافت للنظر هو أن تلك الشعاراتتماثل في ، أبويتها العبارات التي استخدمتها السلطة مع المتظاهرات مثل "لو أنت أختي كنت عرفت شو عملت معك" 106 التي تشير إلى سرديات الوصاية الأبويةللدولة على مواطناتها، والتعامل معهن من منطلق القرابية.
وأخيراً، لا يمكن إغفال أسلوب التفاعل مع قضية التحرش الجنسي بالمتظاهرات سواء من جانب الحراك أو الحملة، التي اعتبرت الحديث عنه أمراً مسيئاً ومضراًبصورة الحراك، الأمر الذي يمكن استغاله من جانب السلطة لمحاربة الحراك وأهدافه 107
جاء مكماً لكل هذه المشاهد والمواقف "غياب الموقف من النظام الأبوي" 108 ، وظهور خطاب تمييزي يرفض طرح قضايا النساء على اعتبار أن لها "ساحاتها" و"مناسباتها" و"ظرفيتها" 109 . وهذا خطاب يتكرر في العديد من الحركات الاجتماعية ذات الأهداف السياسية فالكثير منها ينظر لقضايا النساء خاصة الاستراتيجيةمنها – مثل المطالبة بالمساواة الجندرية - بأنها تتطلب تغييراً هيكلياً يحتمل التأجيل 110
وفقاً للناشطات ممَن التقينا بهن، المشاهد الأبوية بحق النساء المشاركات لم تتواجد في الفراغ، بل تتقاطع مع غيرها من الممارسات التمييزية مثل الطبقية والطائفية. فمثلاً، على الرغم من تصوير الكثيرين للحراك وللحملة بأنها تعمل نيابة عن المعدمين اقتصادياً او المحرومين لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية والاجتماعية،فنجد أن الكثيرين من المنتمين للحراك - ومن الحملة - قاموا باستخدام صفة "المندسين" على بعض المتظاهرين خاصة هؤلاء الذين استخدموا العنف في مواجهتهم معقوى الأمن ومع غيرهم من المتظاهرين، والذين بدا عليهم الانتماء لطبقات اجتماعية دنيا كونهم من سكان إحياء فقيرة وينتمون لطوائف بعينها 111 . تستحضر إحدىناشطات الحملة هذا المشهد الجلي، وتوضح: "إن المندسين من أبناء الطبقات الفقيرة، هم مَن يقومون بأعمال الشغب، فيما البقية هم "عاقلين" و"محترمين" و"طابجامعات محترمة" 112 . وإن توزيع الشهادات الأخاقية والوطنية بحسب ناشطات نسويات شاركن في الحراك هي "قيم أبوية بامتياز".
في النهاية لا تبدو من تجربة مشاركة النساء في إطار حملة "طلعت ريحتكم" بأن الحملة كانت فضاءاً مرحباً بتمثيل النساء وتمكينهم، بل وجدت النساء - اللواتي تحدثنمعهن - أنفسهن في انفصال وعزلة بعد فترة من استمرار الحملة إما عن طريق البنية الأفقية التي تم اقتصار القيادة والتمثيل فيها على حفنة محدودة من النشطاء، أو منخال الاستخدام الإعامي للنساء لإعطاء الحملة صورة تشاركية تقدمية، أو كنتيجة لخطاب الحملة - ومجموعات الحراك بشكل عام - التي حرصت من خاله على الحفاظعلى صورة الحراك بعيداً عن التشوية، وعدم الاشتباك مع التعديات والانتهاكات بحق المتظاهرات والناشطات.
ثالثاً: نقابة المعلمين في لبنان: نساء في القواعد ورجال في القيادة
تأسست نقابة المعلمين عام ١٩٣٨ ، ومرت النقابة بانقسامات لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بمواقع النفوذ، حتى أنشِئت نقابة واحدة في العام ١٩٩٢ تحت اسم "نقابةالمعلمين في لبنان"، مقرّها الرئيسي في بيروت، ولها مجالس فروع في بيروت، والشمال، والبقاع، والجنوب، وجبل لبنان والنبطية. على الرغم من عدم وجودإحصائيات رسمية حول نسبة عضوية الرجال والنساء في النقابة، إلا أن معظم مَن التقينا بهم من النقابيات والنقابيين يجمع على أن النسبة الأكبر والتي قد تصل إلى مايقارب ٧٥ % هي للنساء، وهي نسبة منطقية تتفق مع توزع المعلمين )% ٢٠١٧ ، فقد بلغ عددهم الإجمالي ١٠٢٩٨٨ منهم ٨١٦٨٠ من الإناث ( ٧٩.٣ - والمعلماتفي لبنان للسنة الدراسية ٢٠١٦ .113)% و ٢١٣٠٨ من الذكور) ٢٠.٧
لا تأتي هذه النسب بمفاجأة، فمهنة التعليم هي من أكثر المهن اقتراناً بالنساء حول العالم - خاصة في مراحل التعليم الابتدائي وما قبله - لعدة أسباب وفي طليعتها تناسبالمهنة مع ظروف النساء الاجتماعية وواجباتهن الأسرية، ارتباط المهنة بالدور الرعائي للنساء والتصورات المجتمعية عن كونهن ذوات ميول فطرية تجعلهن أكثر قدرةعلى الاهتمام بالأطفال وتعليمهم، وكذلك التصورات الموجودة في بعض المجتمعات المحافظة عن أن تواجد معلمات حول أطفال في سن مبكر هو أكثر أماناً لهم 114 . تتطابق هذه الأسباب مع خلفيات انضمام عضوات النقابة - اللواتي التقينا بهن - للمهنة، فالكثيرات انتهى بهن المطاف "بالصدفة" في حقل التعليم؛ حيث دفعتهن الحربوالظروف الاجتماعية - مثل الزواج وتأسيس الأسرة - والأحوال الاقتصادية لانخراط فيه 115 . أما البعض الآخر، فقد حفزته الامتيازات المادية والمعنوية التي تمنحهاالمهنة للعمل بها، فمثلاً، تؤمّن مهنة التعليم دخاً مالياً ثابتاً وأوقات عمل مائمة بشكل نسبي، بالإضافة إلى الاستفادة من مجانية تعليم الأبناء في المدارس التي يدرسنالمعلمات فيها.
وتجدر الإشارة إلى إن اختاف الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعلمات اللواتي التقينا بهن، كانت أحد المتغيرات الرئيسية في تنوع أسبابهن في ممارسةالمهنة وقراءتهن لامتيازاتها. فمثلاً، وجدنا أن المستوى الاقتصادي والعمل في مدارس صغيرة كان متغيراً أساسياً في اعتبار المهنة مصدراً "للأمان" على الصعيدالشخصي والأسري والاقتصادي. والأهم هو انعكاس هذه الخلفيات إن على درجة ارتباطهن بالنقابة أو انخراطهن فيها كما ستوضح الأجزاء التالية.
١( العلاقة مع النقابة: عضوية غير نشطة والتزام رمزي
إن نقابة المعلمين ليست نقابة مهنية، ما يعني أن الانتساب إليها ليس شرطاً لممارسة مهنة التعليم، وتنحصر شروط الانتساب لها في ١( التدريس في مدرسة خاصة، ٢( عدم الانتساب إلى أي نقابة أو رابطة أخرى 116 كون الانتساب للنقابة ليس شرطاً لممارسة المهنة، فإن المعلمات الاتي التقينا بهن انضممن إما بسبب فضولهن عنالنقابة نظراً لانتساب العديد من زمائهن ينتسب إليها 117 ، أو بسبب خلفيات المعلمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشار إليها مسبقاً والتي حفزت بعضهن علىالانضمام إليها، فالكثيرات منهن بحاجة للأمان الوظيفي والاقتصادي.
يأتي دور النقابة مثلاً في "الحماية القانونية" كأحد أبرز عوامل انتساب النقابيات - اللواتي التقينا بهن - إليها، فبالنسبة لبعضهن يمكن للنقابة أن توفر دعماً قانونياً خاصةفي حالات تعسف إدارات المدارس مع المعلمين أو المعلمات. في هذا الشأن تردف إحدى المعلمات: "انتسبت للنقابة وصار مدير المدرسة وهو ]رجل دين أي إنه ذوسلطة تتجاوز كونه مديراً[، يحسب لي ألف حساب وما عاد غلّط معي وصار يغلّط مع اللواتي لا يعرفن 118 ، قد أعاد ثقة البعض بالنقابة وحفز العديد من حقوقهن" 119 . كذلك أشارت النقابيات إلى كون القانون رقم ٤٦ المعلمات لانتساب لها وللإيمان مجدداً بالعمل النقابي. وفي سياق موازٍ، نبع انضمام بعض المعلمات للنقابة كردفعل عكسي نتيجة معارضة إدارات بعض المدارس لفكرة الانتساب للنقابة خوفاً من تعرّف المعلمات والمعلمين على حقوقهم/ن وانخراطهم/ن في النشاط من أجلالمطالبة بها. فعلى سبيل المثال، وصفت إحدى النقابيات حادثة سحب طلب انتسابها إلى النقابة من قبل مدير مدرستها التي تضم ٣٥٠ استاذ واستاذة، ولكنها لم ترضخلمنعها وقامت بالفعل بالانتساب 120 . وأخيراً، تمثل بعض الامتيازات المادية التي تجلبها عضوية النقابة - كصندوق التعاضد 121 - واحد من العوامل المحفزة علىالانتساب، ولكن نظراً لكون الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للنقابيات اللواتي التقينا بهن متوسطة، فكان هذا عاماً مساعداً وليس أساسياً.
بالمقابل منذ تواجد هذه الحوافز لحظة انتساب هؤلاء المعلمات للنقابة، إلا أن لديهن اليوم - بعد استمرار عضوية بعضهن لسنوات - موقف سلبي من النقابة، ترتبت عليهغياب رغبتهن أو حماسهن للعب أي أدوار فعّال داخلها. فأغلبيتهن يرين في النقابة "إطاراً لا يقدم ولا يؤخر" في ظل الانهيار العام في منظومة القانون والدولة والنظامالسياسي في لبنان، وعاقة بعضهن بها تنحصر في موسم الاستحقاق الانتخابي فحسب. عندما سألناهن عن أسباب هذا الموقف الحالي، أعربت بعضهن أن حالة عدم الثقةتلك، هي جزء من حالة الإحجام عن الاهتمام بالشأن العام التي أصبحت تصبغ مامح الحياة العامة السياسية والنقابية في لبنان بالنسبة لهن.
ينعكس موقف النقابيات على شكل عضويتهن والتزامهن وأدوارهن ضمن النقابة، وبدا هناك تفاوت واضح بين نقابيات تكاد تكون مشاركتهن من خال النقابة "صفر" - حرفياً كما عبرن - إلى أخريات ينشطن بشكل أساسي من خال حمات من خارج النقابة أو عن طريق أحزابهن السياسية التي ينتمين إليها. بشكل عام تتباين أدوارالمعلمات ضمن النقابة بين المشاركة في التحركات الضاغطة والأنشطة التي تنظمها النقابة، والانتخابات اقتراعاً وترشيحاً 122 ، وفي الاجتماعات حيث يعبرن عنرأيهن ويتفاعلن في النقاش وطرح الأفكار، والعمل على توعية المعلمين بالحقوق، إلى جانب القيام بأدوار تنظيمية أو إعامية. كذلك تعمل المعلمات ضمن روابطالمدارس الأمر الذي يعزز خبراتهن النقابية. ولكن تجدر الإشارة إلى أن كافة هذه الأدوار قامت بها النقابيات في مراحل مختلفة طوال سنوات عضويتهن، أما أغلبيتهناليوم فغير فاعات ويرين غياب عام لدور النقابة.
هذا على مستوى العضوية القاعدية، أما عن مستوى تمثل النساء في المواقع القيادية، فقد شهدت النقابة انتخابات أعضاء المجلس التنفيذي في محطات عدة، ومعها تجلىضعف مشاركة النساء على مستوى القيادة، على الرغم من أن نسبة عضوية النساء في الهيئة العامة للنقابة تفوق نسبة عضوية الرجال كما سبق التوضيح. وفي آخرانتخابات للمجلس التنفيذي للنقابة بتاريخ يوليو ٢٠١٧ ، انتخبت امرأة واحدة من أصل إثني عشر عضواً 123
على مستوى مجالس الفروع في المناطق، تتولى عضوتان مسؤولية إدارة فرعي البقاع والجنوب. وعلى الرغم من أن عدد النساء في الهيئة العامة في الفروع أكبر منأعداد الرجال، ظلت نسب مشاركتهن في قيادة مجلس الفرع أقل من نسب الرجال وهي تتراوح بين أربعة إلى خمسة من أصل اثني عشر عضواً وفقاً لتصريحاتمسؤولتي الفرعين اللّتين التقينا بهما124 يمكن إسناد عدم تواجد النساء في المجلس التنفيذي ومجالس الفروع إلى إشكاليتين. الإشكالية الاولى ترتبط بتفاوت نسبة العضوية فيالفروع بحسب المناطق وبالتالي ما يترتب عليه من حضور المعلمين والمعلمات في اجتماعات الجمعيات العمومية والتي تبت في الكثير من القرارات. بناءً على ماعبّرت عنه المعلمات - اللواتي التقينا بهن - يمكن أن يصل عدد الحضور في الجمعية العامة لفرعي الشمال أو البقاع بين ٣٠٠ أو ٤٠٠ شخص في حين أنه لا يتعدى٢٠ أو ٣٠ شخص في بيروت وهو الأدنى في كل لبنان بسبب ضعف الاهتمام، وهو ما يؤثر على فاعلية الالتزام بقرارات المجلس التنفيذي 125 . تعلل النقابيات ذلكلعدم وجود خطة سنوية أو دورية لتعزيز الوعي النقابي إضافة إلى ضعف الثقة بالقياديين وهي ناتجة بحسب مَن التقينا بهم عن محدودية الإنجازات، إضافة إلى المللمن الوضع العام في البلد من أحزاب السلطة. أما الإشكالية الثانية فهي صورية الانتخابات على مستوى الفروع، حيث سادت "التزكية" في الكثير من المحطات الانتخابيةفي الفروع. بحسب للنقابيات، يتم الاتفاق داخل المجلس التنفيذي، والبت فيمَن يترشح وكيفية عقد التحالفات، وتقرير مَن يكون مسؤول الفرع، وهي ممارسة تحاكيممارسات الأحزاب السياسية وتحاصصهم الطائفي والإطار العام للسياسية في لبنان.
عن هذه الإشكاليات التي تحدّ من ترقي النساء داخل النقابة، تتسأل احدى المعلمات المنتسبات للنقابة "إذا أنا مش بالمجلس التنفيذي هل أكون نقابية؟" 126 . ترددتعبارة "عضو في النقابة" كمرادف لعضوية في مجلسها التنفيذي فحسب، وفقاً لتصريحات العديد ممن التقينا بهم/ن من المعلمين/ات، وهى تبرز تصورات النقابيات عنمحدودية أدوارهن، فهن يرين أنفسهن غير مؤثرات إلا بتوليهن مقعد في المجلس التنفيذي وهو ما يشير إلى خلل ما في بنية وممارسات النقابة، سيتم التطرق إليه فيالقسم التالي.
٢( عقبات أمام ترقي النساء في النقابة
بناءً على تحليل المجموعات المركزة والمقابات يمكن تقسيم العوامل المساهمة في الحدّ من أدوار النساء والتسبب بعدم إقبالهن على تنشيط عضويتهن داخل النقابة إلىعوامل مؤسسية ترتبط ببنية النقابة وممارساتها ومواقفها من القضايا التي تخص المعلمات، عوامل خارجية ترتبط بفاعلين يؤثران على مسار عمل النقابة وإدارتها،وأخيراً عوامل ذاتية وخاصة تتصل بالنقابيات وواجباتهن الاجتماعية نحو أسرهن ومدى تأثيرها على قدرتهن على القيام بأدوارهن العامة.
٢.١ بنية وممارسات لا ترحب بالنساء
عند سؤالهن عن التحديات على المستوى المؤسسي للنقابة، اعتبرت النقابيات "إن هناك خلل بنيوي على مستوى البنية والهيكلية" 127 . فإن أولى الفجوات الأساسية هيعمل النقابة من دون نظام داخلي سواء على مستوى المجلس التنفيذي أو على مستوى مجالس الفروع، فإقرار النظام يتم تأجيله منذ ٣٠ سنة. وفي محاولة تحليل الأسبابلا تجد النقابيات سبباً إلا سيطرة الأحزاب السياسية على النقابة وقبلها تدخل إدارات المدارس الخاصة فيها، وهو ما سيعرض بالتفصيل في القسم التالي. ولكن يؤسسغياب هذا النظام الداخلي برأي الكثيرين/ات الذين/اللواتي تمت مقابلتهم/هن "لوضع غير صحي وغير ديمقراطي"، من شأنه أن يضعف إدارة النقابة ودورها.
ثانياً، يتم تشكيل المجلس التنفيذي عبر الانتخاب، وعليه فهو لا يضم بالضرورة ممثلين/ممثات عن كل المناطق 128 . صحيح أن هناك هامش يسمح بحضور مسؤوليالفروع جلسات المجلس، ولكن هذا الحضور لا يمنحهم صاحية التصويت على القرارات. ومن ثم، فإن مواقف واتجاهات الفروع غير مؤثرة في قرارات المجلسالتنفيذي 129 ؛ كما ويفاقم من هذا الوضع اعتماد الكوتا الطائفية 130 ، على مستوى المجلس التنفيذي أو على مستوى هيئات الفروع؛ مرة أخرى تحاكي النقابة فينظامها السياسي، النظام العام للسياسية في لبنان، رافضة الخروج عنه أو استبداله بآخر.
ثالثا، على مستوى التواصل مع القاعدة، يغيب التواصل الدوري بشكل كبير مع المدارس الصغيرة ويتم معرفة تواريخ عقد الانتخابات والتحالفات والمرشحين واخبارالنقابة عن طريق ممثلي الأحزاب أو عبر التلفاز. وهو الأمر الذي تعيبه المعلمات على النقابة، لما يترتب عليه من تغيب لتمثيل تنوع آراء ومواقف النساء من التحالفاتالتي تشكل والقضايا التي تناقش.
رابعاً، تغيب عن النقابة أي سياسات أو مدونات داخلية تناقش قضايا التمييز والعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي مثل قضية التحرش الجنسي. وبالرغم منتخصيص باباً بعنوان "استشارات ومراجعات قانونية" على الموقع الالكتروني للنقابة، يقتصر نموذج "استمارة مراجعة قانونية" على معرفة المعلومات الأولية من مقدمالمراجعة لتشمل الاسم، رقم الانتساب، الفرع، اسم المدرسة وموضوع المراجعة؛ فيما تغيب أية معطيات تساعد في تصنيف المراجعات على أساس الجنس أو في تحليلنوعية القضايا التي تطال النساء المعلمات 131
تؤثر هذه الفجوات السابق استعراضها، على ديناميات العاقات والتفاعات اليومية مع النساء داخل النقابة. فنجد أن النقابة هي جزء من منظومة "هرمة" على مستوىالقيادات والترقي فيها يكون عن طريق "الأقدمية" بحسب تعبير أحد النقابيين، مما يفسر إقصاء العناصر الشابة عن تولي مواقع قيادية في مقابل احتكار للقيادة من قبلالرجال من أصحاب الخبرة. تقول إحدى النقابيات: "التمييز هنا مستتر وغير مباشر. زميلنا النقابي رجل والكل يسمع كلمته. أنا مين؟ أنا صبية جديدة وأكيد ما بعرفشي بالعمل النقابي. هو نقابي من ٣٠ سنة" 132
كذلك في سياق التفاعات اليومية تبرز سلوكيات تنمّط حضور النساء في النقابة. أحد مامح هذه السلوكيات هو وصف أي امرأة تقوم بأدوار سياسية بأنها "أخت الرجال" 133 ، إضافة إلى توصيف آخر أطلقه بعض أعضاء المجلس التنفيذي في إحدى دوراته على عضوة بالمجلس وهو "أنها أضحوكة المجلس". تبدي النقابيات الانزعاجوالرفض القاطع لهذه التوصيفات لما فيها من انتقاص من المرأة كعضو فاعل سياسي بجانب كونها أنثى، بالإضافة الى كون هذه التعليقات تشجع على جعل المرأة بمثابةسلعة وحصرها في شكلها الخارجي، كيف تبدو وماذا ترتدي.
وأخيراً، انحصرت المطالب التي رفعتها النقابة في السنوات الأخيرة في القضايا المالية ومنها إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب وغاء المعيشة )كونها القضايا الأكثرشعبية وتفاعاً(، عدم فصل سلسلة القطاع الخاص عن القطاع العام، تغييب نقابة المعلمين عن اجتماعات الهيئة العليا للمناهج في المركز التربوي، عدم استفادة المعلمينمن الضمان بعد عمر ٦٤ عاماً وغيرها من القضايا 134 . بينما تفتقد التجاوب مع الانتهاكات التي تواجهها المعلمات بسبب التمييز )راجع القائمة ١ أدناه(. تعتبر بعضالنقابيات أن التمييز مبطّن وغير مباشر في بيروت، وتحديداً في المدارس الكبيرة كونها عادة ما تحكمها حزمة من القواعد تصّعِب من ممارسة التمييز المباشر، في حينترى أخريات وتحديداً في المناطق إنه مباشر وغير مستتر جرّاء صغر حجم المدارس وغياب الرقابة والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تسمح بوقوع هذه الانتهاكات.
.png)
٢.٢ تحاصص وتهميش لعمل النقابة: المدارس الخاصة والأحزاب
يؤثر فاعان رئيسيان على مسار العمل النقابي بشكل عام، وعلى النساء فيها بالتبعية؛ أولهما إدارات المدارس الخاصة وثانيهما الأحزاب السياسية. من خال تجاربالنقابيات الاتي تحدثن إلينا تظهر ممارسات من إدارات المدارس لتقييد الانتساب إلى النقابة. يأخذ هذا التقييد شكل الضغط غير المباشر من خال ما يشبه المساومة التيتمثل أحد آليات عمل المدارس لإقناع المعلمين بعدم فاعلية النقابة مقابل التقديمات المالية من جانبها. تعبر إحدى النقابيات عن ذلك فتقول: "تزيد الإدارة من حين إلى آخرمبلغ ٢٠٠ أو ٣٠٠ ألف ليرة لبناني لرواتب المعلمين، وبيصير شو عم تطلبه من الدولة ليس له قيمة" 135 . يشير ما سردته المعلمات من طرق المساومة التي تنتهجهاإدارات بعض المدارس إلى اعتبار العمل النقابي مصدر للخطر يهدد سلطة تلك المدارس نظراً لما يفضي إليه من معرفة المعلمين/ات لحقوقهم/ن وتعريفهم بكيانتنظيمي من شأنه رفع مطالبهم/ن في حال انضموا/من إليه.
كذلك تتعرض المعلمات في أحيان كثيرة إلى الضغط المباشر كما تكشف إحداهن: "في إحدى المظاهرات، حضرت إلى المدرسة ولم ادخل إلى الصف لرغبتيبالمشاركة في المظاهرة، لم يمنعني المدير من المشاركة، ولكنه حذرني من التصريح أمام المعلمين في المدرسة" 136 . إن حدود التخويف الذي تمارسه الإدارات قديمتد إلى عدم التزام المدارس بالإضراب وإلى تقييد أو منع مشاركة المعلمين/ات في الفعاليات والأنشطة النقابية أو التعبير عبر وسائل الإعام وليس في المدرسة فقط. يترك هذا الأسلوب أثره على الكثير من المعلمين/ات، فمنهم مَن يلتزم بالتعليمات، وقليل منهم لا يمتثل لقرار الإدارة مخاطراً بوظيفته. وفي السياق ذاته، تلجأ المدارسالدينية إلى استخدام سلطتها الدينية - بشكل مستتر - في الترهيب، فتؤثر سلطتها على خيارات ومواقف العديد من المعلمين/ات، نظراً لكون العاقة مع رجل الدين - المتواجد في الادارة - تتخطى المدرسة إلى حدود تنظيم وإدارة العاقات اليومية الخاصة بالزواج والطاق وتنظيم الإرث وغيرها من القضايا. أردفت إحدى المعلماتتشرح تجليات هذه السلطة: "ما في حدا بيعرف المشكلة إنه في رعب من رجل الدين خصوصاً بالمدارس الدينية. أبونا أو الراهبة عندهم سلطة دينية قوية بيمارسوهاعليك كتابعة لهذه السلطة. وعندهم رعايا يعني كل الموظفين بالمواقع القيادية من نفس طائفته/ا، يعني الرعية هو يلي بيزوجن وبيطلقن وبيعملن الارث. بمعنى آخريراعي مصالحهم من عدة زوايا" 137
أما عن الأحزاب السياسية، فلطالما كان تأثيرها حاضراً بقوة منذ بداية تأسيس النقابات في لبنان سنة ١٩٠٩ إذ ساهمت الأحزاب القديمة في بناء اتحادات ونقابات 138. وبالنظر في تأثير الأحزاب على النقابة، ترى النقابيات "أن نقابة المعلمين هي تحاصص أحزاب وتجمع لمصالح حزبية" 139 . ينعكس ذلك على موقف البعض منالنقابة ورفضهن لأي صبغة سياسية للنقابة، لأنه يؤثر سلباً على الانتماء النقابي للعديد منهن، ويأخذ المنافسة الحزبية من بين الأحزاب ويضعها في ساحة النقابات. فنجدمثلاً، أن التصويت في انتخابات المجلس التنفيذي للنقابة -المحدد بكوتا طائفية- يحاكي التحالفات الحزبية المبنية كذلك في معظم الأحيان على موازنات طائفية وسياسية. كذلك يلتزم الأعضاء المنتمين لحزب سياسي وللنقابة بقرارات أساسية مثل الإضراب أو التظاهر استناداً الى الموقف السياسي للحزب الذي ينتمون إليه، وليسبالضرورة موقف النقابة.
يفضي هذا التداخل الحزبي النقابي إلى غلبة الانتماء السياسي الحزبي على أي اعتبارات أخرى. يزيد هذا التداخل من سوء أوضاع مشاركة النساء في النقابات. فبحسبالنقابيات تفرض التوافقات الحزبية على الحزبيات من أعضاء النقابة، وهي توافقات تقصى النساء وتضع المصلحة الحزبية أولًا. تشارك إحدى النقابيات تجربتها قائلةً: "كنت مرشحة مستقلة ]في انتخابات المجلس التنفيذي[. نظموا التسوية واتفقوا على أسماء الأعضاء، اتصلوا بي طالبين مني الانسحاب كي لا يضطروا لتنظيمانتخابات"، بحسب تجارب النقابيات غالباً ما تكون النساء تكملة لتوافق عددي 140 ، يمكن الاستغناء عنها عند الضرورة. ولكن لم تغفل النقابيات وجود العوامل الذاتية،فهن يلومن أنفسهن على قلة النساء ذوات الطموح السياسي أو المهتمات بخوض "المعركة السياسية أو النقابية أو ينظمن الحمات الانتخابية" إضافة إلى إن النساء لايناقشن ضمن أحزابهن أحقيتهن بالوصول إلى مواقع القيادة، إذ إن "خيارات التصادم غير مطروحة" 141
٢.٣ أثر الواجبات الاجتماعية على مشاركة النساء في النقابة
إلى جانب العوامل السابقة المؤثرة على مشاركة النقابيات، فقد أشرن إلى وجود عوامل مرتبطة بحياتهن الشخصية وواجباتهن الاجتماعية نحو أسرهن التي من شأنهاالتأثير على نشاطهن داخل النقابة. كان أبرزها في نقاشهن النظرة المجتمعية للمرأة النشطة سياسياً، فتشير إحداهن حول ذلك أنه دائماً ما يتم سؤال تلك المرأة "وين تاركةبيتها وعائلتها ومسؤولياتها" 142 . والأمر لا يقتصر على النساء المتزوجات بل يمتد إلى العازبات اللواتي إذا انصرفن إلى العمل العام أو السياسي، فيتم لومهن علىعدم السعي وراء مستقبلهن في تأسيس أسرة. يدعم من هذه النظرة، أسباب امتهان النقابيات للتعليم المشار إليها آنفاً، فقد وجدنا المهنة مائمة لظروفهن وواجباتهن الأسريةوتقربهن من طريقة تفكير أبنائهن بحكم قربهن من الطاب، وتمنحهن امتيازات مثل مجانية في تعليم الأبناء، وبالتالي فليس متوقعاً منهن الانخراط في أنشطة سياسية منخال النقابة تطلب وقتاً والتزاماً.
أيضاً، عبّرت النقابيات عن تفاقم الالتزامات الأسرية وما يفرضه الدور الإنجابي من أعباء على المرأة في الاهتمام ورعاية أولادها والحرص على متابعة تعليمهموتربيتهم، بعكس الرجال الذين لا تطالهم تلك الأعباء، ولا يُلامون عليها اجتماعياً في حال عدم قيامهم بها. تصعب هذه الالتزامات من قيام النساء بأي نشاط نقابي، كماإنها تقلّص من مساحات مراكمة الخبرة والتجربة النقابية المطلوبة منهن للعب أدوار قيادية. وأخيراً، يحضر بقوة في حديث النقابيات غياب الدعم من قبل بعض أسرهنلمسيرتهن في العمل النقابي؛ الأمر الذي يصل إلى حدود تحميلهن نتائج أي تقصير أو إهمال على مستوى الأسرة. تدعم إحداهن وجهة النظر هذه بالقول "صديقتي هيناشطة جداً وحزبية بمواقع قيادية زوجها لا يشتغل ابداً بالعمل السياسي، كلما تأخرت باجتماع يحصل اشكال بالبيت" 143
رابعاً: الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً: رؤية محدودة للنساء
١( الاتحاد كونه شبكة أمان اجتماعية
تأسس الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً )المعروف سابقاً باسم اتحاد المعقدين اللبنانيين( عام ١٩٨١ كمنظمة قاعدية مطلبية حقوقية لا طائفية، أولويتها المطالبةبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولكن أخذ الاتحاد في عمله بعداً وطنياً، فعمل خال الحرب الأهلية اللبنانية على تعزيز السلم الأهلي وتوفير الإغاثة المباشرة وتنظيمالعديد من مسيرات السام، وفي السنوات الأخيرة شارك في حملة إسقاط النظام الطائفي عام ٢٠١١ ، مظاهرات التنديد بالتمديد للمجلس النيابي والفراغ الرئاسي، وأخيراًالحراك الشعبي الذي شهده الشارع اللبناني عام ٢٠١٥
يضم الاتحاد اليوم تحت لوائه ١٢٠٠ عضواً/ةً من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وآلافاً من المناصرين/ات والمتطوعين/ات، وهو عدد يمثل ١.٤ % من العددالرسمي لذوي الإعاقات المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان والبالغ عددهم ٨٠٧٠٣ في عام ٢٠١٣ )منهم ٦٢ % من الذكور و ٣٨ % من الإناث( 144. لا يتوافر لاتحاد نسب عضوية النساء فيه بشكل واضح، ولكن يزعم القائمين/ات عليه أن كثيرات من النساء يقصدنه طلباً للدعم والمساعدة، وللتطوع والانضمام، وهوما وجدنا انعكاسه على أسباب انتساب الكثيرات من عضوات وقيادات الاتحاد اللواتي التقينا بهن. أبرز أسبابهن كان الحاجة إلى التواجد في إطار يوفر تضامناً ودعماًللأشخاص ذوي الإعاقة، فهو بمثابة "متنفس" للعضوات بعيداً عن تمييز المجتمع بحسب توصيفهن 145 كذلك هو يمثل شبكة أمان اجتماعي تساندهن في تعزيز "الثقةبالذات" والتعبير عنها للتغلب على النظرة المجتمعية التمييزية ضدهن. تساعدهن هذه الشبكة في التعرف على غيرهن من الأشخاص ذوي الإعاقة من خال الانخراط فيبعض النشاطات الاجتماعية )أنشطة في القرية، انشطة في المدرسة والجامعة، التطوع مع أو تأسيس جمعية( ومن ثمّ توسيع شبكاتهن الاجتماعية، وتحسين مهاراتهن فيالتواصل والاندماج بين أشخاص من خارج محيط الأشخاص ذوي الإعاقة. وأيضاً تمنحهن عضويته القدرة على معرفة الحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة،والوصول إلى بعض مشاريع الدعم أو التوظيف.
أتت تصورات عضوات الاتحاد عنه كونه شبكة الأمان الاجتماعي ومكان يدعمهم في اتساق تام مع ما نعرفه مسبقاً من الدراسات والأدبيات المتعلقة بالنوع الاجتماعيوالإعاقة والمشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة؛ فكلها تشير إلى أن النساء ذوات الإعاقة يجدن في المنظمات الشبيهة والمجموعات الداعمة التي يتواجد فيها أشخاصيشبهونهن مكاناً يساعدهن في التغلب على العزلة الاجتماعية التي تتسبب بها إعاقتهن وتعزز من ثقتهن بنفسهن، بل وتجعلهن أكثر عزماً/قدرةً على التعبئة السياسية أوالاشتراك في الانشطة السياسية - خاصة تلك المتعلقة بالتمييز المرتبط بالإعاقة - بالمقارنة مع أقرانهن من الرجال 146 . يرجع هذا التأثير الإيجابي لتلك الشبكاتالاجتماعية على النساء ذوات الإعاقة إلى كون أوضاعهن أكثر سوءاً من أقرانهن من الرجال نتيجة لما يتعرضن له من "قمعٍ مزدوج" 147 أو "إعاقة مزدوجة" 148 نتيجة كونهن نساء في المقام الأول وذوات إعاقة في المقام الثاني، ومجدداً تأتي الإعاقات الحركية وهي أكثر ظهوراً للمجتمع لتكون المصدر الأول لتشكيل الوصمةالاجتماعية، ومن ثم التفرقة في النظر لأولاء النساء. يأتي مفهوم التقاطعية - المشار إليه مسبقاً - ليساعد على فهم هذه التفرقة المزدوجة والمبنية على محاور الإعاقةوالنوع الاجتماعي والمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأولاء النساء 149
بناء على ذلك، جاءت مقاباتنا ومجموعاتنا المركزة مع النساء ذوات الإعاقة من عضوات الاتحاد لتحيل كافة صعوباتهن وتحدياتهن المرتبطة بنشاطهن السياسي - منخال الاتحاد - إلى التمييز ونظرة المجتمع لهن والوصمة الاجتماعية التي يعايشنها والتي رأين تفاعلها المباشر والواضح مع هيكلية وبنية وممارسات ومواقف الاتحاد. ولذلك فالتحليل يبدأ من تجارب أولاء النساء في بيئتهن الاجتماعية مع أسرهن ومجتمعاتهن وينتهي بالاتحاد، وكيفية التفاعل مع هذه العوامل.
٢( تجارب نساء الاتحاد في بيئتهن الاجتماعية
تتفق جميع الدراسات على أن عوامل البيئة المجتمعية المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقات هي التي تؤثر عليهم وعلى اختياراتهم وأنشطتهم بشكل رئيسي 150 ، وكماذكرنا تتأثر النساء بالإعاقة بشكل مزدوج يطال جميع جوانب حياتهن. تختبر النساء ذوات الإعاقة تفاعات اجتماعية سلبية من خال الهياكل الاجتماعية والأسرية والثقافيةوالسياسية تفترض فيهن الضعف وتجذر جميعها الوصمة الاجتماعية 151 ، ويترتب على ذلك تعرضهن سواء داخل المنزل أم خارجه للتهميش والإهمال وأحياناً العنفأو الإصابة أو الاعتداء أو الاستغال. تحدثت عضوات الاتحاد - اللواتي التقينا بهن - عن أنه لا يزال ينظر لهن بإعتبارهن ضعفاء بحاجة لتلقي الإحسان أو موضوعاًلقرارات يتخذها آخرون نيابة عنهم لأنهن غير قادرات على اتخاذ أبسط القرارات الفردية المتصلة بهم بصورة مستقلة.
تجلى ذلك في الصورة النمطية التي ترسمها عائلة المرأة ذات الإعاقة لها على أنها مستضعفة، فمثلاً تخبر إحداهن: "العائلة لا تقبل فكرة أن المرأة ذات الإعاقة قد تكونمرشحة للمناصب العالية. دوماً يعتبرون إننا نعاني من نقص،" و تسرد أخرى: "لما بدأت العمل مع الاتحاد، تحديت أهلي حتى اقتنعوا" 152 . إن أكثر مَن تحدثنا معهنواجهن عائاتهن حتى سمحن لهن بالمشاركة في الاتحاد وأنشطته، ولم يستطعن اتخاذ القرار بشكل شخصي، وأتت معارضة المشاركة بشكل أساسي مبنية على تحدياتالإعاقة والحركة، والنظرة المجتمعية للمرأة ذات الإعاقة كثيرة الحركة والنشاط. وقد عبرت إحداهن عن ذلك: "بيقولوا أهلي أنتو عم تطلعوا كتير وبتغيبوا أيام بس يكونعنكم أنشطة أنتو بنات ومنخاف تتعرضوا للخطر وعم نسمع كتير حكي بسبب عملكم" 153 . هناك جانب مشروع لهذا الخوف، فقد تحدثت العضوات عن خوفهن منالتعرض للتحرش أو الاستغال بسبب الحاجة إلى استخدام وسائل النقل العامة، مما يعيق مشاركتهن الفاعلة في مختلف الأنشطة. وهذا ليس بمفاجئ في سياق النساء ذواتالإعاقة، فهن الأكثر تعرضاً للتحرش والعنف الجنسي ما بين النساء والرجال، والرجال ذوى الإعاقة حول العالم 154 . وعليه تدفع كل تلك الصعوبات، بعض أولاءالنساء إلى الاعتقاد أن الإرادة الفردية غير كافية للمشاركة في المجتمع بشكل فعّال؛ لا بد من تلقي الدعم من المحيط الأسري والمجتمعي. في سياق موازٍ، أشارتالعضوات - بشكل غير مباشر - إلى أن "منظومة قيم المجتمع" التي تتحكم بمواقف العائلة بالنسبة للإعاقة، وهي بنظرهن منظومة لا تدعم القيام بالدور السياسي. فمثلاً،إحداهن يتأثر أهلها بتعليقات الجيران، وتقول عن ذلك: "كام الجيران بيكون عن كيف يمكن لي مع إعاقتي أن أخرج من البيت وأعود بوقت متأخر. هذا الأمر بالنسبةلأهلي غير مقبول، لأننا اناس شرقيون أولًا وأخيراً" 155 . كل هذه الضغوط مجتمعة تجبر بعض العضوات على الانسحاب أو تقليص هامش تفاعلهن ضمن الاتحاد.
المثير لاهتمام، هو ازدواجية هذه الضغوط؛ ففي حين هناك معارضة أحياناً بخصوص الانخراط في الأنشطة العامة أو السياسية من خال كيانات كالاتحاد، تتعرضبعضهن الي ضغط عائاتهن للقيام بالعمل وكسب المال. تعلق إحداهن عن تجربتها الشخصية: "أنا أهلي محافظين، عندما أخبرهم أن لدي نشاط يقولون لي: تريدينالذهاب لوحدك؟ لكن بالمقابل ليس لديهم أية مشكلة أو اعتراض أن أذهب منفردة إلى الشغل" 156 ولكن يمكن فهم هذه الازدواجية في إطار تنوع الخلفيات الاقتصاديةلعائات أولاء النساء، فبعضهن يحتاج إلى موارد مالية إضافية للتعامل مع وجود فرد ذو إعاقة في الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، نجد صعوبات مضاعفة تواجهها النساءذوات الإعاقة لوصولهن لوظائف أو أشغال مؤمنة )بالمقارنة مع غيرهن من النساء( 157 ، مما يترتب عليه استغالًا اقتصادياً لكثيرات منهن من قبل أسرهن المحتاجةوذوي الدخل المحدود عند نجاحهن في الحصول على العمل.
على صعيد آخر تتمحور أكثر الموضوعات التي طرحتها العضوات حول حقهن في اختيار شركائهن مثلاً. فتضع العائلة والمجتمع شروطاً مسبقة متصلة بالوصمةالاجتماعية 158 وبالتصورات المنتشرة حول قدرة النساء ذوات الإعاقة على الانجاب تقيد من صورة الشريك المستقبلي. عبّرت إحدى الشابات عن ذلك: "تقول أمي،ليس مفروضاً أن تتزوجي شخص عادي، لازم تاخديه متلك يكون عنده حالة بتشبهك حتى ما يحب غيرك ويتزوج عليك. حتى ما يعايرك بإعاقتك" 159 . وتقول منتسبةأخرى: "أنا أعاني كثيراً. الشباب ينظرون إلي وتعجبهم شخصيتي، ولكن لا يقبلون بالزواج لسبب رئيسي وهو الشكل الخارجي" 160 . تدرك الشابات المحددات التيتفرضها عليهن إعاقتهن، ولكنهن ينتقدن النظرة المجتمعية والأسرية التي تعيقهن في كثير من الأحيان أكثر من الإعاقة نفسها )بالرغم من إدراكهن أن هذه النظرة تنبعمن خوف ورغبة في الحماية والرعاية).
٣( بنية وممارسات الاتحاد: قصور مستتر نحو النساء
إلى جانب تلك التجارب التي عاشتها عضوات الاتحاد في بيئتهن الاجتماعية - مع أسرهن ومجتمعهن المباشر والتي أثرت وما زالت تؤثر على اندماجهن وأنشطتهن فيالاتحاد الذي يرونه بمثابة "بيتهن الثاني"، فإنهن لم يسمين صعوبات في الاتحاد على المستوى الداخلي من حيث البنية والممارسات. بالنسبة لهن: "لا وجود للتمييزبالاتحاد، وقصة الذكورية غير موجودة. بعمرنا لم نتعامل على أساس ذكر أو انثى" 161 . انطاقاً من هذا الموقف، يؤكدن على انعدام الحاجة إلى نقاش قضية التمييزفي مجالات تولي النساء لمواقع القرار. إلا أنه بمزيد من التدقيق في تعليقاتهن يمكن تحديد بعض من أوجه القصور.
بدايةً، تختلف نسبة تواجد النساء في عضوية الاتحاد في الفروع بحسب المناطق. فهي تضعف في بيروت وترتفع في المناطق، حيث يأخذ شكل عاقتهن به رابطاً متميزاًمن خال الحضور اليومي إلى مراكز الاتحاد. تعزى ضعف نسبة العضوات في حضور الأنشطة والفعاليات في بيروت، نظراً لالتزاماتهن المهنية وعملهن استجاباًللدخل. يأتي في مقابل ذلك ضعف فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة - سيما النساء منهم – في المناطق، وبالتالي انخراط أكبر للأخيرات في أنشطة الاتحاد. أيضاًتبرز خصوصية العمل على قضايا الإعاقة في المناطق حيث يغلب العمل من منظور خدمي تنموي، مما يجعل من الاتحاد فضاءً جذاباً للأعضاء. إن خصوصية المناطقمن ناحية ضعف وجود المساحات العامة وضعف قدرات الأشخاص ذوو الإعاقة على التواجد ضمن هذه المساحات يجعل من مراكز الاتحاد مساحة لتاقيهم، مما يقويالانتماء إليه. كذلك تحضر خصوصية العمل في المركز الرئيسي في بيروت والتي تجعل منه مركزاً لإدارة البرامج والمشاريع والتفاعل مع الجهات المانحة ومع باقيأطر المجتمع المدني أكثر منه" فرعاً" بالمعنى المتعارف عليه للفروع، الأمر الذي يضعف من قدراته في استقطاب قاعدة أو جمهور أكبر. كذلك الافت على صعيد البنيةالتنظيمية لاتحاد أن الهيئة العامة تضم إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، آخرين منتسبين ومتطوعين ليسوا من ذوي إعاقة، إنما يساندون الاتحاد ويحملون قضاياه، مندون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح 162 . يعود ذلك إلى المقاربة التي اعتمدها الاتحاد وعدم انغاقه على نفسه، سيما وإن مطلب الاندماج هو من أهم مطالبالاتحاد. 163 ، المشاركة في ٢٠٠٠
تشارك عضوات الاتحاد في مهام عدة أبرزها التطوع، الاستقطاب، التعريف بالقانون ٢٢٠ المسيرات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية، المشاركة في الحماتالمطلبية، المشاركة في بناء المخيمات الصيفية وغير ذلك. بالإضافة إلى هذا، فإن قيادة الاتحاد اليوم ترأسها امرأة، كما تتولى نساء إدارة البرامج والعديد من المشاريعسواء في المركز الرئيسي في بيروت أو في المناطق 164 ، وأيضاً نظّم الاتحاد ورش التمكين السياسي للنساء ذوات الإعاقة وتوعيتهن على أهمية المشاركة في مراكزالقرار. وعليه فقد ضمت الهيئات الإدارية المتعاقبة لاتحاد نساءً بنسب متفاوتة. غير أن غلبة الحضور كانت للرجال بشكل دائم، واقتصرت نسبة وجود النساء على سيدةأو اثنتين في عضوية الهيئة الإدارية لاتحاد 165 . حتى بعد حرص قيادة الاتحاد على تشجيع سيدتين شابتين من البقاع للمشاركة في عضوية الهيئة الإدارية فيالانتخابات الأخيرة للهيئة عام ٢٠١٦ ، وانتهاء الانتخابات بفوز الشابتين من أصل اثني عشر عضواً 166 ، نجد أن قيادة الاتحاد بشكل عام هي قيادة هرمة، والعناصرالشابة شحيحة في عضوية الهيئة الإدارية لاتحاد، باستثناء الشابتين اللتين فازتا في الانتخابات الأخيرة. يبرر الأمر وفقاً لقياديين في الاتحاد "في ضعف خبرة النساءالناشطات في الاتحاد" واصفين إشراك الشابات في عضوية الهيئة الإدارية بالمخاطرة، لأنهن لم يراكمن عماً سياسياً وتجربة 167 . لذا استقر الرأي لسنوات وفيالمحطات الانتخابية المتعاقبة على إبقاء عضوية الهيئة الإدارية بأشخاص واكبوا الاتحاد لسنوات وراكموا تجربة في قيادته، وهو ما يذكرنا مرة أخرى بالإطار العاملممارسة العمل السياسي في لبنان المعتمد على شخصية الزعيم ذو الخبرة والأكبر سناً، والمتواجد في موقعه محافظاً على سلطته لعقود.
يمثل هذا الواقع أمراً مُرضياً بالنسبة لعدد كبير من أعضاء وعضوات الاتحاد ممَن التقينا بهم، ولكن لوحظ أنه عادة ما يتم الخلط بين العمل ضمن قيادة الاتحاد والعملضمن البرامج والمشاريع التي يغلب عليها حضور النساء. عبرت إحدى العضوات عن ذلك قائلة: "مش ضروري الواحد يكون ضمن الهيئة الإدارية حتى يكون ناشط. النضال ينبع من القلب ولا ضرورة للصفة للقيام به" 168 . تبدي آراء كهذه أن هناك تفضيل من العضوات للمشاركة من ضمن خارج الأدوار القيادية. وعند سؤالهنعن عدم رغبتهن في مشاركة من خال هذه الأدوار، أشارت العضوات الي التزاماتهن المهنية التي يحافظن من خالها على هامش بسيط من الاستقالية الاقتصادية، حيثشددت أكثر من عضوة بالقول "شغلي يأخذ كل وقتي وهذا بيمنعني اتطوع بشكل مناسب واكيد يمنعني من تطوير نفسي والقيام بأدوار أهم" 169 . كذلك، ترىالعضوات أن الترقي داخل الاتحاد يصحبه التزامات أكبر ويتطلب مواكبة وحضوراً في بيروت، والكثيرات منهن يسكن في المناطق )البقاع أو الجنوب تحديداً( ولاإمكانيات مسهلة تساعدهن على تخطي العوائق المتمثلة في بُعد المسافة. إضافة إلى هذا، فهناك صعوبة في توافر مواصات عامة ميسرة، بالإضافة إلى الخوف منالتعرض للتحرش أو الاستغال - كما ذُكر سابقاً - في أثناء التنقل في المواصات العامة: "أنا ما معي سيارة وبضطر أستخدم وسائل النقل العامة. بسبب وضعيالاقتصادي ما بقدر استعمل تاكسي لذلك بلجأ للباصات. هذا أزمة بالنسبة لي. بسبب الإساءات المعنوية التي أتعرض لها وصعوبة استخدامها من دون مساعدة أحد،إضافة لرفض أهلي وعدم السماح لي العودة بالليل" 170 . بالرغم من اتخاذ الاتحاد خطوات عدة نحو تمكين النساء، إلا أن الصعوبات الفعلية التي تثبط النساء عنالترقي داخله غير متناولة من قبل التدابير الداخلية، فتغيب قرارات تنظيم الاجتماعات في المناطق مثلاً -بدلًا من عقدها في بيروت- لتوفير فرص لأولاء النساءللمشاركة بشكل مختلف.
كذلك عند قراءة استراتيجية العمل التي طرحها الاتحاد عام ٢٠١٦ للسنوات الخمس المقبلة، ناحظ أنها لا تتطرق إلى البُعد الخاص بقضايا وحقوق النساء ذوات الإعاقة،أو إلى أدوار النساء في قيادة وإدارة الاتحاد. تضمنت الاستراتيجية إشارة واحدة فحسب إلى ضرورة العمل على إلغاء التمييز لكن من دون تحديد ما المقصود به، أوتأثيره الخاص على النساء ذوات الإعاقة، أو أي أهداف أو توصيات تتصل بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. تطرح الاستراتيجية تساؤلات حول أولوياتالعمل خال الفترة القادمة: التعليم، العمل، الصحة، الحقوق المدنية، وتغيب أي مقترحات تتصل بحقوق النساء ذوات الإعاقة كما تناولتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذويالإعاقة 171. بالإضافة إلى ذلك، فأحد أبرز الأمثلة هو المرصد الخاص بالانتهاكات التي تطال الأشخاص ذوي الإعاقة. لدى مراجعة موقع المرصد الإلكتروني يتبينإن الباغات الواردة إليه تندرج ضمن سياق الانتهاكات المتعلقة بالحق في العمل، الحق في بيئة مؤهلة، الحق في الوصول إلى الخدمات الصحية، الحق في التنقل، مندون وجود لأية باغات متصلة بالنوع الاجتماعي أو بانتهاكات تطال النساء ذوات الإعاقة 172 . كما أن نموذج الشكوى الخاص بالباغ عن الانتهاكات والمعتمد منجانب المرصد يغيب عنه الجانب المتصل بالنساء، وهو لا يتيح معرفة إذا وقع الانتهاك لأسباب تتعلق بالنوع الاجتماعي، باستثناء بيان نوع الجنس في النموذج. وعن إذاما كانت الانتهاكات المبّلغ عنها أو موضوع الشكوى، وفقاً للنموذج تغيب عنه أية إشارة تتصل بالعنف والتمييز الواقع على النساء ذوات الإعاقة كونهن نساء، ويقتصرالأمر على الانتهاكات العامة التي تطال ذوي الإعاقة في لبنان 173
في النهاية، بالنظر إلى الاتحاد بالمقارنة مع غيره من الكيانات الثاث السابقة، ربما يمكن اعتباره الفضاء الأكثر ترحيباً بالنساء في القيادة والقاعدة، ولكن بنيته لم تحاولرؤية النساء ذوات الإعاقة خارج إعاقتهن، صغر سنهن، قلة خبرتهن، فهي بنية ما زالت تفضل الأكبر سناً والأكثر خبرة. كذلك تأتي تدخاته وأنشطته عامة الأهدافبحيث يغيب عنها حساب الصعوبات التي تعانيها النساء ذوات الإعاقة، ولا تنتبه لمحاولة موائمة ظروفهن الخاصة والتي كما ورد تؤثر عليهن بشكل محوري.
خاتمة
حاولت هذه الدراسة تحليل بنى وممارسات ومواقف أربعة كيانات سياسية بالإضافة إلى تجارب النساء في المشاركة أو الترقي سياسياً من خالها، لتجيب عن سؤالالتحديات والعقبات التي تواجهها النساء في نشاطهن السياسي. في سعيها للإجابة عن هذا السؤال، انطلقت الدراسة من فرضية أن مزيداً من النساء في القيادة من شأنه أنيسهم في كسر الصور النمطية عن كون النساء غير مؤهات للسياسة والحكم، وأن يساعد على تحقيق المساواة الجندرية على المدى البعيد.
فقد وجدنا أن مشاركة أغلب النساء في القوات اللبنانية كانت محدودة بأدوار رعائية وخدمية أثناء فترة العمل العسكري، وحتى مَن أشتركن منهن في الأدوار العسكريةالمباشرة، قد فعلن ذلك بشكل مؤقت وخلف قيادة الرجال. حتى أثناء فترة الاعتقال والتضييق التي تعرض لها الحزب والتي خلقت مساحات أوسع للنساء، لم يترق منهنللقيادة إلا ستريدا جعجع، مؤكداً عامل العائلية السياسية الذي يؤطر رؤية الحزب للنساء. كذلك أتت بنية وممارسات الحزب لترسم أدوار محددة للنساء تتصل برؤيتهنفي أدوارهن التقليدية كراعيات وأمهات، فجاءت أكثر أدوار النساء داخل الحزب متركزة في جهاز الشؤون الاجتماعية، جهاز تفعيل دور المرأة، جهاز الشهداءوالجرحى والمصابين، بمقابل ضعف تواجد النساء في المواقع الميدانية القريبة من القاعدة الشعبية للحزب، والتي يحتل الرجال أغلبها، نظراً لقيمة تلك المواقع في بناءالتحالفات السياسية والانتخابية. وأخيراً، يظل تقاطع "المصلحة الحزبية" مع "المصلحة الطائفية" العامل الرئيسي في استبعاد النساء أولًا عند صياغة التوازنات السياسيةمن أجل ضمان المقاعد الانتخابية.
أما حملة "طلعت ريحتكم" فقد تسبب قصور النموذج الأفقي الاهيكلي الذي تبنته الحملة إلى تفرد حفنة من النشطاء بالقيادة من دون إشراك من المشاركين في قاعدةالحملة على رأسهم النساء. وجاءت مشاركة النساء بشكل "تجميلي" كواجهة إعامية للحملة، من دون مشاركتهن الفعلية في صياغة ما ألقي من بيانات، وكذلك تماقصائهن في اجتماعاتها نتيجة حضور القيادات السياسية التي دائماً ما استأثرت بالنقاش والحديث. اعتمدت الحملة مع الناشطات والمتظاهرات خطاب أبوي ارتكز علىآليات حمائية تجاهن كونهن نساءً، وبالمقابل تغاضت الحملة عن نقاش حالات التحرش الجنسي التي مسّت المتظاهرات حفاظاً على مظهر الحراك والحملة، غير آبهة بمايترتب على ذلك من إبعاد للنساء وتأثير على مشاركتهن في أنشطة الحملة.
كانت حالة نقابة المعلمين الأكثر لفتاً لانتباه، ففي كيان تمثل النساء فيه ٧٥ % من قاعدة عضويته، يندر في قيادته وجود النساء. يحول دون وجودهن عدة عوامل أهمهاتمركز أنشطة المجلس التنفيذي للنقابة في العاصمة بيروت في حين أن كثافة عضوية النقابة أكبر في المناطق، الأمر الذي يترتب عليه عدم حضور النساء في الجمعياتالعمومية وغياب تمثيل أصواتهن في تلك التجمعات. حتى النساء اللواتي يستطعن الولوج إلى مجالس النقابة، كثيرات منهن يتم اختزال مشاركتها لطريقة ملبسهاوحديثها، بدلًا مما تطرحه من أفكار. في سياق متصل، يأتي التدخل الحزبي في عمل النقابة ليؤثر على تفاعل النقابيات - مزدوجات العضوية في النقابة والحزب - ويعلي من أولوية القرارات والخيارات الحزبية عن نظريتها النقابية، خاصة في أمور الترشح في انتخابات مجلس النقابة. أخيراً، أشارت النساء إلى كون وظائفهنالرعائية ووجباتهن الاجتماعية تجاه أسرهن تتسبب بتكون صورة مجتمعية سلبية لأولاء الاتي انخرطن في العمل النقابي أو السياسي بشكل عام، فالمعلمة يجب أن تمنحالأولوية لبيتها.
أخيراً، قبل حديثهن عن قصور الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، تطرقت عضوات الاتحاد إلى تأثير بيئتهن الاجتماعية والتي بنظرهن تحول دون مشاركتهمفي الأنشطة السياسية كونها المصدر الأول للوصمة الاجتماعية التي تلصق بهن بسبب إعاقتهن وهي تشكل نظرة أسرهن ومَن حولهن وبالتالي تتحكم في تحديد حركتهنوأنشطتهن واحتمالية عملهن. بجانب العوامل البيئية، لم يمنع كون الاتحاد شبكة أمان اجتماعي للنساء ذوي الإعاقة، توفيره مساحة لترقيهن سياسياً داخله. فعلى غرارحالة النقابة، يتطلب الترقي السياسي داخل الاتحاد مواكبة الأنشطة والاجتماعات في مركزه في بيروت وهو ما لا تستطيع العديد من النساء فعله نظراً لعدم قدرتهن علىاستخدام المواصات العامة مثلاً، أو خوفهن من التحرش؛ وتغيب معظم هذه الصعوبات عن الاتحاد، وبالتالي فبنيته وممارساته لا تتناول تدابير للتعامل مع تلكالصعوبات.
إن القاسم المشترك بين الحالات الأربعة هو أن بنياها وهياكلها لا ترحب بالنساء فهي أكثر تناسباً للرجال ولا تأخذ بعين الاعتبار كيف تؤثر على حيوات النساءوتجاربهن بداخلها. الأهم هو أن كافة الكيانات لا ترى أعباء النساء القادمة من بيئتهن الاجتماعية - خاصة أسرهن ومجتمعاتهن المباشر - ولا تدرك كيف يمكن لتلكالأعباء التفاعل والتأثير على النساء داخل هذه الأطر. وعليه فهي لا توفر لهن أي أدوات تساعدهن على الموائمة بين مسؤولياتهن وأدوارهن في حال رغبن في الترقيسياسياً. وبالتالي ينتهي الحال بالنساء الي الحاجة للمفاضلة بينهما.
كذلك بدت عوامل محاكاة الكيانات الأربعة لأوجه الإطار العام للسياسة في لبنان، فوجدنا أن العائلية السياسية تتجلى في حزب القوات اللبنانية، والكوتا الطائفية فيالمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، واستخدام خطابات أبوية تنتقص من النساء ومن قدراتهن تماثل تلك التي تستخدمها السلطة مع النساء المشاركات في حركة "طلعتريحتكم"، وعوامل مثل "الأقدمية" و"الخبرة" تظهر ويتم التشديد عليها خاصة مع النساء ذوات الإعاقة في حالة الاتحاد. تمتد عوامل محاكاة النظام السياسي اللبناني إلىالنساء -اللواتي التقينا بهن - أنفسهن، فكثيرات منهن متصالحات مع هذا النظام ونواقصه وأوجه قصوره، ولا يرين بدياً عنه، ولذلك فهن يرتضينه كإطار يشاركن منخاله - خاصة وإن كان سيوفر لهن شكل من أشكال الحماية )سواء للوجود الطائفي، أو مصدر للأمان الاجتماعي والاقتصادي(. وهذا دال على ترسخ وتجذر هذا النظاموما ينضوي عليه من قيم الأبوية التي تُخْضِع النساء لها وتحرص على استمرار إخضاعهن بإشراكهن في العمل السياسي بشكل مجتزأ وشكلي. ومن هنا تطرح الدراسةسؤالًا حول ما إذا كان هناك أي فضاء يحاول كسر العجلة أو توفير معادلة بديلة للنظام السياسي القائم، وما يترتب عليه من مساحات جديدة لمشاركة النساء.





