أتاحت لنا البيانات التي تم جمعها من خلال مسح قام به مركز دعم لبنان في ٢٠١٥ إمكانية بلورة لمحة عامة عن الفاعلين/ات الأساسيين/ات في مجال الجندر، ومجالات اهتمامهم، فضلا عن ما يعتمدونه من مقاربات وأنماط تدخل. من الممكن استخلاص نتيجتين أساسيّتين للبحث بالإستناد إلى المسح والعمل الميداني: فمن جهة، عَبرت الجهات الفاعلة في مجال الجندر عن قلقها إزاء العلاقات غير المتوازنة التي تربطها بالجهات الممَوّلة لها، ومن جهة أخرى، انتقدت جميعها الآثار السلبية الناجمة عن تنفيذ مشاريع قصيرة الأجل على عملها، واستدامتها، وتعاونها بعضها البعض. يقدم التقرير حالتين مواضيعيتين مستقاة من العمل الميداني (حقوق العمل والنساء في لبنان، الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية) تظهر وجود فجوة بين الإحتياجات الفعلية التي تحددها الجهات الفاعلة نفسها في مجال الجندر، والمشاريع التي تعمل هذه الجهات الفاعلة عينها على تنفيذها. كما يقدّم التقرير توصيات موَّجهة إلى الجهات الفاعلة المحلية، إلى الدولة، وإلى الجهات المانحة.
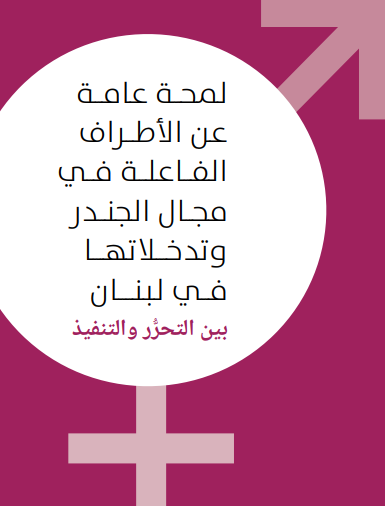
لمحة عامة عن الأطراف الفاعلة في مجال الجندر وتدخلاتها في لبنان
بين التحرُّر والتنفيذ
مقدِّمة
يعمل على وصف المنظمات النسائية في المنطقة بشكل عام، وفي لبنان بنوع خاص على أنها الرائدة في مجال إحداث تغيير إجتماعي تحرري. والواقع أننشوء الحركة النسائية في لبنان 1 حصل في أعقاب التغيرات التاريخية الرئيسة التي شهدها العالم العربي-وبشكل رئيسي في خلال فترات نيل البلدان العربيةاستقلالها ومراحل خوضها غمار التحديث المتجسِّد بالقومية العلمانية والحداثة الإسلامية 2. وأتت هذه التغيرات التاريخية بموازاة نشوء في الوقت عينهحركات مماثلة في كل من أميركا الشمالية وأوروبا 3. والحقيقة أن المنظمات النسائية اللبنانية بلغت ذروتها بعد انتهاءالحرب اللبنانية الأهلية )التي امتدت بينالعامين 1975 - 1990 (.وقد صادفت هذه الفترة مع انتهاء حقبة الحرب الباردة التي تميزت بضخ أموال خارجية ضخمة للمنظمات غير الحكومية اللبنانيةبغية تنفيذ سياسات ما بعد مرحلة الحرب الباردة ك“إرساء الديمقراطية” 4 و“الحوكمة الرشيدة”. كما تم استخدام أدوات وممارسات أخرى مثال “التمكين” و“تعميم مراعاة المنظور الجندري” من أجل قياس “التقدُّم المُحرز” ومدى “إرساء الديمقراطية” في دولة ما من خلال قياس مدى تحقيق حقوق المرأة ضمنهذه الدولة بالتحديد. وقد مهدَّت الثمانيات الطريق أمام موجة من الحوار والمطالب في ما خص حقوق المرأة، في حين شهدت أيضا دعوات لإعتماد تشريعاتوخطابات بشأن حقوق الإنسان تكون أوسع نطاقا. وفي العام 1997 ، صادق المجتمع الدولي بغالبيته، بما في ذلك لبنان، على اتفاقية القضاء على جميعأشكال التمييز ضد المرأة. وقد أتاحت هذه الإتفاقية لعدد وافر من المنظمات غير الحكومية إمكانية الإنخراط في العديد من الشبكات الدولية، ما ساهم بالتاليببروز منظمات مراعية لمتطلبات تنفيذ المشاريع إذ تعمد على استهداف النساء من خلال الإستجابة لإحتياجاتهن وتحقيق حقوقهن. وهكذا حلت المنظماتالمستهدِفة لجوانب محدَّدة من قضايا المرأة تدريجيا محل المنظمات النسوية، أو المنظمات التي تعتمد نهجا نسويا واضحا 5.
غير أن أثر الأجندات الدولية المنفَّذة عبر الجهات المانحة على المشهد المحلي بقي متفاوتا. فهي أحدثت حسا من المنافسة وسجالا بين المنظمات النسائية، كماأنتجت مشاريع قصيرة الأمد وغير قابلة للإستدامة لإرتهانها بتوافر التمويل، من جهة، وأضفت طابعا مهنيا على عمل كان في السابق تطوعيا صرف، ما كانله بالتالي وقعٌ إيجابي على جودة المشاريع 6.
وفي حين يبرز توافق بين الجهات الفاعلة والمحلِّلين بأن المنظمات اللبنانية تؤدي أو تستكمل دور الدولة من خلال إقدامها على توفير الخدمات، أو المناصرةفي سبيل إقرار سياسات، أو المشاركة في عملية صنع هذه السياسات، فإن هذه المنظمات ما زالت تصنف نفسها على أنها أشبه إلى حد بعيد بالجهات الفاعلةالعاملة على إيصال الصوت، بدلا من مجرد كونها مزوِّدة للخدمات 7. وفي الواقع، غالبا ما تكون إدعاءاتها هذه مسيَّسة للغاية إذ إنها تسعى في عملها إلىالتركيز على المجموعات المهمَّشة، وعلى المسائل التي يجب أن تعالجها الدولة من جراء ما تعتمده من سياسات.
وفي هذا السياق، يسعى التقرير إلى تقديم لمحة عامة عن الجهات الفاعلة الحالية في مجال قضايا الجندر وتدخلاتها في لبنان. كما يسعى إلى تسليط الضوءعلى العلاقة المعقَّدة بين المنظمات التي تُعنى بشؤون المرأة في لبنان والجهات المموِّلة لها. ومن الأهمية بمكان في هذا الإطار الإجابة على الأسئلة التالية: إلىأي مدى تساهم توجهات التمويل في تحديد ملامح تصميم المشاريع على المستوى المحلي؟ وهل أن المشاريع القصيرة الأمد والمتحورة حول توفير الخدماتتساهم في تنقية التغيير الإجتماعي الذي يمكن لهذه المنظمات إحداثه؟
|
الإطار 1 |
|
منهجية التقرير |
|
تتمثل المنهجية المعتمدة في هذا التقرير بمسح إلكتروني أطلق بدء من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014 بغيةمسح 36 منظَّمة تُعنى بشؤون المرأة، إلى جانب ما تنفِّذه من برامج ومشاريع 8. كما تم إجراء سلسلة من أكثرمن 10 مقابلات معمَّقة مع جهات فاعلة، وجهات مموِّلة، وجهات فاعلة محلية بالغة الأهمية في أيار/مايو 2015 . إلى ذلك، عمل على تنظيم ثلاثة طاولات مستديرة مواضعية من أجل مناقشة النتائج الأولية التي توصَّلإليها التقرير في ربيع وخريف 2015 . وفي الواقع، يستند التحليل المُنجز إلى السرد العائد للجهات الفاعلةالمحلية والذي تم جمعه في إطار المقابلات والطاولات المستديرة، كما إلى نتائج المسح، والإستعراض المكتبي للأدبيات التي عملت الجهات الفاعلة في مجال الجندر في لبنان على إنتاجها. |
1 لمحة عامة عن المشاريع التي تستهدف النساء في لبنان
أتاحت لنا البيانات التي تم جمعها من خلال المسح إمكانية بلورة لمحة عامة عن الفاعلين/ات الأساسيين/ات في مجال الجندر، ومجالات اهتمامهم، فضلاعن ما يعتمدونه من مقاربات وأنماط تدخل.
.1.1المنظمات الرئيسة التي تستهدف اليوم قضايا الجندر والنساء في لبنان
عملت 36 منظمة تُعنى بشؤون المرأة وتعمل في مجال قضايا الجندر/المرأة على تعبئة استبيان مركز دعم لبنان. ومن الأهمية بمكان الإشارة في هذا السياقإلى أن هذا العدد لا يعني أن هذه المنظمات الست وثلاثين هي المنظمات الوحيدة أو الرئيسة العاملة في هذا المجال، بل أن هذه المنظمات هي تلك التي كانتالأكثر تجاوبا مع مسح مركز دعم لبنان.
والجدير ذكره أن الجهات الفاعلة هذه هي جد متباينة لجهة الحجم، والنوع، ومجال المشاريع المنفَّذة، كما لجهة سياسات وهيكليات التمويل. فالغالبية العظمىمن هذه المنظمات تُعرِّف عن نفسها بأنها منظمة محلية من منظمات المجتمع المدني، في حين أن ما تبقى من الأطراف الفاعلة في مجال حقوق المرأةاللبنانية، فإنها عبارة عن جمعيات وائتلافات.
.1.2مجالات التركيز الأساسية
تشكِّل مسألة حقوق المرأة إلى حدٍّ بعيد مجال التركيز الأكبر بالنسبة إلى غالبية الفاعلين/ات الذين تم مسحهم ( 27 ). تليها مسألة المساواة بين الجنسين ( 13 )، والزواج المُبكر ( 5). إلى ذلك تدخل مسألة المثليين والمثليات والثنائيين والثنائيات والمتحولين والمتحولات جنسيًا ضمن مجال تركيز 4 منظمات 9 .
من الممكن اعتبار حقوق المرأة مصطلحا شاملا لكافة المشاريع التي تدخل فيها المرأة في عداد المستفيدين الرئيسيين منها. وقد يُنظر إلى ذلك كمؤشِّر لتأثيرمكوِّن “تعميم مراعاة المنظور الجندري” المنتشر في أغلبية سياسات الجهات المانحة.
وفي حين أفادت المنظمات التي تم مسحها في الإستبيان بأن “حقوق المرأة” تشكل مجال التركيز الأساسي بالنسبة إليها، تميل المقابلات المعمَّقة التي أجريتإلى إدراج فارق بسيط في هذه النتيجة.
فالأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات أكَّدوا أن من شأن غياب فهم شامل للقضايا المرتبطة ب“حقوق المرأة”، كما تجزئة رؤى المؤسسات وتخصُّصها بشأنهذا الموضوع بالتحديد إضفاء شيء من الضبابية على صورة حقوق المرأة في لبنان. إلى ذلك، سلَّطت المقابلات أيضا الضوء على أن مصطلح “المساواة بينالجنسَين” يُستخدم كمصطلحٍ جامع يشمل مختلف الأنشطة والمشاريع الجاري تنفيذها، كما تمكين المرأة على المستويَيْن السياسي والإقتصادي.
|
الإطار 2 |
|
النوع الإجتماعي/الجندر: مصطلح شامل ومتعدِّد المعاني؟ |
|
حتى منتصف القرن العشرين، كان مصطلح “النوع الاجتماعي” يُستخدم فحسب للدلالة على الفئة النحوية التيتصنّف الأسماء بين مؤنّث ومذكّر وما ليس أيًا منهما، أو تميّز بين الأشياء الحيّة وتلك الجامدة. حاليًا، يُستخدمتعبير“النوع الاجتماعي” عند الإشارة إلى الهويات الاجتماعية ك“المرأة” أو “المتحوّل/ة جنسيًا” أو “الرجل” أو“غير ذلك”. وعلى الرغم من أنّ كلمة “جنس” عينها تُستخدم للدلالة على كلٍ من النوع الاجتماعي والجنس فياللغة العربية )وعلى “الفعل الجنسي” كذلك(، إلّ أنّ التفريق الحديث بين الجنس )مذكّر - مؤنث( والنوع الاجتماعي )رجل - امرأة( قائمٌ اليوم. أمّا في اللغة الإنكليزية، يُعدّ التمييز بين النوع الاجتماعي والجنس طريقةً شائعةً لتعريف النوع الاجتماعي؛ ففيحين يُفهم الجنس في إطارٍ بيولوجي، يُبنى النوع الاجتماعي على أساسٍ اجتماعي.10 غير أنه، وبالنسبة إلى بعض المحلِّلين، قد ساهم الإستخدام الواسع النَّطاق لمصطلح “النوع الإجتماعي” في مجالالتنمية في التَّخفيف من دلالاته السياسية. وأصبح بالتالي “النوع الإجتماعي” مصطلحا شاملا لمروحة واسعة منالمعاني، والأجندات، والجهات الفاعلة المتنافسة. ويمكن التأكُّد من ذلك بنوع خاص إذ إن الجندر مصطلحٌ شاملٌلكافة البرامج المرتبطة بالنساء و المثليين والمثليات والثنائيين والثنائيات والمتحولين والمتحولات جنسيًا. أمابالنسبة إلى بعض المراقبين، فإن المصطلح الذي تنقَّل من الحركة الاجتماعية إلى التنمية خسر القوة الحاسمة فيالتعبير عن الأفكار المرتبطة بالحقوق والقوة، كما القدرة على تسليط الضوء على اللامساواة المستشرية في حياةالأفراد المتأثِّرين بعمل وكالات التنمية. وبالتالي، أصبح الجانب النسوي والتحولي للجندر ملطَّفا، كما يمكننا رؤيةذلك في برامج التمكين الإقتصادي التي تُركِّز على “تحرير” النساء من خلال تدريبهن على اكتساب مهارات وتوفير فرص عمل لهن بدون أن تأخذ أسباب القمع الهيكلية بعين الإعتبار. |
والواقع أن هذا التفاوت القائم بين خطابات المنظمات والناشطين/ات بشأن بعض المواضيع مثال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين يثير أسئلة حول تأثيراللغة المعتمدة من قبل الجهات المانحة، كما على المستوى الدولي على كيفية وصف المنظمات لعملها.
|
الإطار 3 |
|
تعميم مراعاة المنظور الجندري |
|
يشير مصطلح “تعميم مراعاة المنظور الجندري” إلى تقييم مكوِّن الجندر في التشريعات، والسياسات، والبرامجفي كافة مكوّناتها وعملياتها ذات الصلة، بدءً من التصميم، ووصولا إلى تنفيذ السياسات والبرامج، وذلك بهدفتحقيق المساواة بين الجنسَيْن. وقد برز هذا المصطلح في أعقاب نشوء الحركات النسوية في بلدان أميركاالشمالية وأوروبا بهدف تحقيق المساواة عبر اعتماد السياسات المناسبة. واليوم، يشير هذا المصطلح بالتحديد إلى السياسة التي ينتهجها المانحون وكيف أن هذه السياسة تحدِّد بشكل جوهري أجندات المنظمات. وقد أدى ذلك إلى بعض الخلافات بشأن المصطلح إذ يمكن أن يُنظر إليه على أنه ممارسة سياسية قائمة علىأساس الجندر. والواقع أن الإنتقاد الموجَّه إلى مفهوم “مراعاة المنظور الجندري” يتمثل بأن ملكية المفهوم تعودللمؤسسات بدلاً من منظمات المجتمع المدني والناشطين.
إلى ذلك، يثير المفهوم تساؤلا بشأن كيفية معالجة رؤية المساواة بين الجنسين المعتمدة من قبل المانحين إلىعوامل اللامساواة الأخرى، كالطبقة الإجتماعية، والإتنية، والدين، وكيف أن رؤية المساواة بين الجنسين هذه قدتختلف عن الإستراتيجيات المعتمدة بغية تحقيق المساواة الحقيقة للجميع، بغض النظر عن الخلفيات. والحقيقة أن ذلك دفع ببعض المنتقدين إلى اعتبار أن عملية تعميم مراعاة المنظور الجندري بوصفها استراتيجيةًلتحقيق المساواة فشلت لأسباب عدة هي: غياب الفهم الواضح بشأن المفهوم واستراتيجيات تنفيذه قبل أن تعتمده الحكومات، والهيئات الحكومية البينية، والمنظمات غير الحكومية؛ والإفتقار إلى التمويل بسبب النقص في الإلتزامالجاد، وغياب الفهم بشأن كيف لتعميم مراعاة المنظور الجندري أن يؤثّر على السياسات، والممارسات اليوميةللممارسين في مجال التنمية. إلى ذلك، لم تنجح عملية تعميم مراعاة المنظور الجندري في تحويل هيكليات القوةالقائمة، بل إنها ساهمت عوضا عن ذلك، في جعل دور المرأة أقل ظهورا إلى العيان. |
.1.3أنواع المقاربات والتدخلات
ترسم مختلف الآثار المسجلَّة في مجالات التدخل صورة مثيرة للإهتمام عن عمل المنظمات التي تُعنى بشؤون المرأة. والواقع أن مسألتي التوعية، والتنميةالإجتماعية تشكلان مجال التدخل الرئيسي، وفقا لما أفادت به تباعا 27 )التوعية(، و 22 )التنمية الإجتماعية( منظمة 9 . ولم تُشر تباعا إلا 10 )الدعمالإقتصادي( و 6 )الخدمات الطبّية( إلى الدعم الإقتصادي والخدمات الطبّية كمحور اهتمام لها. ويدل ذلك إلى مستوى عال من المهنية في صفوف موظَّفي هذهالمنظمات، إذ إن تنفيذ هذه الأنشطة يتطلّب امتلاك مهارات عالية. كما يدل أيضا على التوجه العام السائد ضمن منظمات المجتمع المدني بالتحول إلى طابعالمنظمات غير الحكومية.
وأتاح المسح أيضا إمكانية إلقاء نظرة سريعة على المانحين الرئيسيين في مجال المسائل المرتبطة بقضايا المرأة، كما على هيكليات تمويل المنظمات النسائيةفي لبنان.
.1.4الجهات المانحة الرئيسةوهيكليات تموي.ل المنظمات المحلية
تبرز في هذا المجال أنواع مختلفة من الجهات المانحة، وبشكل أساسي وكالات الأمم المتحدة، والسفارات الأوروبية، والمؤسسات الدولية، فضلا عنالمنظمات غير الحكومية الدولية، وشركات القطاع الخاص الأجنبية )مثال شركة روش للصحة(، وشركات خاصة لبنانية. ولدى تحليل هيكليات تمويلالمنظمات النسائية في لبنان، يبدو أن هذه الأخيرة تعتمد إلى حد بعيد على التمويل الدولي. وفي الواقع، 29 منظمة من المنظمات التي تم مسحها تحظى بتمويلجزئي أو كلي من الخارج، في حين أن عدداً كبيراً من المنظمات الأخرى تعتمد على رسوم الخدمات والعضوية، كما على أموالها الخاصة لتموِّل بشكل كليأو جزئي أنشطتها. إلى ذلك، صرَّحت منظمة واحدة فقط أنها تحظى حصريا بتمويل وطني، إلى جانب ما تحصل عليه من هبات )بدون أن تُحدِّد مصدرالأموال الوطنية، في سياق يطبعه شبه غياب التمويل العام لمنظمات المجتمع المدني المحلية(. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه بإمكان منظمة واحدة فقط أن توفراستدامتها الذاتية، إذ إن استراتيجيتها الإقتصادية الذاتية تشكل مصدر تمويلها.
ويشكل غياب الدعم العام الذي توفره الدولة من أجل كفالة بعض الإستقرار والإستدامة، مصدرَ قلق للكثير من المنظمات. وقد عبَّر في هذا السياق أحد ممثليمنظمة غير حكومية عن خيبة أمله قائلا: “نشعر أحيانا أن ما نقوم به لضمان التمويل ليس إلا هدرا للوقت والطاقة إذ إن المنظمات لا تحصل على أي نوع منأنواع دعم الدولة أقله لتغطية تكاليف التشغيل” 12 .
إلى ذلك، أظهرت نتائج المسح الذي تم إجراؤه فجوةً في التمويل العام الموفَّر للمنظمات العاملة من أجل تعزيز حقوق المرأة؛ الأمر الذي يولِّد ارتهانا للتمويلالدولي، ما يساهم بدوره في تحديد ملامح الديناميكيات القائمة بين الجهات المانحة من جهة، والجهات الفاعلة المحلية من جهة أخرى.
ويسلط اعتماد المنظمات المحلية إلى حد كبير على التمويل الدولي الضوء على العلاقة المعقدة القائمة بين المانحيين الدوليين والفاعلين المحليين. فمن شأن ذلكبدوره أن يثير تساؤلا بشأن التأثير المزعوم لما تعتمده الجهات المانحة من لغة وسياسات على كيفية تحديد المنظمات لهويتها ولمجال عملها.
أضف إلى ذلك أن التحليل العرضي للبيانات التي تم جمعها في المسح، والتي تُركِّز على مجالات تدخل الجهات الفاعلة وهيكليات تمويلها، يميل إلى إظهارالجهد الكبير المبذول لإضفاء الطابع المهني على العمل المنجز، كما هو مشار إليه في القسم السابق. وقد يرتبط ذلك بالقيود التي تفرضها الجهات الفاعلة )أيالقيود اللوجستية، والإدارية، فضلا عن الموظفين الماهرين، والأجور(، كما بالمسألة الأوسع نطاقا والمتمثِّلة بضرورة البحث الدائم عن مصادر تمويل منأجل توفير دعم للهيكليات القائمة والموظفين العاملين لحسابالمنظمة. وفي الواقع يأتي الإعتماد إلى حد كبير على التمويل الدولي ليؤكِّد أكثر هذه الإدعاءات.
ويدعو تحليل البحث والمقابلات المعمَّقة، ومناقشات الطاولات المستديرة إلى التساؤل بشأن العلاقة القائمة بين السياسات التي تنتهجها الجهات المانحة وشكلالمشاريع المنفّذة من قبل العيِّنة المؤلفة من الجهات الفاعلة، والمنظمات، والتجمعات المحلية التي عملنا على مسحها. ويدعو هذا التحليل بنوع خاص إلى طرحالأسئلة التالية: كيف تُحدِّد الجهات الفاعلة المحلية علاقتها بالجهات المانحة؟ كيف تتعامل هذه المنظمات مع القيود التي تفرضها الجهات المانحة، مثال القيوداللوجستية والإدارية؟ هل من الممكن تأكيد الإفتراض الأكثر شيوعا في صفوف الجهات الفاعلة المحلية بأن “المنظمات المشتبه بها” 13 تحصل على كلالتمويل الموفَّر؟ 14
وعلى الرغم من أن بعض المنظمات تعي القيود التي تفرضها حقيقة “البحث عن تمويل” والمنافسة الناجمة عن السعي وراء التمويل بين المنظمات غيرالحكومية، فإن هذه الأخيرة ما زالت تبدي إلتزاما كبيرا إزاء بلورة مشاريع تمتثل للقيم الأساسية والغايات الرئيسة المدرجة في التزامها السياسي المبدئي. غيرأن بعض الجهات المانحة تميل إلى مقاربة المنظمات غير الحكومية التي تعرفها، وغالبا ما تكون في هذه الحالة تلك التي تكون الأكثر مأسَسَةً، وتديرهاشخضيات مرموقة ومعروفة. وفي الواقع، تترتب أيضا عن هذه الحقائق آثار على العلاقات القائمة بين المنظمات النسائية في لبنان: فالمنافسة الحاصلة في مابينها سعيا للحصول على تمويل تعيق تضافر الجهود في ما بينها من أجل تحقيق اي عملية تنسيق، وإنجاز أي عمل جماعي متفق عليه.
|
الإطار 4 |
|
بعض مصادر التمويل الخاصة بالفاعلين في مجال الجندر الذين تم مسحهم |
|
المنظمات التي أفادت بأنها تعتمد حصرا على مصادر التمويل والهبات الدولية هي: مشروع الف، أبعاد: مركز الموارد للمساواة بين الجنسين، نساء رائدات، مجموعة الأبحاث والتدريب للعملالتنموي، جمعية موزايك/ Mosaic، الاتحاد النسائي العربي الفلسطيني/ PAWL ، المؤسسة العربية للحرياتوالمساواة، عدل بلا حدود، منظمة “شيلد”، كفى عنف واستغلال. وقد أفادت منظمة واحدة بأنها تعتمد على مصادر التمويل الوطني والمنح والهبات الوطنية وهي: المجلس النسائي. في حين أفادت منظمتان أخريان بأنهما تعتمدان على المنح ومصادر التمويل الوطنية، ورسوم العضوية، و/أوالهبات، وهما: جمعية الشابات المسلمات وباحثات- تجمع الباحثات اللبنانيات. أما المنظمة التي أفادت بأنها تتمتَّع باكتفاء ذاتي، فهي: تجمع النهضة النسائية. |
|
الإطار 5 |
|
الجانب السلبي لإضفاء الطابع المهني |
|
ساهمت مطالب الجهات المانحة المتمثِّلة برفع التقارير المالية واللوجستية، ووضع مؤشرات لقياس الأثر، فيزيادة الحاجة إلى عدد أكبر من الموظفين الماهرين، ما جعل المنظمات أكثر صرامة على المستوى اللوجستي. وقدأدى ذلك بدوره إلى بروز الحاجة إلى تمويل مستدام من أجل توفير حسن سير عمل المنظمة. وتسبب بالتالياعتماد المنظمات المحلية على المانحين، بغياب الإبداع والمرونة في اقتراح وتنفيذ المشاريع المستهدِفة لقضاياالمرأة. والحقيقة أن ذلك أثّر ايضا على علاقة المنظمات بمجتمع النساء الذي تعمل على مساعدته أو تمثيله، إذ إنالمنظمات عملت كمزوِّدة خدمات للنساء معتبرةً إياهن الجهات المتسفيدة مما توفِّره من خدمات، بدلا من أن تعملمعهن كشريكات متساويات معها، مرسِّخة بذلك فكرة الهرمية. |
|
الإطار 6 |
|
إستراتيجيّات للت.أقلم مع “الجهة المانحة” |
|
صنّف المؤلِّفون ضمن فئات الطرقَ التي تعتمدها المنظمات غير الحكومية لبلورة استراتيجيات مختلفة من أجلإدارة القيود المفروضة من قبل الجهات المانحة: التجنُّب )أي تفادي الإمثال لشروط بعض الجهات المانحة من خلال العمل مع الجهات الفاعلة المتوافِقة أو رفض عروضتمويل محدَّدة(؛ التأثير )أي تغيير محتوى الشروط ، واستخدام الإعتماد المتبادل كوسيلة للضغط في المفاوضات، والإقناع، وإشراك ممثّليالجهات المانحة(؛ التخفيف )أي التخفيف من أثر الشروط التي تفرضها الجهات المانحة(؛ التظاهُر )أي الإدعاء بالإمتثال للشروط المفروضة، والإمتثال السطحي والظاهري لهذه الشروط، وتوفير معلومات انتقائية(. 15 |
الشكل 1
الأطراف الفاعلة في مجال الجندر وتدخلاتها في لبنان
قام مركز دعم لبنان، في إطار مشروعه شبكة معلومات العدالة الجندرية بالشراكة مع دياكونيا، بمسح وتحليل معلومات شاملة عن المنظمات العاملة علىقضايا النوع الاجتماعي في لبنان، بالاضافة الى مجالات تدخلاتهم، مقارباتهم، وأنواع نشاطاتهم. تستند البيانات على معلومات وفّرتها 36 منظمة بين السنتين2014 و 2015 .
الرسم البياني يشير إلى أنواع تدخلات الفاعلين والفئات المستهدفة، وهي )من جهة اليسار إلى اليمين(: النساء الناشطات في كل المجالات - كافة النساء –المثليون والمثليات وثنائيو وثنائيات الميل الجنسي والمتحوّلون والمتحوّلات جنسيًا والكوير كافة الرجال - المهاجرين والعاملات الأجانب واللاجئين - المهنيينفي مجال الجمعيات والسياسات العامة، الإعلاميين والرأي العام - ضحايا العنف الجندري )نساء وأطفال( - النساء المهمشات، كالمسجونات والمصاباتبأمراض وإصابات منقولة جنسياً أو مرض السرطان، والمتعاطيات المخدرات -الشبان والشابات، بما فيه طلاب الجامعات والشباب المهمشين. كما أن الرسميشير إلى مدى وصول التدخلات إلى كل فئة.
2- نتائج البحث الرئيسة
من الممكن استخلاص نتيجتَيْن أساسيّتين للبحث بالإستناد إلى المسح والعمل الميداني: فمن جهة، عبَّرت الجهات الفاعلة في مجال الجندر عن قلقها إزاءالعلاقات غير المتوازنة التي تربطها بالجهات المموِّلة لها، ومن جهة أخرى، انتقدت جميعها الآثار السلبية الناجمة عن تنفيذ مشاريع قصيرة الأجل علىعملها، واستدامتها، وتعاونها بعضها البعض.
.2.1الشراكات غير المتوازنة
تشير النتائج التي تم التوصل إليها إلى أن اعتماد المنظمات غير الحكومية المحلية ماليا على الجهات المانحة يؤدي إلى غياب التوازن في السلطة. وبما أنوكالات التمويل قلما تشرك شركائها المحليين في بلورة السياسات، فإن الشروط التي تضعها الجهات المانحة لا تتماشى عادة مع طريقة عمل المنظمات غيرالحكومية 16 . ومن شأن ذلك أن يؤثِّر بدوره على الإستراتيجيات التي تعتمدها المنظمات غير الحكومية لإدارة القيود المفروضة من قبل الجهات المانحة.وفي هذا السياق، أظهرت النتائج التي توصل إليها العمل الميداني أن بإمكان المتطلبات المهنية المساهمة في تحويل منظمة شعبوية التوجُّه ومناضلة إلى مجردمنظمة مختصة في تزويد الخدمات. كما أن من شأن القيود التي تفرضها الجهات المانحة أن تقوِّد استقلالية المنظمات المحلية وملكيتها لما تقوم بها منتدخُّلات 17 .
إلى ذلك، فإن تسليط الضوء على المخرجات والنتائج الملموسة القابلة للتسليم يعيق قدرة المنظمات غير الحكومية على إعادة تقييم الإحتياجات المحلية، فضلاعن أن ذلك يؤثِّر على العمليات وعلى استدامة المخرجات 18 . الأمر الذي دفع بعض الأشخاص الذين أ�جريت معهم مقابلات إلى وصف منظماتهم بماتقوم به من تدخلات بأنها “مجرَّد منظمات منفِّذة لسياسات الجهات المانحة 19 ”.
وهنا لا بد لنا من الإشارة أيضا إلى تأثير الكلمات الطنّانة والتوجهات السائدة )ك“إشراك الرجال” و“الصحة الجنسية”( التي قد تدفع بعض المنظمات غيرالحكومية إلى أن تسلك المسار عينه الذي تعتمده الجهات المانحة، مغيِّرة بالتالي القيم الرئيسة التي تضعها نصب أعينها وتؤمن بها، حتى وإن جاء ذلك علىحساب تحولها إلى مجرد منظمة منفِّذة للمشاريع. ويجب ايضا ذكر الدور الذي تضطلع به تلك الكلمات التي توصف عادة بكلمات سياسات التنمية الطنانة، فيتحديد ملامح هذه السياسات بالتحديد، بما أن هذه الكلمات سرعان ما تصبح رائجة الإستعمال في خطابات المنظمات والجمعيات، كما في طريقة نشرهاللمعلومات المرتبطة بمشاريعها. والواقع أن هذه الأخيرة لا تُحدِّد إطار عمل المنظمات غير الحكومية ووكالات التنمية وحسب، بل أنها أيضا تضفي الشرعيةالتي تحتاج إليها الجهات الفاعلة في مجال التنمية لتبرِّر تدخلاتها 20 ، ناهيك عن أهيمة التلازم الدائم في استخدام كلمات رئيسة مختلفة كاستخدام كلمة“الجنسية” مع “الصحة”، أو استخدام كلمة “العنف” مع “النوع الإجتماعي”، و/أو “المرأة”. ونتيجة لذلك، تنشأ بعض المعاني الجديدة من جراء عمليات التلازموالترابط المستخدمة بين مختلف الكلمات. وفي الواقع، تخفِّف هذه المعاني من اهتمام المنظمات غير الحكومية بقضايا الجندر وتجعلها بالتالي ترى المسائلالمرتبطة بالجندر من المنظور الذي تحدِّده لها الجهات المانحة، أي المنظور الذي يركز على المرأة والعنف، بدلا ربما من تسليط الضوء على الرجل والعنف،ذلك أن الرجال هم في الغالب الذين يمارسون العنف بحق المرأة.
بالإضافة إلى ذلك، إن الكثير ممن أجريت معهم مقابلات اجمعوا على التشديد على أن آثارا سلبية على فعالية العمل تتأتى عن الوقت والجهد الإضافي الذييخصصونه للعمل مع الجهات المانحة والإستجابة لمتطلباتها.
فالقيود التي تفرضها الجهات المانحة لجهة المطالب الفنية هي عديدة وتختلف بين مرحلة تصميم المشروع والتخطيط له ضمن إطار منطقي )بما في ذلكتحديد المجموعات المستهدَفة، ومؤشرات قياس التقدم المحرز والنجاح المحقَّق، والمخرجات التي يمكن التنبؤ بها(، ومرحلة وضع التقارير المالية والسرديةالمفصلة )من أجل كفالة حسن المساءلة والأداء(. كما أن بإمكان منظمة ما ألا تستخدم الأموال المرصودة لتغطية التكاليف العامة، وفقا لما أفاد به العدد الأكبرمن الأشخاص ممَّن تم إجراء مقابلات معهم. إلى ذلك، فإن غياب التمويل الأساسي أدى إلى توزيع متناثر للموارد مع الوقت، وذلك بغية كفالة استدامة التمويلوالمشاريع، وحتى أحيانا من أجل ضمان استدامة المنظمات نفسها. كما شكَّل كل من الوقت المخصص للإستجابة لمتطلبات الجهات المانحة والجهد المبذولفي هذا الصدد مصدرَ قلقٍ عبَّر عنه الأشخاص في إطار المقابلات التي أجريت معهم، إذ إن ذلك غالبا ما يكون على حساب أنشطة أخرى يتعين على المنظمةتنفيذها. وفي الواقع، فإن الأثر البالغ المتأتي عن القيود التي تفرضها الجهات المانحة على المنظمات غير الحكومية وما تنفِّذه من أنشطة، يكشف أن الشروطالتي تضعها الجهات المانحة هذه سعيا لتحسين الفعالية، تشكِّل فعليا عائقا أمام ممارسات المنظمات.
وفي حين شدد بعض الفاعلين ممن تم إجراء مقابلات معهم على الدور الذي يؤدونه ك“مترجمين للإحتياجات المحلية إلى اللغة الدولية الخاصة بالمانحين”،وصف آخرون الوقت الذي يخصِّصونه لإجراء مفاوضات مع الجهات المانحة، والإستجابة لمتطلباتها، “بأنه أمرٌ أشبه بخوض لعبة الجهات المانحة الخاصة،بما من شأنه المساهمة في تعميق الشرخ بينهم وبين احتياجات المتسفيدين من مشاريعهم 21 . إلى ذلك، أفاد بعض الناشطين ممن أجريت معهم مقابلات، بأنوكالات الأمم المتحدة هي الأكثر “تصلبا” في ما خص الجانب اللوجستي، إذ تحظى بهيكليات وأنظمة إدارية معقدة وغير مرنة، إلى جانب كونها تفضِّل تنفيذأجنداتها الخاصة عبر استخدام مصطلحات محدَّدة ولغة خاصة بها من أجل تحديد ملامح مشروع ما. وهذا ما تسعى الجهات المانحة غالبا إلى تبريره بما أنهاهي نفسها ستخضع لمساءلة البلدان المانحة لها: فالجهات المانحة تُركِّز أحيانا على الإدارة القائمة على النتائج المترافقة مع رفع تقارير مالية وبناء قدرات،وذلك ليس من أجل تحقيق نتائج أفضل، بل أيضا تحسبا لمساءلة المكلَّفين في البلدان المانحة لها” 22 .
ويؤدي ذلك أحيانا إلى وجهات نظر متباينة وتقارير سردية متعارضة: فبينما يبدو أن المنظمات المحلية تصف علاقتها بالجهات المانحة ب“العبئ” المقيِّد، فإنالجهات المانحة ترى أن شراكاتها مع تلك المنظمات أشبه بعلاقة ترابط. لذا، فإنه بالنسبة إلى الجهات المانحة التي تم إجراء مقابلات معها في إطار هذاالتقرير، من الممكن تحسين هذه الشراكات عبر ترجمة القضايا الدولية المرتبطة بالجندر وتكييفها مع السياق الموضعي، كما من خلال دمج الفهم المحليللمسائل الخاصة ببلورة السياسات و“نقله” إلى “بلدان الجهات المانحة والمنصات والمؤتمرات الدولية” 23 . أضف إلى ذلك أن الجهات المانحة شدَّدت علىأن “الملكية المحلية” أمرٌ ضروري لتحقيق الأهداف المحدَّدة لمشروع ما. لذلك، دائما ما تعمل هذه الأخيرة على تقييم شعور منظمة ما بالملكية المحلية قبلإعطائها المنح، لتكون بالتالي بصدد تمويل مشاريع مستمدَّة من الإحتياجات المحلية.
لكن، في المقابل، يبدو أن الممارسات المطبقة على أرض الواقع تسعى إلى تحقيق توازن في هذا الصدد. فوفقا لمدير إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية،قليلةٌ هي الجهات المانحة التي تسمح بعلاقة من ندّ للند مع المنظمات المحلية: “فالجهات المانحة بأغلبيتها لا تكترث ابدا لعمليات التقييم الميداني”، ما يؤديضمن المنظمات غير الحكومية إلى توجه “للتكيف مع رغبات وكالات التمويل [...] 24 ”. من جهة أخرى، أفاد آخرون ممن أجريت معهم مقابلات بأنهم لميشعروا يوما بأن أجندات الجهات المانحة تُفرض بدون أي مراعاة عليهم، بل بالأحرى كانت الجهات المانحة تُعبِّر عن “تفضيلها” لبعض المواضيعوالمقاربات، مساهمةً بالتالي بشكل غير مباشر في توجيه تركيز مشاريع المنظمات المحلية وتدخلاتها.
غير أن بعض المنظمات التي أجريت مقابلات معها ادعت أنها تعتمد سياسة واحدة تجاه التمويل: فهي لا ترفع إلا المشاريع القائمة على الإحتياجات، ولا تقبلبالتالي التمويل الذي يفرض الإمتثال لمؤشرات لجهة الأعداد والأهداف المنوي بلوغها، ويركِّز على المشاريع الموفِّرة لخدمات نوعية. إلا أن الجانب السلبيلإنتهاج سياسة واضحة كهذه و“اعتماد موقف راديكالي بدون إبداء أي مرونة إزاء الأهداف المنوي بلوغها” 25 ، يتمثل في تزايد الصعوبات لتوفير التمويلوالإستدامة.
لذلك، فإن العلاقات القائمة مع الجهات المانحة غير متوازنة حتى الآن، على الرغم من أن عددًا متزايدًا من الجهات المانحة يسعى إلى توصل إلى وجهاتنظر مشتركة عبر خوض نقاشات وتشاورات. وفي حين أعربت بعض المنظمات غير الحكومية عن رغبتها في تغيير بيان المهمة الخاص بها وفقا للأموالالمتوافرة، فإن البعض الآخر منها اعتبر أن الإتصاق للمبادئ يشكل مصدر قلق رئيسي، وإنها بالتالي “تتشبَّث بالقضية” 26 التي شكلت بالأصل الدافعالأساسي لها.
|
الإطار 7 |
|
المؤشرات مقابل الإحتياجات |
|
أجمعت المقابلات على تسليط الضوء على أن غياب التمويل الأساسي لتغطية التكاليف العامة، وتفوّق عددالمشاريع المحدودة المدة، وكثرة المتطلبات المرتبطة بالمسائل اللوجستية وشؤون المساءلة، كلها أمور فرضتتحديات أمام البحث عن الإحتياجات وإنجاز التخطيط الطويل الأجل. إلى ذلك، أفادت الجهات الفاعلة التي أجريتمعها مقابلات بأنها تواجه مصاعب متزايدة لتوفير موارد مستدامة، بينما تُبدي تمسكها بأهدافها ومهماتهاالرئيسة. |
.2.2المشاريع القصيرة الأجل في مواجهة الإستراتيجات الطويلة الاجل: من التخصص إلى التجزئة
تُشكِّل مسألة التمويل للمشاريع القصيرة الأجل أحد مصادر القلق الرئيسة للجهات الفاعلة المحلية، بما أن هذه الأخيرة تخشى من أن يؤدي التمويل المحدودالمدة إلى الحد من أثر هذه المشاريع، في الوقت الذي لا تكون فيه عادة المشاريع والبرامج مُستدامة. وفي الواقع، اقترح عدد كبير من الجهات الفاعلة المحليةأنه يجب على عمليات التقييم التي تُجريها الجهات المانحة أن تستهدف الإستراتيجيات الطويلة الاجل، وليس مخرجات المشاريع القصيرة الأجل. ووفقا لماأفادت به عدة المنظمات غير الحكومية عاملة فقط على التمويل القائم على مشاريع، فإن تمويل المشاريع القسيرة الأجل يؤدي إلى شكلٍ من أشكالاللااستقرار، الامر الذي لا ينعكس على جودة العمل واتساقه وحسب، بل أيضا على المنظمة برمتها 27 .
وتساهم حالة اللااستقرار هذه في تغذية ثقافة المنافسة التي تنظر إلى المنظمات على أنها “شركات” مع إيلاء اهتمام طفيف لعمليَّتَي التنسيق والتشبيك. فممارسات التمويل التي تعتمدها الجهات المانحة تساهم في تأجيج الفرقة بين هذه المنظمات عبر تجزئة التمويل، والمشاريع، والمبادرات. والحقيقة أن لهذهالمشاريع القصيرة الأجل أثرا محدودا، لا سيما في ما خص إحداث تغيير مجتمعي. وفي هذا السياق، عمل مدير إحدى المنظمات غير الحكومية على إقامةمقارنة بين الموضع الحالي ونموذج الشركات موضحا أن “نموذج الإدارة الحالية للمنظمات هو أشبه بنموذج إدارة الأعمال التجارية: أي البحث أولا عنمصادر تمويل، ثم العمل في وقت لاحق على تنفيذ مشروع. فالمنظمات غير الحكومية المحلية تمتلك رؤية محدودة، إذ ليست جزءً من عملية ديمقراطيةوسياسية تمتلك أفكارا بشأن المواطنة أو التغيير”.
من جهة أخرى، اشار العديد من الأشخاص ممن أجريت مقابلات معهم إلى أن المقاربات المتمحورة حول المشاريع والتي تركزِّ على مسألة محدَّدة بدون انترتبط بالسياق الأوسع، تشكلِّ العامل الرئيسي وراء اتساع الهوة بين عمل المنظمات النسائية والكفاح النسوي الأوسع.
وكما افاد به أحد الأشخاص ممن أجريت معهم مقابلات، “هنالك خوف من الحديث عن حقوق المرأة في العالم العربي” 28 . ويُنظر إلى هذا التردد فيمعالجة حقوق المرأة على أنه العامل المسبِّب لتخصص الجهات المانحة في بعض القضايا والمشاريع، وفي الوقت عينه النتيجة المتأتية عنها.
وقد قدم غالبية الأشخاص ممن أجريت معهم مقابلات، كما المشاركين في مناقشات الطاولات المستديرة العنف القائم على النوع الاجتماعي كمثال على ذلك: فتركيز الجهات المانحة والمنظمات على العنف القائم على النوع الإجتماعي يشكل خير مثال على كيف أن موضوعا محدَّدا قد يجتذب كل مصادر التمويل، مايؤدي إلى غياب المقاربات الشاملة لحقوق المرأة. وقد صرح في هذا الصدد أحد الناشطين قائلا : “إنه لصراع عالمي! علينا أن نتحدَّث عن العنف الهيكليوالعنف الممارَس من قبل الدولة، وألا نكتفي بالتالي بالحديث عن القضايا العصرية مثال قضية العنف القائم على النوع الإجتماعي!!” 29 وتابع مشدِّدا علىضرورة، كما على أهمية ربط قضايا” محدَّدة بأسباب ومشاكل تكون “هيكلية” بدرجة أكبر.
وفي هذا السياق، يبدو أن الإفتقار إلى رؤية واسعة يساهم في إحداث تحوُّل في أنماط عمل الناشطين. وقد فسَّر ناشطٌ ومناصرٌ في سبيل تمتع المرأة بحقوقهاكيف أن في بيئة المنظمات غير الحكومية اليوم، “لا تولي المنظمات النسائية أهمية كبيرة للكفاح من أجل قضية ما”، وأن المنظمات تنشط بدلا عن ذلك فيسياق يتسم “بإضفاء الطابع الشخصي على القضية”، بما يكفل بروز منظمة واحدة في إطار الدفاع عن قضية محدَّدة.
وغالبا ما يُذكر كمثال على ذلك الإئتلاف الذي حضَّر قانون مكافحة العنف الأسري ومارس ضغطا من أجل إقراره. وقد صرح في هذا الإطار عضو فيالإئتلاف الذي ساهم في صياغة القانون قائلا “بينما ساهم ائتلافٌ من المنظمات في صياغة قانون مكافحة العنف الأسري، فإن وسائل الإعلام وفئات كبيرة منالجمهور أطلقت عليه تسمية “قانون كفى”، تيمنا بالمنظمة الأكثر ظهورا في سياق النضال من أجل إقراره” 30 .
كما قدَّم بعض الأشخاص ممن أجريت مقابلات معهم مثالا آخر على “إضفاء الطابع الشخصي على القضية” تمثل بتنامي الميل لإنشاء منظمة محلية جديدةبمساعدة وجه عام ذائع السيط بصفته “مؤسِّسا، أو رئيسا، أو مديرا للمنظمة”.
وقد أشار بعض الأشخاص ممن أجريت مقابلات معهم إلى أن هذا الميل يلقى تشجيعا ودعما من قبل ممارسات التمويل التي تعتمدها الجهات المانحة، والتيتميل أحيانا إلى تفضيل زيادة التفرقة بين صفوف الفاعلين في مجال النوع الإجتماعي. والحقيقة أن الجانب الإيجابي المتأتي عن تكاثر أعداد الفاعلين قد يكمنفي أن كل منظمة تلجأ إلى اعتماد المقاربة التي تعرفها خير معرفة من أجل توفير خدمات مهنية للمجتمعات المحلية المستهدفة. فمثلا في حالة المنظماتالعاملة على القضايا الخاصة بالكوير والمثليين والمثليات والثنائيين والثنائيات والمتحوّلين والمتحوّلات جنسيًا، أدت هذه التفرقة إلى إعادة توزيع الخدماتبالإستناد إلى ما تمتلكه كل منظمة من قدرات، وخبرات، وطرق تدخل 31 : “فالخبرة هي أفضل ما تمتلكه منظمة ما، وبالتالي يتعيِّن على كل منظمة أن تركِّزعلى ما تُحسن القيام به”. 32
وفي الواقع، تمت الإشارة في المقابلات إلى أن التفرقة التي يعمل على إحداثها بين صفوف الجهات الفاعلة تشكل مصدر قلق لهذه الجهات الفاعلة بالتحديد، مايؤدي إلى تحقيق نتائج سلبية طالما أن المنظمات النسائية هي المنظمات المعنية: فعملية بناء الإئتلافات والتشبيك تدخل ضمن العقبات التي تواجهها المنظماتوالجمعيات العاملة في مجال قضايا المرأة. وهكذا فإنه يُنظر إلى هذه الأخيرة )ووفقا للإستنتاجات التي خلص إليها العمل الميداني، تنظر المنظمات لبعضهاالبعض(، على أنها تعمل لخدمة مصالحها الخاصة، بدلا من بذل ولو القليل من الجهد، أو حتى بدون أن تسعى لتحقيق هدف أكبر أو مشترك. وبحسب مدافعمخضرم عن حقوق المرأة “يجب أن تشكل عملية التشبيك الغاية المتوخاة، لا الإستراتيجية. فعملية التشبيك ينبغي أن تكون جزءً من النضال، أو مشروعا بحدّذاته. كما يجب أن تكون قضية تستحق النضال من أجلها، إلا أن عمل المنظمات غير الحكومية موجَّهٌ إلى حد بعيد نحو المشاريع” 33 .
وقد برَّرت بعض المنظمات التي أ�جريت مقابلات معها غياب التعاون في ما بينها ب“أن بعض المنظمات تمتلك قدرات أكبر من منظمات أخرى؛ الأمرالذي يجعل من المستبعد بالنسبة إليها العمل بشكل تعاوني مع المنظمات الأخرى” 34 . وقد عبَّر ممثل منظمة غير حكومية أخرى عن الشعور نفسه بكلماتشديدة اللهجة قائلا: “لمَ التعاون مع منظمات أخرى، طالما بوسعنا تأدية العمل بمفردنا” 35 . وعليه، فإن هذه المنظمات لا تولي أي اهتمام لبناء ائتلافات أوشبكات مع منظمات أخرى، ذلك أن التعاون يقتضي تشاطر الأموال وبلورة مشاريع وفقا لآراء المنظمات الأخرى وأجنداتها. وفي ظل غياب رؤية مشتركة،أو رؤية جماعية، أو حتى مع الإفتقار إلى نقاش مفتوح بشأن مقاربات مشاريع التنمية، يجد عددٌ كبير من المنظمات أنه من غير المجدي الإنضمام إلى أيائتلاف 36 .
ووفقا لأحد الناشطين، من غير الممكن اعتبار أن المنظمات النسائية هي حركات نسوية لأنها لا تتَّخذ موقفا واضحا من القضايا السياسية: “فهي لا تولي أياهتمام للعامل الإقتصادي، كما أنها لا تسائل الدولة وتنتقد سياسات الحكومة” 37 ، بل على العكس، فإنها، وبحسب ما أفاد به بعض الأشخاص ممن أجريتمقابلات معهم، تُفضِّل إقامة علاقات مع السياسيين وصانعي السياسات، بدلا من السعي إلى إقامة روابط مع المنظمات الشعبية.
وتتمثل النتيجة الأخرى المتأتية عن تجزئة المساحات، والتخصص، وغياب التعاون، بالإفتقار إلى الشمولية، وبعدم تطابق العمل المنجز مع الإحتياجات علىأرض الواقع. ووفقا لما أفادت به ناشطة نسوية فلسطينية، “فإن المنظمات تركِّز اهتمامها على النساء اللبنانيات، بدلا من النساء في لبنان” 38 . وبحسب أحدالعاملين الفلسطينيين في منظمة غير حكومية، “فإن المنظمات غير الحكومية لا تؤمن جميعها بشمولية حقوق الإنسان”، وبالتالي فإنها لا تستهدف سوىمجموعات محددة من النساء بالإستناد إلى وضعهن الإجتماعي والسياسي، في حين أنها تتجنب استهداف النساء الأخريات وحقوقهن. وتابع هذا الأخير قائلا إنبعض المنظمات غير الحكومية تُقصي النساء الفلسطينيات بحجة أن دمجهن في أنشطتها “يزيد الأمور تعقيدا” 39 .
وبينما تعمل مروحة واسعة من المنظمات، والمشاريع، والبرامج على استهداف العاملات المنزليات المهاجرات منذ العام 2010 ، وبنوع خاص منذ اطلاقاستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين المتجسِّدة في الإتفاقية رقم 189 التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2013 ، فإن الدفاع عنحقوق “الأقليات” الأخرى، مثال النساء الفلسطينيات، ما زالت مرتبطة حصرا بعمل المنظمات الفلسطينية وتدخلاتها.
من جهة أخرى، فإن سلسلة الطاولات المستديرة المنظّمة في ربيع 2015 ، والمقابلات المعمقة التي تم إجراؤها سلطت الضوء على واقع أن الجهات الفاعلةفي مجال النوع الإجتماعي في لبنان تواجه تحديات، عندما تسعى إلى التطرق إلى مسألة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية، وحقوق العمل الخاصة بالفئات التيلا تندرج ضمن خانة العمال المنزليين المهاجرين. وقد أوضحت في هذا السياق إحدى المشاركات قائلة بشكل متعقِّل “إنه لا يسعنا اليوم كنسويات بلورةخطاب، ولا حتى برنامج تدخل بشأن القضايا الإجتماعية وتلك الخاصة بشؤون العمل.”؛ ثم اضافت “لم نتمكَّن كنسويات في لبنان من معالجة مسألة التمييزضد المرأة من منظور اجتماعي اقتصادي 40 .” أما المشاركون الآخرون فأجمعوا على تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به الجهات المموِّلة في زيادةالإهتمام بمسألة وضع البرامج والتدخلات المحلية وتوجيهها نحو تنفيذ اجنداتها الخاصة 41 .
وأتت المقابلات المتعمِّقة التي يربط فيها المجيبون مسألة توافر التمويل بالإحتياجات “الحقيقية” لتُعزِّز أكثر هذا الإعتقاد. وتُجسِّد في هذا السياق دراساتا حالةالتباين بين احتياجات التمويل الفعلية في لبنان والمشاريع المنفَّذة من أجل تلبية هذه الإحتياجات بالتحديد.
|
الإطار 8 |
|
“ما من شيء أشبه بالنضال في سبيل قضية واحدة لأننا لا نعيش حياة متمحورة حول قضية واحدة” |
|
أظهرت النتائج التي خلص إليها العمل الميداني، وجود عدد قليل من المنظمات التي تشدِّد على أهمية “العمل علىمشاريع تتمحور حول قضية واحدة”، مستبعدةً بالتالي ضرورة اعتماد مقاربة كلية، أو شاملة لل“نضال النسوي”. ففي نظر هذه المنظمات، عندما يتم التركيز على قضية واحدة، ترتفع الحظوظ في تحقيق الهدف المرجو بلوغه 42 ”. لكن لا يبدو أن هذا الأمر يُشكِّل رؤية مشتركة تتشاطرهاالمنظمات النسوية مع المنظمات العاملة على قضايا الجندر. لذلك فإن ضرورة إعادة تحديد النضال النسوي برزتمرارا في خلال المقابلات، بما يُشدِّد على الحاجة إلى خوض نضالات نسوية شاملة ومتعدِّدة الجوانب، بدلا منتنفيذ مشاريع قطاعية. وفي هذا السياق، أقر الأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم بأن مقاربة أكثر شمولية قد تثبت على المدى الطويل فعاليةً أكبر وأثرا أعلى. |
3- حالا ت مواضيعية مُستقاة من العمل الميداني
تظهر الأعمال الميدانية )أي المقابلات المعمَّقة والمسوحات(، ونقاشات الطاولات المستديرة المنظَّمة في ربيع 2015 ، فضلا عن المراجعات المكتبيةللأدبيات التي نشرتها الجهات الفاعلة في مجال الجندر، وجودَ فجوة بين الإحتياجات الفعلية التي تحددها الجهات الفاعلة نفسها في مجال الجندر،والمشاريع التي تعمل هذه الجهات الفاعلة عينها على تنفيذها.
وقد تم في إطار إعداد هذا التقرير، تحديد مسألتين مُقلقتيَن رئيسيَّتَين.
1. الكل أجمع على ذكر غياب البرامج والمشاريع المستهدِفة لحقوق النساء العاملات، وللمواضيع ذات الصِّلة كإصلاح قانون العمل أو القوانين الإجتماعيةالإقتصادية )بما يشمل كافة النساء العاملات في لبنان بمن فيهن النساء غير اللبنانيات، والإنصاف في الأجر، وإجازة الأمومة، كما العاملات منهن في القطاعغير النظامي ضمن القوى العاملة الرَّسمية...الخ(. وفي سياق يتسم بازدياد مطالب وتحركات الإتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني بشكل ملحوظ،وذلك دفاعا عن حقوق العمال والمستخدمين، وسعيا لتصحيح الأجور المتدنية، كما اعتراضا على البطالة، وغياب التغطية الصحية، وغلاء المعيشة المترافقمع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتردي ظروف العمل، يبقى أن هذه المطالب غير شامِلة للنساء العاملات.
2. إلى ذلك، وبينما تعمل العديد من المنظمات والجمعيات في لبنان على تنفيذ مشاريع ذات صلة بالحقوق الإنجابية، أو الصحة الجنسية للنساء، كما للأقليات،فإن النتائج التي خلص إليها العمل الميداني شدَّدت على أن المسائل المرتبطة بالحقوق الجنسية )كحرية اختيار الشريك، أو التمتع بحياة جنسية صحية( لاتندرج عامة ضمن مجالات اهتمام المنظمات العاملة على قضايا المرأة في لبنان. وفي الواقع، تُجسِّد هاتان المسألتان العلاقة التي تجمع بين المنظمات المحليةوالجهات المانحة، والتي تستند إلى حدّ بعيد إلى توافر التمويل وفقا لأجندات الجهات المانحة. ومن شأن ذلك بدوره أن يساهم في تحديد ملامح برامج مشاريعالتنمية المنفَّذة في لبنان.
.3.1الموضوع: 1حقوق العمل والنساء في لبنان
ساهم الإهتمام المتزايد الذي توليه المنظمات النسائية لوضع العاملات المنزليات المهاجرات في تسليط الضوء على المعاملة القانونية/غير القانونية التي تلقاهاهذه الأخيرة من قبل سلطات الدولة،ووكالات التوظيف الخاصة، و/أو أرباب عملهن. وليست المسائل المتمثلة بغياب الحماية الإجتماعية والصحية، وغالباظروف السكن المروِّعة، إلى جانب ظروف العمل اللاإنسانية، والأجور الجد المتدنية )التي غالبا ما يصادر أرباب العمل أجزاءً منها( بجديدة، ما يجعل منمعالجتها في إطار البرامج التي تبلورها المنظمات غير الحكومية أمرا بالغ الأهمية.
تعمل منظمة العمل الدولية، ضمن إطار استراتجيتها العالمية للعمل اللائق للعمال المنزليين، على حث لبنان على المصادقة على اتفاقية العمال المنزليين للعام2011 . أما على المستوى المحلي، وبعد التعبئة الدولية التي سُجِّلت في هذا السياق، فقامت منظمات غير حكومية وجمعيات عديدة )مثال كفى، وحركةمناهضة العنصرية( برفع الصوت عاليا للمطالبة باحترام حقوق العمال المنزليين، وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية، وإنشاء مراكز للمهاجرين. إلى ذلك، نُظِّمفي كانون الثاني/يناير
|
الإطار 9 |
|
نظام الكفالة: مثال آخر على إسناد مسؤوليات الدولة إلى جهات خارجية 43 |
|
يرعى نظام الكفالة عمل العمال الأجانب في لبنان، كما في بلدان الشرق الأدنى كسوريا، والأردن، واسرائيل. فهويسمح بإسناد مسؤوليات الدولة إلى منظمات غير حكومية وجهات فاعلة ضمن المجتمع المدني. ومن الأهميةبمكان فهم هذه الأمور جميعها لأنه بحسب هذا النظام أصبح بإمكان أرباب عمل العمال المهاجرين وموظِّفيهمالسيطرة عليهم، بما يخدم مصالحهم الخاصة. وبموجب نظام الكفالة، يرتبط وضع العمال المهاجرين قانونا برب عمل أو كفيل واحد طوال فترة عقد الإستخدام. ولا يُمكن بالتالي للعامل المهاجر أن يدخل البلاد، أو ينتقل إلى عمل آخر، أو حتى يغادر البلاد أيا يكن السبب، بدون الحصول أولا على إذن خطي وصريح من الكفيل. كما يجب أن يضمن كفيلٌ العامل لكي يتمكَّن هذا الأخير مندخول بلد المقصد، وهو يبقى بالتالي مرتبطا بالكفيل عينه طيلة فترة إقامته في بلد المقصد. إلى ذلك، يجب على الكفيل أن يُبلِّغ السلطات التي تُعنى بشؤون الهجرة في حال ترك العامل المهاجر العمل لديه، كما عليه التأكُّد منأن العامل غادر البلاد بعد انتهاء مدة عقد عمله، بما في ذلك تسديد تكلفة رحلة العودة إلى بلاده. وغالبا مايمارس الكفيل المزيد من الرقابة على العامل المهاجر من خلال حجز جواز سفره ومستندات السفر الخاصة به، على الرغم من أن التشريعات في بعض البلدان تعتبر أن هذه الممارسة مخالفة للقانون. وهذا الواقع يجعل العاملالمهاجر معتمدا على كفيله لتوفير سبل معيشته وإقامته. وبينما أصبح الفاعلون يرفعون الصوت في العقد الأخير اعتراضا على نظام الكفالة المطبَّق على العاملاتالمنزليات المهاجرات، إلا أن عددا قليلا منهم جاهر بموقف شاجب لهذا النظام لدى تطبيقه في 31 كانون الأول2014 على العمال السوررين. |
2015 مؤتمرٌ تأسيسي بهدف إنشاء اتحاد للعمال المنزليين، تحت مظلة الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان. وبما أن نظام الكفالة المُطبَّق،على العاملات المنزليات المهاجرات وإقصاءهن من قانون العمل أديا إلى تمييز قانوني ضد هذه الفئة المحدَّدة من النساء، فإن منظمة العمل الدولية نفَّذتمجموعة محدَّدة من التدخلات المصمَّمة خصيصا لتلبية احتياجاتهن. إلى ذلك، فإن ترتيبات معيشة العاملات المنزليات المهاجرات تجعل رصد أحوالمعيشتهن أمرا شبه مستحيل. لذلك، فإن منظمة العمل الدولية تقوم، وبالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية، بتنظيم دورات تدريبية للعاملين الإجتماعيين،على كيفية إجراء عمليات تفتيش منزلية. كما أن الإفتقار إلى آليات الرصد الرسمية دفع أيضا إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص، عبر دفع وكالاتالتوظيف على المصادقة على مدوِّنة سلوك. ومن الممكن اعتبار ذلك مثالا على كيف ينبغي أن تَتعامل الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية مع الدولةاللبنانية لإيجاد طرق للإلتفاف حول الفراغ القانوني. بالإضافة إلى ذلك، إن منظمة العمل الدولية تعمل على حمل وزارة العمل على صياغة قانون عمل يرعىتمتع حقوق العمال المنزليين بحقوقهم، وذلك بهدف توفير حماية أفضل لهم. و“مع ذلك، ومن منظور سياسي وتشريعي، لا بد من النظر إلى العمال المنزليينعلى أنهم على قدم المساوة مع العمال الآخرين، بغض النظر عن جنسيتهم، أو جنسهم، ما يُحتِّم بالتالي إدراجهم في قانون العمل” 44 .
والجدير ذكره أن منظمة العمل الدولية، كما المنظمات المحلية التي تُعنى بشؤون العمال المنزليين، وبنوع خاص العاملات المنزليات المهاجرات، تركتفراغا في ما خص حقوق النساء العاملات بشكل عام: فهذا التركيز على سوء المعاملة القصوى، والإساءة التي تقع ضحيتها العاملات المنزليات يأتي في سياقارتفع فيه عددٌ جد ضئيل من الأصوات اعتراضا على وضع العمال الآخرين الخطر )نذكر على سبيل المثال لا الحصر العمال السوريين، والسودانيين،والعراقيين، والعاملات المصريات(، أو بشكل عام، القوى العاملة في لبنان.
ففي الواقع، تتعرض النساء العاملات في لبنان للتمييز لجهة فرص التوظيف المتاحة لهن، والفجوة في الأجور بين الجنسين، كما المنافع، والإجازات المرضيةوإجازات الأمومة. إلى ذلك، فإن النساء يعملن بغالبيتهن في قطاع الزراعة وفي مجال العمل الإجتماعي، والقطاع غير النظامي. ولا شك في أن الكثير منالنساء يقمن بعمل غير مدفوع الأجر ضمن الأسر.
وبما أن الغالبية العظمى من النساء العاملات في لبنان يعملن في القطاع غير النظامي، أو ضمن الأسر، فإن الإحصاءات الرَّسمية تشير إلى أن مشاركة المرأةفي القوى العاملة لا تتعدّى % 23 ” 45 .
لذلك، فإنه لا يتم الإعتراف بعمل النساء “غير المرئيات”، لا سيما العاملات المنزليات، والعاملات في قطاع الرعاية. وفي الواقع، يعمل عدد ملحوظ منالنساء على توفير ما يُعرف ب“خدمات الرعاية” )اي تقديم الرعاية المنزلية للمسنين، أو للمرضى، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب العمل الإجتماعي(،في سياق تغيب فيه الدولة عن تقدمة الخدمات الأساسية كتوفير المآوي للمسنين، والرعاية النهارية للأطفال، وإجازات الأمومة، والإجازات الوالدية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن النساء يعملن إلى حد كبير في قطاع المجتمع المدني 46 . ويؤدي ذلك إلى شكل من أشكال الإستغلال الإقتصاديكغياب الوصول إلى الضمان الإجتماعي، وتعويضات ساعات العمل الإضافية غير المدفوعة، و“العمل التطوعي” القسري، إذ يُصوَّر هذا الأخير على أنهيُشكِّل امتدادا “طبيعيا” لدور المرأة ك“مقدِّمة رعاية”. والحقيقة أن آثارا جد ملموسة لم تعالجها بعد الجهات الفاعلة في مجال الجندر تتأتَّى عن هذه الرؤيةالنمطية القائمة على نوع الجنس التي تصوِّر المرأة على أنها المسؤولة عن توفير خدمات الرعاية.
من جهة أخرى، أظهرت النتائج التي توصَّل إليها العمل الميداني الحاجة الملحَّة إلى مراجعة قانون العمل، وتعديله، وتنقيحه ليشمل كل النساء العاملات فيلبنان: أي المواطنات اللبنانيات، كما النساء من الجنسيات السورية، والعراقية، والفلسطينية، إلى جانب العاملات المهاجرات، وهم بغالبيتهم من بلدان جنوبشرق آسيا وأفريقيا. ويجب في هذا الإطار الا يقلِّل التركيز على العمل المنزلي من أهمية النضال من أجل إعمال الحقوق الإجتماعية والإقتصادية 47 .
كذلك، لا بد من النظر إلى حقوق العمال على أنها مكوِّنٌ من مكوِّنات العدالة الإجتماعية، وخطوة بالغة الأهمية باتجاه القضاء على عدم المساواة بين الجنسين. كما ينبغي أن يضم مفهوم العدالة الإجتماعية الأوسع كافة أشكال التمييز التي يتعرض لها المواطنون اللبنانيون، والأجانب، والعاملات المنزليات المهاجرات،والمرتبطة بتكافؤ فرص العمل. ووفقا لأحد الأشخاص ممَّن أجريت معهم مقابلات، فإن المنظمات النسائية هي ضعيفة في دفاعها عن الحقوق الإجتماعيةوالإقتصادية، أو في كيفية معالجتها لقضايا التمييز: فهي لا تُوفِّر أي دعم للنقابات، ولا تُعبِّر عن أي موقف إزاء السياسات الإقتصادية، كما لا تعالج موضوعاستثناء حقوق العمال الفلسطينيين، والعراقيين، والسوريين من النقاش القانوني. إلى ذلك، فقد أثار الناشطون والمدافعون مواضيع أخرى بالغة الأهمية،وتطرقوا بنوع خاص إلى واقع أن غياب الرؤية الشاملة، والقُدوات النسائية بين صفوف المنظمات غير الحكومية، يحوِّل على ما يبدو هذه الأخيرة إلىمؤسسات بدلا من جهات فاعلة في المجال الإجتماعي. وهكذا فإنه يُعمل على تجزئة أجندات المجتمع المدني سعيا للحصول على أموال، ما يجعل الجهاتالفاعلة تخسر بالتالي قدرتها الجماعية على ممارسة ضغط على عملية صنع السياسات على مستوى الدولة.
وبتعبير آخر، أدّى إضفاء الطابع المهني على عمل المنظمات غير الحكومية إلى نشوء منظمات أقرب ما تكون إلى المؤسسات التجارية، تفتقر إلى رؤيةسياسية، أو رؤية أوسع تعدو مجرَّد تنفيذ المشاريع. وعليه، فإن المنظمات النسائية فقدت أي اتصال بالنساء اللواتي من المفترض أن تمثِّلها. ولم يعد المجتمعالمدني يمتلك أي وسيلة جدية للضغط على الحكومة، بما أنه بات يعمل وفقا لأجندات المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية الدولية 48 ، وفقا لماخلص إليه ممثِّل منظمة محلية
.3.2 الموضوع 2: الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية
“تُعتبر المقاربات التي تعتمدها المنظمات غير الحكومية المحلية إزاء الجنسانية ناقصةً، إذ إنها لا تتطرق لدى تناولها موضوع الجنسانية إلى المسائلالعنصرية، والرأسمالية، والمعاملة التمييزية على اساس طبقي. لذلك، تبرز الحاجة إلى اعتماد مقاربة شاملة، تستند إلى الشرعية المحلية، على أن تكون فيالوقت عينه غير دفاعية، ومتَّسمة بالطابع السياسي.” 49 وفي الواقع، تشمل الصحة الإنجابية القدرة على اختيار توقيت إنجاب الاطفال أو عدم إنجاب الأطفالأساسًا، والإستفادة من الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك منع الحمل والإجهاض الآمن، والرعاية ما قبل الولادة والعناية التوليدية والحصول علىالمعلومات، فضلا عن كونها تشمل أيضا حرية اختيار الشريك الجنسي.
وقد اتخذ الخطاب الدولي المُعتمد بشكل أساسي في قرارات الأمم المتحدة والمستندات الصادرة عنها بشأن الجنس شكلا جديدا مع تصور مفهوم “الحقوقالجنسية” المرتبطة بالصحة والإنجاب، والعنف. فمفهوم الحقوق الجنسية نتج عن انخراط الموجة الثانية من النسويات في العمل مع الأمم المتحدة، ومشاركتهافي المؤتمرات الدولية مثال، مؤتمر بيجين، كما تأتى عن مساهمة مجموعات المثليين والمثليات والثنائيين والثنائيات والمتحوّلين والمتحوّلات جنسيًا وحامليوحاملات صفات الجنسين والكوير.
إلى ذلك، تؤثر الأجندات والسياسات التي تتبعها المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية الدولية في تحديد ملامح المقاربات والمشاريع التي تنفِّذهاالجهات الفاعلة المحلية. والحقيقة أن المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية تسعى بشكل أساسي في لبنان، إلى تخفيض معدلات الوفياتالنُفاسية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، في حين أن منظمات المثليات والمثليين ومزدوجي/ات الميل الجنسي،ومتحولي/ات الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس، والكوير، تعمل على توفير دعم طبي، مركِّزة بالتالي على الجانب الطبي للصحة الإنجابية
|
الإطار 10 |
|
الحقوق الجنسية |
|
بصورة عامة، تشمل الصحة الإنجابية القدرة على اختيار أوان إنجاب الأطفال أو عدم إنجاب الأطفال أساسًا،والحصول على الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك منع الحمل والإجهاض الآمن والرعاية قبل الولادة ورعايةالتوليد والحصول على المعلومات. وقد رُسمت الخطوط العريضة للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية كفرعٍ من فروع حقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان الذي عُقد في القاهرة في العام 1968 . انتشرمصطلح “الصحة الإنجابية” بمعناه الحديث سريعًا عبر قنوات الأمم المتحدة وعبر المنظمات غير الحكومية عبرالوطنية. وطوّرت مؤسسات تنظيم الأسرة وحركات ومجموعات الدفاع عن صحة المرأة ومنظمة الصحة العالميةهذا المفهوم الذي بات تعريفه يشمل “حقّ جميع البشر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب بعيدًا عن التفرقة والإكراه والعنف” 50 . وكان إدراج الحقوق الإنجابية في إطار حق المرأة في تقرير مصيرها 51 تقدّميًا منحيث تصنيفه لوفيات الأمهات كانتهاك لحقوق الإنسان، وتشديده على الحق في تنظيم الأسرة، واعتبار العجز عنالحصول على وسائل منع الحمل كشكل من أشكال التفرقة.[...] بالإضافة إلى ذلك، تختلف النسويات حول ملاءمةهذا المصطلح والبرنامج الذي يطرحه، بما في ذلك مسألة استخدام مفهوم “الحقوق” الإنجابية بدلً من مفهوم“الصحة” الإنجابية الأكثر شمولً 52 . فالمفهوم الأول يشدّد على المسائل المتعلّقة بالصحة كحق ينبغي أن تؤمّنهالدولة ومؤسساتها، فيما لا يشمل المفهوم الثاني المحاسبة بل قد يهمل أيضًا الحقوق الفردية للنساء 53 . ويبرزالنقاش عينه في ما يتعلّق بمفهومي الحقوق الجنسية والصّحة الجنسية؛ فالنسويات قد يفضّلن استخدام مصطلحالحقوق الجنسية، فيما تفضّل المؤسسات الرسمية مصطلح الصحة الجنسية الأكثر “حيادية54. |
والجنسية، ومعتمدة المقاربة الطبية للجسد. بتعبيرcآخر، يبدو أن الدفة تميل لصالح الصحة على حسابcالحقوق، ولصالح الجانب الإنجابي على حسابالجنسيّ. ففي النقاشات الدولية والمحلية المتمحورة حول السياسات، يُنظر أحيانا إلى المشاكل المرتبطة بموضوع الجنسانية على أنها أقل “خطورة” وإلحاحامن مشاكل الصحة، أو العنف، أو الفقر، ما يؤدي بالتالي إلى استبعاد معالجتها. وإن هذا التعارض يميل إلى الحد من الروابط القائمة بين الإقصاء الجنسيوالفقر من جهة، وبين المسائل الخاصة بتقسيم العمل على أساس نوع الجنس، والتنميط على أساس التغاير الجنسي، و كراهية المثلية الجنسية، ومختلف أشكالالعنف، من جهة أخرى. كذلك، تميل الجهات المانحة فقط إلى معالجة القضايا المرتبطة بالمثليين والمثليات والثنائيين والثنائيات والمتحوّلين والمتحوّلات جنسيًاوحاملي وحاملات صفات الجنسين والكوير، وبالأقليات الجنسية، والعنف ضد المرأة، والعنف الجنسي، كما لو أنها تقوم بانتقاء المواضيع غير القابلة للنقاش” 55 .
وتجدر الإشارة إلى أن التمويل يخضع للمبادئ التوجيهية عينها، وهو بالتالي لا يأتي نتيجة نقاش شامل. وقد طرح في هذا السياق، الناشطون والمناصرونالأسئلة التالية الذِّكر حول ما إذا كان توافر التمويل الذي يستهدف منظمات المثليين والمثليات والثنائيين والثنائيات والمتحوّلين والمتحوّلات جنسيًا وحامليوحاملات صفات الجنسين والكوير، يعيق بذل أي جهد لمعالجة تمتع المرأة بحقوقها الجنسية. “لم تقوم حركة الكوير وحدها بمعالجة هذه القضايا؟ فهذه القضاياتعني غالبية النساء، إلا أن التمويل لا يستهدف إلا الكوير قبل النساء، في الوقت الذي لا تتمتع فيه المرأة اللبنانية بحقوق عديدة كحقها في عدم الزواج! هل هذايعني أن المعركة محسومةٌ سلفا؟” 56
وقد وصف العديد من الناشطين والفاعلين ممن تم إجراء مقابلة، بالميل السائد تحديد ملامح الخطاب المرتبط بالجنسانية من منظور تحويل المرأة إلى الضحية. ووفقا لما أفاد به ناشطٌ مخضرمٌ، فإن الأمر يبدو في هذه الحالة كما لو أن “الخطابَ دفاعيٌ، ربما بداعي الخوف؛ فمثلا يتم تناول موضوع العنف الجنسيوالتنديد به، وبما سوى ذلك من الأمور، كطريقة “محترمة” للحديث عن الجنس 57 .”وقد أقرَّت في هذا السياق مدافعةٌ عن حقوق المرأة بأن منظمتها لم تنظمقط أي ورشة عمل حول الحقوق الجنسية، على الرغم من أنها عملت إلى حد كبير على العنف الجنسي 58.
وتميل البرامج والسياسات المرتبطة بالحقوق والصحة الجنسية والإنجابية على مقاربة موضوع الجنس بوصفه أمرا ينبغي التخفيف من حدته أجل الحؤولدون وقوع أي عواقب وخيمة مثل حالات الحمل غير المرغوب بها، والإصابات، أو الأمراض المنقولة بالإتصال الجنسي، مثال فيروس نقص المناعةالبشرية/الإيدز، مستبعدةً بالتالي الجوانب الإيجابية المرتبطة بالجنس كاللذة. وقد عبَّرت الناشطات عن الحاجة إلى اعتماد مقاربة للجنس أكثر إيجابية، تُركِّزعلى جانب الجنسانية الإحتفالي. فهذه السياسات الدولية والحكومية التي تعتبر أن الجنس مسألةٌ مرتبطة بالصحة، تمنح بحكم الواقع سلطة للأطباء، والأطباءالنفسانيين، والعاملين في القطاع الصحي، ذلك أن هؤلاء يحتفظون بالمعلومات التي تتيح للمرأة التُعرُّف إلى وسائل منع الحمل أو الإجهاض الآمن. وفيالواقع، أدى “إضفاء الطابع الطبي” على قضايا الجنس بعامة، وعلى جسد المرأة بنوع خاص )منع الحمل...(، إلى ضرورة استعادة السلطة التي مُنحتللأطباء لإرجاعها إلى المرأة.” 59
كذلك، وصفت الجهات الفاعلة بالمعضلة ربط قضايا الحقوق الانجاببية والوصول الى اساليب منع الحمل بالامومة، باعتبارها جزءا اساسيا وطبيعيا ولا يتجزأمن هوية المرأة. والسبب في ذلك ان مثل هذا الربط يؤدي الى تقييد النظرة الى المرأة من منطلق دورها في الانجابي.
“في قانون الأحوال الشخصية، يتلازم ذكر المرأة مع الطِّفل. هل من وجود إذا للمرأة خارج إطار الأمومة؟ أو حتى خارج إطار الزواج؟ فدور المرأة يقتصرعلى الشِّق الإنجابي. لذا يتم تسليط الضوء بشكل واضح على دورها المهم كأم.” 60
وبالتالي يتم بحكم الواقع إقصاء النساء العاذبات من الحقوق الإنجابية، كما ذكر في هذا الصدد أحد الناشطين قائلا: “لا تستهدف حملات الصحة المنظَّمة النساءالعاذبات اللواتي يعشن بمفردهن أو الأمهات العاذبات، أو النساء اللواتي يخترن المساكنة مع شريك […]. ومرد ذلك إلى أنهن يعشن خارج إطار الزواج.” 61
وتجدر الإشارة إلى أن حالة عدم المساواة بين الجنسين والطبقات تُكرَّس في إطار الصحة الإنجابية. فالتفاوتات بين الطبقات تتجسَّد من خلال الحصول علىالإجهاض إذ إن لبعض النساء وصولا إلى العيادات الخاصة من أجل الخضوع لعمليات الإجهاض في ظروف آمنة ولائقة. والواقع أن النظام الصحيالمُخصخص يزيد من حدة المشكلة، إذ إن الضمان الصحي لا يُوفِّر اي تغطية للفحوصات، والكشوفات الخاصة بالإصابات، أو الأمراض المنقولة بالإتصالالجنسي في خلال فترة الحمل، كما أفاد به أحد الناشطين، فإن حبَّة صبَيحَةِ الجماع استُبدلت مؤخرا بحبة أعلى كلفةً.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو السياق اللبناني بهيكليته الذكورية إلى إعادة التفكير بقدرة المرأة على اختيار أوان إنجاب الأطفال أو عدم الإنجاب، بمعزل عنالضغوط الاجتماعية أو العائلية، وبحقّها في التحكّم بجسمها ورغباتها وخياراتها الجنسية: وقد صرحت في هذا السياق مدافعة عن حقوق المرأة قائلة: “لقدشهدنا تحوُّلا في الخطاب المرتبط بالعنف. لكن هذا التغيير لم ينسحب على الجنس. فإن القضايا الخاصة بالجنسانية ما زالت مُستبعدةً بسبب الطابع الديني الذييطغى على المجتمع، حتى لو أن النظام السياسي هو ديمقراطي بالمبدأ. فالمنظمات الدينية هي التي ترعى بحكم الواقع شؤون البلاد، ويشكل النقاش حولقانون الأحوال الشخصية خير دليل على ذلك.” 62 وقد لاحظت هذه المدافعة عن حقوق المرأة أيضا كيف أن المنظمات التي عملت على صياغة القانونمكافحة العنف الأسري تجنَّبت إثارة موضوع الإغتصاب الزوجي. كما أن معالجة موضوع الزواج المُبكر تُترك للمؤسسات الدينية. وقد طرحت ناشطة أخرىموضوع هيمنة المنظمات التي تعنى بشؤون الكوير على موضوع الجنسانية، ما يحول دون إثارة النِّقاش بشأن العلاقة بين البطريركية الممارَسة على جسدالنساء والأقليات الجنسية.
-4التوصيات بالخطوات المنشودة
التوصيات الموجَّهة إلى الجهات الفاعلة المحلية
- يجب أن تشكِّل عمليات تقييم الإحتياجات المحلية محور البرامج التي تنفِّذها المنظمات غير الحكومية.
- يجب أن تُركِّز الجهات الفاعلة المحلية أكثر على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، كما على حقوق العمل للنساء والأقليات )الجنسية منها،والإتنية...الخ( المقيمين في لبنان، والعاملين ضمن الأراضي اللبنانية.
- يجب أن تغيِّر الجهات الفاعلة المحلية مقاربتها التي تعمد على إظهار المرأة بمظهر الضحية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا الجنس/الجنسانية.
- يجب أن تمارس المنظمات غير الحكومية ضغطا على الدولة لمطالبتها بتحقيق تساوي الحقوق للمرأة وللأقليات، كما بتوفير الخدمات الأساسية )نذكرفي هذا السياق على سبيل المثال لا الحصر،الخدمات الخاصة بالحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية(.
- يجب أن تتعاون الجمعيات والمنظمات الشعبية مع بعضها البعض من أجل بلورة أجندة مشتركة بشأن القضايا التوافقية على الأقل. يجب أن تسعىالجمعيات والمنظمات الشعبية إلى وضع مبادئ توجيهية للشراكات المُبرمة بين الجهات المانحة/ والمنظمات المحلية.
- يجب أن تتمكَّن التدخلات في مجال النوع الإجتماعي من إحداث توازن بين التدخلات المحدَّدة الأهداف والتدخلات الشمولية، في إطار المقاربةالمزدوجة المسار
التوصيات الموجَّهة إلى الدولة
- يجب وضع سياسة عامة ترعى عمل الجهات الفاعلة المحلية ضمن المجتمع المدني، كما يجب رصد أموال عامة للمنظمات المحلية لكفالة استدامةعملها.
- يجب أن تُقِر الدولة بحقوق المرأة والأقليات الجنسية، مكرِّسة ذلك في قوانينها
التوصيات الموجَّهة إلى الجهات المانحة
- يتعين على الجهات المانحة إيلاء اهتمام أكبر للإحتياجات المحلية لدى قيامها بتصميم تدخلاتها. يجب أن تكون الجهات المانحة على بيِّنة من النتائج السلبية المتأتية عن ديناميكيات البحث عن تمويل على المنظمات المحلية، وأن تعمل بالتالي على التخفيف من آثارها عبر ما تعتمده من ممارسات.
- يجب أن تسعى الجهات المانحة إلى توفير رابط بين الأجندات الدولية والإحتياجات المحلية. لذلك، يتعين عليها أن تأخذ بعين الإعتبار السياقات والإحتياجات المحلية، عندما تقوم بتصميم تدخلاتها، وجمع الأموال بهدف تنفيذها.





