تمّ إجراء العمل الميداني في ثلاثة مواقع مختارة وهي عبرين في شمال لبنان، وشبعا في جنوب لبنان، وعاليه في جبل لبنان – بسبب تاريخها السياسيّ والإجتماعي المختلف، كما بسبب خصائصها الديموغرافيّة وتنوعها وعلاقتها مع المناطق المجاورة. أعد هذا التقرير ضمن إطار مشروع مركز دعم لبنان "حماية اللاجئين الحضريين ضمن نظام الأمن الخليط في لبنان: بحث وجدول أعمال"، بالشراكة مع منظمة "إنترناشونال آليرت". وتم تطوير الرسم البياني "الأنظمة الأمنية الخليطة غير الرسمية في مناطق مختارة في لبنان"، بالإضافة إلى المزجز للسياسات "الأمن الذي يحمي: وضع سياسات حول توفير الأمن المحلي في المجتمعات المحلية التي تستضيف لاجئين سوريين".
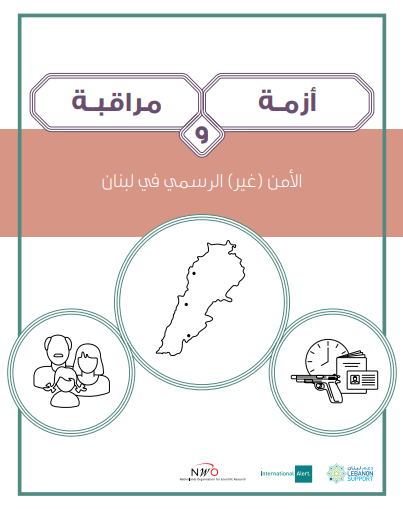
المقدِّمة
الشّرق الأوسط – حيث الجغرافيا السياسيّة غالباً ما تُشكِّل خطابات الأمن وتطبيقاته العمليّة – يُنظَر إليه على نحوٍ مُتزايدٍ على أنّه بيئة شرذمها النّزاع و"الخطر" حتّى. وفي لبنان، فالهواجس الأمنيّة الداخليّة والتي يؤجّجها إلى حدٍّ واسع تدفُّق اللاجئين بأعداد كبيرة كنتيجة للنّزاع السياسي الذي طال أمده في سوريا تُبرِّر إستجابات الدّولة القمعيّة وإعلان حالات الطّوارئ في محاولة لاحتواء التّعبئة الإجتماعيّة، والخصام الشّعبي والإنشقاق السّياسي1. فالعديد من التقارير حول الأمن في وعن لبنان يميل إلى نَسْخ الخطابات المُتمحوِرة حول الطائفيّة والقبليّة، في حين يُسيء تفسير الأمن على أنّه ظاهرة قابلة للقياس كميّاً كما يُخطئ في تحديد الأسباب الكامِنة وراء التّهديدات الأمنيّة المختلفة. وقد أولى المثقّفون وأصحاب المهنة إهتماماً غير كافٍ بكيفيّة فَهْم الجهات الفاعِلة أنفسهم لهذا المفهوم – وخاصّةً مَنْ هم في السّلطة -، ومن خلال اعتبار الأمن فئة بديهيّة للتّحليل، وكيفيّة استغلال الجهات الفاعِلة المختلفة لِمفهوم الأمن كي تُحقِّق أهدافاً سياسيّةً. وبالتّالي، فالأمن هو مفهوم مائع ومُتنازِع عليه يتمّ اختباره وتعريفه بأشكالٍ مُتنوّعة. ونتيجةً لذلك، غالباً ما يختلف النّاس في آرائهم حول أنواع التّهديدات (مَنْ أو ماذا) وكيف يجب على المجتمع أنْ يستجيب لها.
وتُهيمن نزعتان رئيسيّتان عموماً على الخطابات في لبنان حول آليّات الأمن ومُزوِّدي الأمن. فمن جهة، تجد النّزعة الثقافيّة التي تُسلِّط الضّوء على الدّور الإستثنائي للميليشيات كمُزوِّدي أمن. ومن جهة أخرى، تجد النّزعة المعياريّة والتي تُركِّز على توصيف الدّولة اللبنانيّة بشكلٍ ثابتٍ ونمطيٍّ على أنّها دولة غائبة وضعيفة بطبيعتها2.
أما من جانبنا، فقد سعَيْنا لنبقى على مسافة نقديّة من الخطابات الأمنيّة السّائدة والبالية، على اعتبار أنّ:
- الميليشيات، السّابقة منها كما الحاليّة، كانَتْ في قلب أجهزة الدّولة في لبنان منذ إتّفاق الطّائف عام 1989؛
- الدّولة اللبنانيّة، وبعيداً عن كونها مجرّد غائبة، هي فاعِلة وعامِلة على جميع الأصعدة الإجتماعيّة والإقتصاديّة والأمنيّة. وتبقى الدّولة اللبنانيّة المهندس الرئيسي للسّياسات العامّة التي تحمي في النّهاية مصالح الجهات الفاعِلة الخاصّة والتي تُشكِّل جهاز الدّولة نفسه، رغم أنّه يُنظَر إليها غالباً على أنّها ليبراليّة مقارنةً مع الديكتاتوريّات الأخرى في المنطقة العربيّة.
- إنّ عدم المُساواة الجندريّ أو بين الجنسَيْن متفشٍّ على جميع مستويات المجتمع، ويُعزِّزهُ جهاز الدّولة. في هذا السّياق، تؤثِّر أفعال الجهات الأمنيّة الرسميّة وغير الرسميّة تأثيراً لا مفرّ منه على ديناميّات الجندرة، مِمّا يُساهم أيضاً في تشكيلها بالمقابل.
عموماً، تمّت مناقشة الجهات الأمنيّة من خلال إعادة التّفكير فيما هو غير رسمي مقابل ما هو رسمي3. غير أنّ أنظمة تَوْفير الأمن، والتي تجمع معاً قوى الأمن الدّاخلي والقوّات المسلّحة اللبنانيّة أي الجيش اللبناني، والشّرطة البلديّة، والأحزاب السياسيّة المحليّة، تجتاز الحدود المفاهميّة بين تَوْفير الأمن عبر القطاع العامّ وتَوْفير الأمن عبر القطاع الخاصّ أو بين الجهات الرسميّة والأخرى غير الرسميّة4.
على صعيدٍ عالميٍّ، لم يعُدْ "ضَبْط الأمن" يُعتبَر كحكرٍ على الدّولة المركزيّة في أيّامنا هذه، لا بل مهمّة يبذل مختلف "التّرتيبات" المؤسّساتيّة الجهود لأجل إتمامها، علماً أنّ تلك الجهود يُمكن أنْ تكون عامّة أو خاصّة أو مجتمعيّة أو هجينة5. وتتألّف "الحوكمة الأمنيّة" هذه من جِهات فاعِلة رسميّة وغير رسميّة، حكوميّة أو خاصّة، تجاريّة أو مُرتكِزة على "المُتطوِّعين". هذا "التجمُّع"، كما نُشير في هذا التّقرير، يقوم بمهام تقوم على الرّقابة الإجتماعيّة، وحلّ النّزاعات، وتَعْزيز "السّلام" عبر التحسُّب للتّهديدات – الحقيقيّة أو المُتصوَّرَة – والتي تنشأ عن حياة المجتمع المحلّي. في سياقات متعدّدة، تبرز "مجتمعات محليّة" تقوم بمهام "ضَبْط أمن"6، ما يؤدّي إلى "تجمُّع إشراف"7 يتمّ وفق طريقة عمل معقّدة ويتألّف من جِهات فاعلة مختلفة ومُتغيِّرة، وممارسات إجتماعيّة ومؤسّسات.
وكما سيتّضح طوال هذا التّقرير، فهذا التجمُّع الهجين للأمن يُعيق المُقيمين المحليّين بطُرُقٍ مختلفة، كما يُعيق مجتمعات اللاجئين والمُهاجِرين، تجاه الوصول إلى مُزوِّدي أمنٍ رسميّين ومؤسّسات الدّولة لِتسوية المسائل الأمنيّة اليوميّة.
ويُشكِّل التّحقيق في وصول اللاجئين السوريّين إلى الأنظمة الأمنيّة عدسة تفسيريّة يُمكن من خلالها تفحُّص مناخ التحسُّب للعنف والقوى غير الرسميّة.
ويعكس اختيار المواقع، والتي ليسَتْ هي بالضّرورة الأماكن التي يُبلَّغ فيها عن وقوع أكثر أحداث انعدام الأمن أو فورات العنف في لبنان، كيف أنّ المجتمع المحلّي يُراقب وكيف تتمّ إدارة أزمة اللاجئين على مستوًى محليٍّ.
أهدافنا الرئيسيّة هي مُعاينة كيف أنّ اللاجئين السوريّين أثاروا بشكل خاصّ هواجس أمنيّة لدى وصولهم إلى المواقع الثلاثة في لبنان منذ عام 2011 فصاعداً؛ وكيف تُعالج الجهات الإجتماعيّة المختلفة هذه "التّهديدات" المُركّبَة؛ وكيف تُشكِّل سياسات الأمن ككلّ حياة النّاس اليوميّة. في هذا السّياق، نتفحّص كيف أنّ "الهلع المعنوي"8، والذي غالباً ما يُحرِّض عليه المُلتزِمون سياسيّاً، يُساهم في بناء انعدام الأمن الجماعيّ. وانعدام الأمن الجماعي هذا يؤسِّس لتصوُّر مُشترَك للخطر بين اللبنانيّين والسوريّين. وعموماً، لم يكُنْ تركيزنا الرئيسيّ مجرّد تقدير مَتْ يملك ومَنْ يخضع للسّلطة الأمنيّة، بل كان بالأحرى إظهار المستويات المُتعدِّدة من التّنسيق أو المنافسة القائمة بين مُزوِّدي الأمن الرسميّين وغير الرسميّين في عوالم مُصغَّرة حيث تواجه السّلطة محدوديّات بسبب تدخُّل النُّظراء.
المنهجيّة
تمّ إجراء العمل الميداني في ثلاثة مواقع مختارة ما بين شهرَيْ شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2016. وقد تمّ اختيار المواقع الثلاثة – ألا وهي عبرين في شمال لبنان، وشبعا في جنوب لبنان، وعاليه في جبل لبنان – بسبب تاريخها السياسيّ المختلف، كما بسبب خصائصها الديموغرافيّة والإقتصاديّة الإجتماعيّة. وقد تمّ اتّخاذ مقاربات رسميّة وغير رسميّة تجاه أحداث تتعلّق بالأمن في هذه المواقع الثلاثة، كما ورد في وسائل الإعلام ومواد البحث على مدى العامَيْن المُنصرِمَيْن.
فقد أُجْرِيَتْ 30 مقابلة مُعمَّقَة وشبه مُنظَّمَة مع إناث وذكور ما فوق سنّ الـ 18 من بين المُقيمين المحليّين واللاجئين السوريّين والعُمّال المُهاجرين منذ زمن طويل، والمخاتير المحليّين – وهم وُسطاء رسميّون للحكومة مسؤولون عن الشّؤون الإداريّة المحليّة -، والبلديّات، والشّرطة البلديّة، والفروع المحليّة للأحزاب السياسيّة، وكذلك المنظّمات غير الحكوميّة المحليّة أو الدوليّة التي تعمل في المواقع الثلاثة.
سعى الباحثون، من خلال مُحادثة بين مقاربات تأديبيّة مختلفة، مثل علم الإنسان وعلم الإجتماع والعلوم السياسيّة، إلى تَطوْير نقدٍ لآليّات الأمن الهجين وفهمها الإجتماعيّ في لبنان. وقد تمّ تبنّي مقاربة تفاعليّة تُركِّز على أشكال الأمن القائمة على العلاقات والإجراءات. وبالتّالي، نحن نهدف إلى النّظر في كيف تُفاوض الجِهات الفاعِلة الإجتماعيّة آليّات الأمن على أساسٍ يوميٍّ، وإلى خَلْق قاعدة أدلّة على أثر هذه التّرتيبات الرسميّة وغير الرسميّة على حماية اللاجئين في لبنان.
وفيما يتعلّق بالمنهجيّة، فحالة عبرين جديرة بالملاحظة. فأهل هذا الموقع يدركون واقع أنّ بلدتهم إكتسبَتْ أهميّةً عام 2013، حين سلّطَتْ وسائل الإعلام والمُدوِّنون الضّوء على الإجراءات الأمنيّة غير الشرعيّة المَفْروضة على اللاجئين السوريّين. في السّياق نفسه، جلبَتْ تعميمات حظر التجوُّل والتي تُنفِّذها البلديّات المحليّة في لبنان على وجه غير شرعيّ – بما أنّ فَرْضها لا يقع ضمن صلاحيّات البلديّة – إهتماماً غير مَسْبوقٍ للباحثين إلى التّطبيقات غير التقليديّة للأمن المحلّي. وبالتّالي، نظر المُقيمون المحليّون في عبرين إلى مشروعنا البحثيّ على أنّه مُتحيِّز في المقام الأوّل: مجرّد طريقة لتَفْضيل بعض الأصوات المحليّة على غيرها (الأصوات السوريّة في مقابل الأصوات اللبنانيّة). وبما أنّه لا يجب الإستخفاف بواقع أنّ المُقيمين اللبنانيّين هم أكثر أمناً أو أنّهم يشعرون بأنّهم مَحْمِيّون أكثر من اللاجئين السوريّين، بقوا هم مصدر معرفتنا الأساسيّ في المواقع الميدانيّة. وبصرف النّظر عن حالة عاليه، وهي مدينة كبيرة نسبيّاً حيث يسهل الإلتقاء والتّفاعُل مع اللاجئين السوريّين بمعزل عن المُقيمين المحليّين، فقد صَعُب الوصول إلى كلا النّساء والرّجال من اللاجئين السوريّين غالباً، ما عدا في الحالات التي لعبَتْ فيها المنظّمات غير الحكوميّة والمقيمون المحليّون والمزوِّدون دور الوُسطاء.
سوف نناقش الجهات الأمنيّة الفاعِلة الرسميّة وغير الرسميّة على أرض الواقع بعد أنْ نعرض لخلفيّة إجتماعيّة تاريخيّة لسياقات البحث الثلاثة. ومن ثمّ، سوف نُسلِّط الضوء على كيف يُفهَم الأمن ويُطَبَّق محليّاً: كمكانة إجتماعيّة، أو كمُعزِّز للهويّة المجتمعيّة، أو كإجراء ضروري لِمعالجة المخاطر الفعليّة، أو في حالات أخرى، كسبيلٍ لِمواجهة القلق الإجتماعي أو المُضايقة المُزمِنة. فانعدام الثقة النموذجي في هذه السّياقات اللبنانيّة تجاه الوافِدين الجُدُد وإدراك "الضّيافة عن غير إرادة"9 التي يُمارسها السكّان اللبنانيّون يُخفيان خلفهما التصوُّرات المختلفة لانعدام الأمن والعلاقة المعقّدة مع الخطر الفعليّ.
١. لمحة عن خلفيّة المواقع الثلاثة
لقد وقع الإختيار على ثلاث حالات لدراستها.
بلدة عاليه الواقعة في جبل لبنان هي منطقة حضريّة هجينة ديموغرافياً ذات أغلبيّة درزيّة يُنظَر إليها عامّةً على أنّها مهد الحزب التقدُّمي الإشتراكي التّابع لعائلة جنبلاط. وكانَتْ هذه البلدة واحدة من أولى البلديّات التي فرضَتْ تعميمات حظر التجوّل على اللاجئين السوريّين في نيسان/أبريل 2013، علماً أنّها معروفة بأنّها منطقة آمنة وسياحيّة رغم الإشتباكات التي حرّضت الدّروز ضدّ المسيحيّين الموارنة في عدّة مناسبات على مرّ التاريخ اللبناني.
والحال نفسها ينطبق على قرية عبرين البترونيّة والمعروفة أيضاً لأمنها. فهي منطقة متجانسة ديموغرافياً ذات أغلبيّة مسيحيّة مارونيّة تؤيِّد على العموم حزب الكتائب. وقد فرضت عبرين هي الأخرى تعميمات حظر تجوّل في ربيع عام 2013 سائرةً على خُطى مواقع أخرى في لبنان.
وتمّ اختيار قرية شبعا اللبنانيّة الجنوبيّة السنيّة، والتي فرضت حظر تجوّل عام 2014، لتجانسها الديموغرافي المماثل وأيضاً لكونها محور خلافٍ سياسيّ – على عكس عاليه وعبرين – مع جوارها. ومن بين الحالات الثلاث التي تمّت دراستها، تعكس شبعا الأحداث في سوريا أفضل انعكاس نظراً لموقعها على الحدود وطابعها السياسيّ.
بالتّالي، فإنّ الغرض من هذ التّقرير هو تحليل إجراءات التّرهيب المُعتمَدَة، ولا سيّما تعميمات حظر التجوّل، في سياقات تتّصف بسلالات أمن مختلفة، سياسيّة وإجتماعيّة. لهذا السّبب، لم تؤخَذ معدّلات أعلى من الإشتباكات أو غيرها من المسائل الأمنيّة بعين الإعتبار كعوامل مُحدِّدة في اختيار المواقع.
لا يعيش اللاجئون في المواقع الميدانيّة الثلاثة المُختارَة في مُخيّمات غير رسميّة – والتي تُولى الأولويّة لها عند تَوْزيع المُساعدات - بل في مساكن مُستأجَرَة. وفي حين أنّ هذه المعلومة لا يُقصَد منها مُطلقاً التّرويج للحجّة القائلة إنّ سُكّان المخيّمات غير الرسميّة هم أقلّ عرضةً للتّمييز والضّغينة، فهي تهدف إلى إظهار أنّ السّياسات السياسيّة القانونيّة الإقصائيّة لها أثر أكثر مباشرةً على اللاجئين الذين يعيشون وسط المجتمعات المحليّة. فيُعبَّر عن التوتُّرات في واقع الحال من خلال اعتماد تعميمات حَظْر تجوّل ودوريّات في الشّوارع، فضلاً عن إجراءات إقصائيّة أخرى، مثل الإعتقال ومُصادرة الأوراق الثبوتيّة، وهذه الممارسات هي مصدر قلقٍ أساسيّ ضمن المخيّمات غير الرسميّة أيضاً. أشكال التوتُّر هذه ليسَتْ جديدة على لبنان، إذ اعتُمدَت لتعتدي على الحقوق المدنيّة للاجئين الفلسطينيّين والذين مُنِعوا في القانون من امتلاك العقارات أو العمل في قطاعات رفيعة المستوى مهنيّاً منذ أواخر الأربعينات من القرن العاشرين وحتّى يومنا هذا10.
عاليه
يقع قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان وهو يضمّ أغلبيّة درزيّة يُقدَّر عدد سكّانها بـ 100,000 شخص. لكنّها تستضيف أيضاً أكبر عدد من السكّان غير اللبنانيّين والذين يُشكِّلون أكثر من 5 بالمئة من مُجمَل سكّانها11.
عاليه هي موطن لِحوالى 35,000 إلى 40,000 شخص وحوالى 3,500 أسرة لاجئة12، باعتبارها بلدة حضريّة تتألّف من 20 منطقة. وقد ذاع صيتها في لبنان وفي الخليح العربي على أنّها وجهة سياحيّة. وهي تتلقّى التّمويل من الإتّحاد الأوروبي، كونها واحدة من الكُتَل البلديّة الإثنتَيْ عشرة في البلد، والذي يُصرَف غالباً على التّنظيم المدني وإدارة النّفايات الصّلبة. وتستقبل عاليه الآن عدداً غير مسبوقٍ من اللاجئين. وفي الوقت الذي يُقيم فيه اللاجئون السوريّين أساساً في شققٍ سكنيّة، هم لا يستفيدون من الخدمات الإجتماعيّة العامّة، فلا يُوفَّر لهم الرّفاه إلّا بشكلٍ محدودٍ من خلال المنظّمات غير الحكوميّة13 حسبما ذكر لنا أعضاء من المجلس البلدي. غير أنّ عدد السوريّين يتضاءل باستمرار نظراً لهجرتهم غير الشرعيّة في أكثر الأحيان إلى دُوَلٍ ثالثة أو، وفي حالاتٍ قليلة، نظراً لبرامج إعادة التّوطين خارج لبنان.
قال لاجئون سوريّون، حين وُجِّه السّؤال إليهم، إنّهم استقرّوا هنا لأنّ عاليه بدَتْ لهم أكثر أماناً من بيروت، والتي خشيوا منها لأنّها أكثر "اختلاطاً" ومنصّة مهيّئة للتوتُّرات السياسيّة والإجتماعيّة. ومعظم هؤلاء الذين أُجرِيَتْ معهم المقابلات يأتون في الأصل من السويداء (جنوب سوريا) ومن سلميّة (وسط سوريا). والبعض منهم ليسوا وافدين جُدُداً: فهم إمّا لهم أقارب في البلاد وإمّا أتوا في السّابق إلى لبنان للعمل. وإلى جانب ضيافة أهل عاليه، ذكر المُقيمون أيضاً موقع البلدة المثالي على الطّريق الرئيسي الذي يربط دمشق ببيروت باعتباره عاملاً يُشجِّع اللاجئين على الإنتقال في الوقت الحاضر.
وتُشكِّل عاليه نقطة تركُّزٍ لعددٍ من الأحزاب السياسيّة كونها تكتنف عشرة مخاتر )وهم وُسطاء الحكومة المُكلَّفون بالشّؤون الإداريّة المحليّة(. ويحظى الحزب التقدُّمي الإش راكي، والذي يرأسه وليد جنب اط وهو من مؤيّدي المعارضة السوريّة، بموقع ثقلٍ محليّ .ً كما هناك وجودٌ للقوّات اللبنانيّة وحزب الكتائب، وكلاهما خصمان لنظام الأسد في سوريا، في البلدة. وعلى المقلب الآخر، تنتصب الأحزاب التي تؤيّد النّظام السوريّ في عاليه وهي الحزب الديمقراطي اللبناني الدرزي، والحزب السوري القومي الإجتماعي، والتيّار الوطني الحرّ، وحركة التّوحيد.
وغالباً ما تتمّ مناقشة البلدة ضمن تقارير العمل الميدانيّ كمنطقة تُنازع إقتصاديّاً بسبب القطاع السياحيّ المُتدهوِر. وقد حدّد مُقيمٌ محليٌّ قائلاً:
"يملك الخليجيّون الكثير من البيوت هنا، لكنّهم لا يتردّدون إليها كثيراً مؤخّراً. فهم يخافون من تصاعُد العنف وعدم الإستقرار على أثر ما يحدُث في سوريا [وبالطّبع، توصيف الخليج العربي لحزب الله بأنّه حزب إرهابيّ لن يساعد الخليجيّين على السّفر إلى لبنان]".14
وقد أكّد السكّان المحليّون في المقاب ات كلّها التي أُجْرِيَتْ على الفقر المُتزايد في منطقة عاليه. إضافةً إلى ذلك، فالوجود الشّحيح لِمُقدِّمي المساعدات الدوليّ ن، وبالمقارنة مع مناطق أخرى في لبنان مثل الشّمال وسهل البقاع، يولِّد شكلاً من أشكال الإمتعاض ب ن الأحزاب السياسيّة والجِهات البلديّة الفاعِلة، واللذان يشعران بأنّهما تُرِكا وحدهما لِيتعام ا مع أزمة اللاجئ ن في ظلّ عدم كفاية الدّعم.
وأخيراً وليس آخراً، فعاليه كانت، وكما أشار رئيس شرطتها البلديّة15، واحدة من أولى البلديّات التي فرضَتْ حَظْر التجوّل.
عبرين
عبرين هي قرية صغيرة في شمال لبنان تقع في قضاء البترون. ويبلغ عدد سكّانها حوالى 3,000 نسمة، أغلبهم من المسيحيّين الموارنة. وتُقدِّر مفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين العدد الحاليّ للاجئين السوريّين بحوالى الـ 60016. وكان لِمعظم اللاجئين أقارب في القرية ما قبل اندلاع النّزاع في سوريا. وكانوا يعملون بشكلٍ أساسيٍّ في مجالات البناء والزّراعة والبستنة. وبعد نُشوب النّزاع السوري عام 2011، أحضر العديد من هؤلاء العُمّال الذكور عائلاتهم الصّغيرة أو حتّى الكبيرة إلى القرية. ويقتصر مركز عبرين على شارعٍ صغيرٍ، حيث تقع أكثر المتاجر وفروع الأحزاب السياسيّة الرئيسيّة (الكتائب، والتيّار الوطني الحرّ، والقوّات اللبنانيّة). وتُعرِّف هذه الأحزاب الثلاثة نفسها كجزءٍ لا يتجزّأ من "المجتمع" نفسه، إذ تقف في وجه تيّار المردة والذي أسّسه سليمان فرنجيه.
مع العلم أنّ الإنتخابات البلديّة الأخيرة أجريَتْ عام 2010، فقد استقال المجلس البلدي المحلّي عام 2013 تارِكاً وراءهُ فراغاً في السّلطة17. وقد انهار المجلس عندما فشلَتْ الأحزاب السياسيّة الثلاثة في الإتّفاق على حصصها في المجلس البلدي. تُدير عبرين حاليّاً هيئة إداريّة تتّخذ مركزاً لها في قضاء البترون ويُديرها القائمقام، وهو منصب أوجده العثمانيّون. إلّا أنّه لم يُرْصَد أيّ إدارة واضحة للمنطقة من قِبَل أيّ كيان خلال رحلاتنا العديدة للقرية.
لا يتخالط اللاجئون مع المُقيمين المحليّين، حسبما تُؤكِّد التّقارير الصّادرة عن العمل الميداني، والذي قد يعود سببه جزئيّاً إلى واقع أنّ أكثر الخدمات التي لهم وصولٌ إليها تتواجد خارج عبرين. ويبدو أنّ السوريّين راحوا يُديرون حياتهم الإجتماعيّة في الغالب ضمن مركز للاجئين يقع في البترون (على بُعد 7 كلم) وتتولّى تنسيقه منظّمة غير حكوميّة، كما راحوا يمارسون حياتهم الإجتماعيّة في مسجد البترون، حيث يتسجّلون لِتلقّي المساعدات. ولا يُرسل اللاجئون أولادهم إلى المدارس الإبتدائيّة والمدارس الثانويّة المحليّة، إذ يؤثِرون أنْ يرتاد أولادهم مدرسة سوريّة تقع في قرية مجاورة.
وقد عبّر كلٌّ من القائمقام والمنظّمات غير الحكوميّة اللذَيْن أجريَتْ المقابلات معهما حاجة اللبنانيّين أنْ يتعاملوا مع وجود اللاجئين السوريّين الدّائم. شدّد عامِل إجتماعي قائلاً: "لن يرحلوا هذه المرّة"18. والإعتراف بوجودهم الدّائم يُلاحَظ في الطّبيعة الطّويلة الأمد لبعض برامج التنمية المُوجَّهة للاجئين السوريّين وللمجتمع المحلّي، في محاولةٍ لِجَعْل هذا الأخير يتكيّف مع اللاجئين على نحوٍ مُستدامٍ. وهنا، أفاد مقيمٌ محلّي19:
"لا يزال الفرق قائماً بين السوريّين الذين اعتادوا على المجيء والعمل هنا وبين اللاجئين الجُدُد. فقد كانوا يجيئون ثمّ يعودون إلى سوريا. والآن، هم جاؤوا ليبقوا. وأُشير هنا إلى أنّ الفوضى كانَتْ أكبر منذ بضعة سنوات ... كان النّاس يتنقّلون طيلة الوقت".
عندما بدأ اللاجئون السوريّون يتوافدون إلى عبرين، علّق المُقيمون المحليّون لافتات تُعلِن عن إجراءات حَظْر تجوّلٍ ليلاً وحذّروا مُقيمين آخرين من إستخدام سوريّين أو إستئجار البيوت20 لهم في محاولةٍ لتقليص أعدادهم. ومع ذلك، يستأجر كلّ اللاجئين السوريّين البيوت في القرية. وفي حين يصف بعض السكّان المحليّون حَظْر التجوّل كإجراء وقائي ضروريّ، يُفسّره اللاجئون السوريّون على أنّه رأس الهرم لعمليّة تمييز إجتماعي واسعة النّطاق.
وصف مُقيمٌ محليٌّ21 الرّفض العامّ لإقامة المخيّمات بقَوْله: "لا نُريد المخيّمات، فإذا أُقيمَتْ هذه، سوف ينتهي بنا المطاف بدعوتهم "نازحين" وليس "لاجئين"". لا تُرصَد أيّ إشارات لـِ "اللجوء" في الحياة اليوميّة. وفي هذا الإطار، فالنّاس يثبتون بأنّهم يخافون تحويل الشأن السوري إلى "فلسطين جديدة"، وفق التّسمية المزعومة، وهم يدعمون الإجراءات الأمنيّة المحليّة على أنّها الشّكل الوحيد الممكن لِضَبْط الوافدين الجُدُد. ويبرز من بين الأسباب الرئيسيّة الكامنة وراء فَرْض تعميمات حَظْر التجوّل واقع أنّ قسوة النّظام السّوري ومشهد الفلسطينيّين يصلون إلى لبنان في الأربعينات من القرن العشرين بقيا محفورَيْن في الذّاكرة الجماعيّة. وقَوْل لبنانيّ: "السوريّين هلكو الأرض" (أي السوريّون استنفذوا الأرض كلّها)، يُجسِّد المشاعر المحليّة التي سبق أنْ ذُكِرَتْ.
يبدو أنّ السوريّين الموجودين في لبنان مُعترَف بهم بأنّهم يد عامِلة أرخص في الإقتصاد الوطني. فلطالما استُخدِم المُهاجِرون السوريّون وبشكلٍ أساسيٍّ لأعمال الزّراعة والبناء والتّنظيف والبستنة حتّى ما قبل الأزمة22.
شبعا
تقع قرية شبعا في محافظة النبطيّة في جنوب لبنان، على الحدود الفاصِلة بين لبنان وسوريا وهضبة الجولان شماليّ إسرائيل وفي جوار ما يُسمّى بمزارع شبعا، وهي مساحة من الأرض إحتلّها الجيش الإسرائيلي عام 1981.
تغلب الطائفة السنيّة على سكّان شبعا المحليّين والذين يبلغ عددهم حوالى 8,000 مُقيم. والعديد من المُقيمين في البلدة لا يقطنونها إلّا في الصّيف بما أنّهم يعيشون ويعملون في بيروت أو في المُدُن المُجاورة، مثل صيدا، في بقيّة أيّام السّنة. لهذا السّبب، ينخفض عدد السكّان المحليّين إلى حوالى الـ 4,000 نسمة في فصل الشّتاء. وقد تمّ إحصاء من 5,000 إلى 7,000 لاجئ سوري في القرية منذ اندلاع النّزاع في سوريا، أتوا بمعظمهم من قرية بيت جنّ السوريّة المُجاورة. وقد رجع العديد من اللاجئين في الآونة الأخيرة إلى بيت جنّ في سوريا، ولم يختَر سوى حوالى 3,000 لاجئ فقط البقاء في شبعا. قبل نُشوب الأزمة، جمع القريتان تاريخٌ طويلٌ من التّجارة والتّهريب، خاصّةً بسبب تقاربهما الجغرافيّ. فدرج العديد من اللاجئين، وخاصّةً الذّكور منهم، على التنقُّل بين شبعا وبيت جنّ ما قبل النّزاع وخلاله. لكنْ، وبالنّسبة للعديد منهم، لم يعُدْ ذلك ممكناً بعد أنْ أعلنَتْ الحكومة اللبنانيّة عن قوانين جديدة تتعلّق بإقامة السوريّين في لبنان عمد الأمن العامّ إلى تطبيقها إبتداءاً من كانون الثاني/يناير عام 2015 وما زال. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ معظم هؤلاء الذين تحدّثنا معهم لم تكُنْ بحوزتهم أوراقٌ ثبوتيّة قانونيّة عند إجراء العمل الميداني23.
تعرّضَتْ القرية لفترةٍ طويلة للنّزاعات والمخاطر الأمنيّة نظراً لتقاربها الجغرافي مع مزارع شبعا وهضبة الجولان، بالإضافة إلى الإحتلال الإسرائيليّ الذي طال أمده. وقد زادتْ حدّة هذا التصوُّر منذ اندلاع النّزاع السّوري. فشبعا الآن هي "البلدة العالِقة بين الفكَّيْن، بين المطرقة والسندان"24، "والبلدة المُتضرِّرة بفعل الحروب على الجبهتَيْن"، وبالتّالي فهي عرضةٌ باستمرار لـِ "تسرُّبات" النّزاع المُسلَّح. ويتعزّز ما سبق أيضاً بفعل العَزْل المُتعدِّد الوجوه لِشبعا التي تقع في وادٍ تُزنِّره التّلال، وكذلك بفعل واقع أنّ البلدة هي في خِلاف طائفيّ وعقائديّ مع محيطها الذي ينطبع على الأغلب بتأْييد النّظام السّوري. كما أحاطَتْ الشّبهات بتورُّط السكّان المحليّين المُحتمَل في النّزاع السّوري، نظراً لروابط البلدة الوثيقة مع قرية بيت جنّ والتي هي معقل للجيش السّوري الحرّ، مِمّا أجّج مخاوف بأنْ تتحوّل شبعا إلى عرسال أخرى25 فتُشهد الأحداث نفسها. فيشعر المُقيمون المحليّون في شبعا واللاجئون السوريّون على حدٍّ سواء بأنّ هذه العزلة الجغرافيّة والسياسيّة ملموسة، وغالباً ما يشكوان معاً من إهمال الجِهات السياسيّة الفاعِلة والحكومة اللبنانيّة والمنظّمات غير الحكوميّة الدوليّة. ففي عددٍ من المقابلات، أُتِيَ على ذكر تحدّيات التنقُّل على أنّها واحدة من العوامل الرئيسيّة خلف عزلة القرية وذلك نظراً لِمحدوديّة البُنى التحتيّة والدّعم الإجتماعي ومرافق العمل. فيعتمد العديد من المُقيمين في شبعا على دَعْم الأقارب المُتعدِّد الوجوه والذين تركوا القرية ليذهبوا إلى بيروت أو إلى بلد أجنبي.
تُحيط شبعا، ونظراً لتقاربها المباشر مع أراضٍ خصبة للنّزاع، حواجز القوّات المسلّحة اللبنانيّة أي الجيش اللبناني وقواعد اليونيفيل. كما تنشط أجهزة مخابرات الجيش اللبناني في المنطقة، حسبما أكّد لنا عدد من السكّان المحليّين الذين أجرَيْنا معهم المقابلة26. وبالرّغم من ذلك، ففي حين بالكاد يدخل عناصر الجيش اللبناني واليونيفيل إلى القرية، وهم لا يتدخّلون عامّةً بالشّؤون المحليّة، يُقال عن مخابرات الجيش اللبناني بأنّهم يقومون بمُداهمات مُنتظمة تستهدف بيوت اللاجئين السوريّين.
تجمع بلديّة شبعا إئتلافاً من الأعضاء الذين ينتمون إلى تيّار المستقبل والذي يقوده سعد الحريري والجماعة الإسلاميّة التّابعة للإخوان المسلمين. وقد شهدَتْ الإنتخابات الأخيرة والتي أُجرِيَتْ في 22 أيّار/مايو 2016 منافسة مُتجدِّدة بين الجماعة الإسلاميّة وتيّار المستقبل اللذَيْن تمثّلا بلائحتَيْن مُتنافستَيْن. وأكّد الفَوْز الواضح للائحة تيّار المستقبل وعلى رأسها رئيس البلديّة الحاليّ محمّد سعد على فشل الجماعة الإسلاميّة في تَرْسيخ نفسها كقوّة سياسيّة محليّة. فأعرب السكّان المحليّون والذين أُجرِيَتْ معهم المقابلات عامّة عن تَأْييدهم لتيّار المستقبل، بل اعترفوا بأنّهم شعروا بأنّ الحزب أهملهم. وفي حين اكتسبَتْ الجماعة الإسلاميّة وبعض المجموعات السلفيّة وزناً في القرية منذ وصول اللاجئين السوريّين، لم يتمكّن السلفيّون حتّى الآن من انتزاع تمثيل بلديّ.
وليس ما يُشير بوضوح إلى حزب الله ولا يتمتّع الحزب بتأييدٍ شعبيّ في شبعا، رغم أنّ وجوده وسيطرته على المنطقة الجنوبيّة هما في صلب الحديث عن الأمن في لبنان. وفي الوقت الحاضر، يتدخّل حزب الله بين الفينة والأخرى في شؤون القرية وفي السّياسات البلديّة.
٢.السّلالات المحليّة للأمن أو انعدامه في المواقع الثلاثة
غالباً ما يبدو أنّ الدّافع وراء فَرْض إجراءات أمنيّة بما فيها تعميمات حَظْر التجوّل هو نوبات عنف ماضية وفورات خوف شعبيّ وانعكاسات للتوتُّر السياسيّ الإقليميّ، ما يُبرِّر الحاجة إلى فَهْم سلالات التّرهيب المُشفَّرة محليّاً. فيميل قسم واسع من وسائل الإعلام إلى حَذْف البُعد الدنيويّ للعنف مُتجاهلاً تماماً واقع أنّه كان موجوداً ومُتورِّطاً طوال عقود بالحياة العاديّة وبالظّروف السياسيّة. ويُمكن النّظر في كيفيّة التّعامُل مع انعدام الأمن كتذكُّرٍ للعنف الماضي وتحسُّبٍ للعنف المستقبلي27. وبالتّالي، يبحث هذا التّقرير في المعاني الإجتماعيّة للتّعاطي الحاليّ مع أشكال مُترقَّبَة من العنف، وكيف أنّ معانٍ مُماثلة تتغيّر باختلاف العلاقات الإجتماعيّة وأحداث التّاريخ السياسيّ.
وأيضاً، تُعزَّز آليّات الأمن غير الرسميّة عبر الفعل التكامليّ ضمناً (أو عدم الفعل) للآليّات الرسميّة. ففحين تمّ تَصْوير الجيش اللبناني لزمنٍ طويلٍ على أنّه عاجز عن حماية الأراضي اللبنانيّة، وخاصّة خلال الإعتداءات الإسرائيليّة (1978، 1982، 1996)، يُصوَّر "الضعف" العسكري المحلّي غالباً على أنّه نقيض لـِ "قوّة" الأحزاب السياسيّة اللبنانيّة. وبالفعل، غالباً ما يعتمد العسكر على الميليشيات المجتمعيّة ويميل إلى تَعْزيز قاعدة أنصارهم السياسيّين، مُتوقِّعاً منهم أنْ يمتثلوا للقانون الأخلاقي والسياسي في المجال العامّ. ويجوز التّعميم هنا عبر القَوْل بأنّ هذه الولاءات المُتبادَلة بين الأنصار والأحزاب السياسيّة تقوم ضمناً لقاء خدمات أساسيّة ومساعدة إجتماعيّة تعجز الحكومة المركزيّة عن تقديمهما. ففي أعقاب النّزاع السوريّ والتدفُّق الهائل للاجئين السوريّين كنتيجة له، تلقّى قطاع الأمن الهجين الذي أُسِّس له تاريخيّاً إهتماماً محليّاً ودوليّاً مُتزايداً، وبالتّالي، تمّ التوقُّع منه أنْ يتكيّف مع التحدّيات الجديدة ومع "تسرّب" العنف. كاستجابة لهذا الوضع، كثّفَتْ الدّولة اللبنانيّة إجراءات التّرهيب المحليّة، بالتّوازي مع الآليّات غير الرسميّة لِتَوْفير الأمن.
ولا بُدّ من النّظر إلى آليّات التّرهيب هذه على ضوء تاريخ سوريّ-لبنانيّ مُترابِط28 ومَشوب بانعدام الثقة المُتبادَل، ما يُسهم في شَرْح اعتماد إجراءات أمنيّة مختلفة. فعلى خلاف شبعا، لا عاليه ولا عبرين تعانيان بشكل خاصٍّ من الحرمان من الخدمات أو من معدّلات بطالة محليّة عاليّة عندما تمّت مقارنتهما مع مناطق لبنانيّة أخرى (مثل قضاء طرابلس أو منطقة عكّار الشماليّة). مع ذلك، فرضَتْ المواقع الثلاثة كلّها إجراءات أمنيّة ضدّ اللاجئين السوريّين. ولِتَبْرير هذه الإجراءات، قال معظم المُقيمين إنّها لم تُتَّخَذ نظراً لعدد السوريّين الكبير بالمقارنة مع اللاجئين العراقيّين أو السودانيّين حول لبنان، بل أيضاً نظراً لخصوصيّات علاقتهم المُتناقضة مع جارهم السوريّ29.
عاليه هي الموقع الميدانيّ الوحيد بين المواقع الثلاثة حيث أنّ تعميمات حَظْر تجوّلٍ كانَتْ قد نُفِّذَتْ في الماضي. فيتذكّر المُقيمون المحليّون حَظْر التجوّل الذي طُبِّق خلال الإجتياح الإسرائيلي عام 1982 (إبتداءاً من السّاعة 6 مساءً على ما يبدو، رغم أنّ أحداً لم يوثِّق هذه المعلومة) وخلال حرب الجبل (1982-1984). يتذكّر عضوٌ من حزب الكتائب30 في عاليه حين فرض الجيش الإسرائيلي إجراءات أمنيّة في المدينة عبر تَقْسيمها على أساسٍ طائفيٍّ، فيقول:
"عندما كان الإسرائيليّون هنا، لم يُفرَض حَظْر تجوّلٍ حقيقيّ. لا بل اكتفوا بتقسيم الحيّ الغربي من عاليه ببساطة إلى قسمَيْن ومنعوا المسيحيّين الذين يعيشون في الحيّ الأسفل [حيث ما زالَتْ الكنائس قائمة] من الذّهاب إلى الحيّ الأعلى [واسمه الخلّة، حيث جرَتْ عمليّات القتل]. لقد أطلق أحد القادة العسكريّين الإسرائيليّين النار عليّ مرّةً إذ كنّا نتسلّل بشكل غير شرعيّ إلى الحيّ الأعلى".
وأيضاً، يتذكّر السكّان المحليّون تعميمات حَظْر التجوّل التي فرضها الجيش السوري خلال سنوات "الوكالة السوريّة" على لبنان. فيتذّكر عضوٌ في حزبٍ سياسيٍّ في عاليه31 قائلاً: "كانوا أكثر صرامةً حتّى وقد نصبوا الحواجز أيضاً".
حين بدأ اللاجئون يصلون من سوريا، حسبما يتذكّر بعض الأشخاص الذين أجَرْينا مقابلات معهم، أحرقَتْ مجموعة من الرّجال المحلّات التجاريّة التي يملكها سوريّون انتقاماً من النّظام السوري. أشار لاجئٌ سوريٌّ قائلاً32: "حتّى ولو جنبلاط [وهو شخصيّة سياسيّة نافِذة جدّاً في عاليه كزعيم للحزب التقدُّمي الإشتراكي] يقف مع الثّورة السوريّة، فهو ليس مع الشّعب السّوري". في هذا الإطار، فتصوُّرات الأمن لدى اللاجئين تنبع من شعورهم بأنّهم مَوْصومون سياسيّاً، إمّا مع نظامهم أو ضدّه.
آخر فصول العنف التي يتذكّرها السكّان المحليّون هي إشتباكات أيّار/مايو عام 2008 بين التحالفَيْن السياسيَّيْن الرئيسيَّيْن في لبنان [تحالف 14 آذار بقيادة تيّار المستقبل التّابع لِسعد الحريري وتحالف 8 آذار بقيادة حزب الله]. وبقدر ما يتذكّر السكّان المحليّون، فالإشتباكات أدّت إلى مقتل 16 عضواً من حزب الله. ورغم ذلك، أشار مُقيمٌ محليٌّ: "لا يمكنني أنْ أفعل شيئاً لأشعر بأنّني أكثر أماناً. حين أرى الدّولة والجيش اللبناني وقوى الأمن الدّاخلي، أرتاح"33.
اليوم، لا يُنظَر إلى اللاجئين على أنّهم سببٌ وراء مشاكل أمنيّة مُحدَّدَة. فقد أشار شرطيّا بلديّة34 إلى أنّ الأمن وحماية اللاجئين يجب أنْ يُنظَر إليهما كوجهَيْن لعملة واحدة. وقد ذكرا النّزاعات الشخصيّة أو السياسيّة فيما بين المجتمعَيْن المحلّي واللاجئ أو ضمنهما كمصدر لعدم الإستقرار المُتفرِّق.
رغم أنّه لا يبدو في الظّاهر أنّ هناك قضايا أمنيّة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود اللاجئين السوريّين في عاليه، فبعض شرائح المجتمع المحلّي تميل إلى التمسُّك بالشكّ والرّيبة تمسُّكاً شديداً. لنأخذ على سبيل المثال تأكيد واحدٍ من السكّان المحليّين35: "لم يعتَدْ السوريّون على بعض الأمور [كطريقة لبْس النّساء هناك] ... ولذلك حدث ما حدث في ألمانيا"36. وبالفعل، يُصوَّر السوريّون على أنّهم أكثر تحفُّظاً في العادات والممارسات الإجتماعيّة. ونتيجةً لذلك، يُصوَّر الرّجال السوريّون بشكلٍ خاصّ على أنّهم مصدر انعدام الأمن بالنّسبة للنّساء اللبنانيّات، بسبب الخوف من التحرُّش الجنسي والعنف الجنسي. وعلاوةً على ذلك، فإنّ تصوّر اللاجئين السوريّين بأنّهم يُقرَنون بإحتلال النّظام للبنان حتّى شهر نيسان/أبريل عام 2005 تؤكِّد عليه كلمات لاجئ سوريّ: "كلّما وقع سوءٌ، يُلقى اللوم على السوريّين. لكنْ الأمر يعتمد أيضاً على انتمائنا الطائفيّ، ما يُغيِّر تصوّرات النّاس. أؤمن أنّ الإندماج هنا قليل، حتّى ضمن المجتمعات المحليّة"37.
وها حديث سيدة من السكّان المحليّين تعكس تصوُّر اللاجئين بأنّهم غير مُرَحَّب بهم وبأنّهم كبش محرقة.
"السوريّون وسخون وهم يتكاثرون جدّاً ... 50% منهم تركوا البلد عبر التّهريب والهجرة إلى أوروبا بسبب القوانين هنا. لكنْ منطقتنا هي منطقة آمنة عموماً: فما دُمنا ننعم بشرطة وطنيّة وشرطة بلديّة، ننعم بمساعدة فوريّة. لكنّني أظنّ أنّ البلديّة تُخفي أموراً عنّا لكي تُطمئننا على أمننا. أنا متأكّدة من ذلك"38.
ويتذكّر المُقيمون في عبرين بدورهم الحواجز التي أقامها نظام الأسد (1976-2005) لمُراقبة أرضهم في حين تنعّموا بدَعْم القرية الشيعيّة المُجاورة رشكيدا. ويتذكّر المُقيمون أيضاً كيف أنّ جيش الأسد درج على إيقاف السكّان المحليّين تعسُّفاً. قال واحدٌ من السكّان المحليّين39: "أظنّ أنّ النّاس يريدون الآن أنْ ينتقموا، وهم يستخدمون اللاجئين لِتَحْقيق هذه الغاية. هؤلاء الجنود كانوا سوريّين، وما زلْنا نشعر بأنّنا مَجْروحون". وتجدر الإشارة إلى أنّ الجيش السوري لم يُحاسَب يوماً على الجرائم التي ارتكبها، بسبب هيمنته على لبنان، بما في ذلك مضايقة المواطنين اللبنانيّين.
وعلى خلاف عاليه، وبقدر ما يتذكّر السكّان المحليّون في عبرين، لا توجَد أمثلة تاريخيّة أخرى عن تعميمات حَظْر تجوّل في القرية. ففي الواقع، يصف السكّان المحليّون تاريخ قريتهم بأنّه مُستقيم ومُتجانس تماماً: فنقطة التحوّل التاريخيّة الوحيدة ذات المغزى هي أزمة اللاجئين السوريّين والتي أثّرت على حياة عبرين اليوميّة بطُرُقٍ جديدة.
وتتّصف الذكريات التاريخيّة على الغالب بالتّنافس ما بين عبرين وقرية رشكيدا المُجاورة، حيث يتواجد حزب الله وهو الحزب الشيعيّ الأساسيّ والحليف المُقرَّب من نظام الأسد. أمّا الآن، فيُشار إلى السوريّين على أنّهم "يجلبون" انعدام الأمن إلى القرية: ففي حين يُنظَر إلى الرّجال على أنّهم مُتحرِّشون جنسيّون مُحتمَلون، هناك مَيْلٌ لاعتبار النساء وبصورةٍ أساسيّة مُربّيات أطفال، وبالتّالي اعتبارهنّ عاملاً من عوامل "التّهديد" الديموغرافي".
وينسب معظم المُقيمين المحليّين اللاجئين السوريّين الحاليّين إجمالاً إلى نظام البعث رغم أنّ معظم اللاجئين هم ضدّ الحكومة السوريّة على المستوى السياسيّ.
يُظهر السَّرْد عن علم الأنساب الإجتماعي للأمن المحلّي بأنّ عبرين أصبحَتْ وجهةً رئيسيّة للعائلات التي هربَتْ من بيروت خلال الحرب الأهليّة إذ اعتُبِرَتْ البلدة على أنّها أكثر أماناً من العاصمة اللبنانيّة. وقد بقي معظم هذه العائلات في القرية بعد انتهاء الحرب. في هذا الصّدد، قال أحد المُقيمين40:
"عدْتُ إلى القرية عام 1976، حين اندلعَتْ الحرب الأهليّة بما أنّ بيروت لم تعُدْ آمنة. صحيحٌ أنّنا احتفظنا بأرضنا في "كليمنصو" (وهو حيّ في بيروت الغربيّة)، لكنّنا لم نشعر يوماً بالرّغبة في العودة في التّسعينات من القرن العشرين. فقد شعرنا أنّنا في بيتنا هنا مجدّداً في عبرين، حيث وُلِدْنا".
ولا شيء تغيّر، فلا يزال المجتمع المحلّي يصف عبرين بأنّها قرية آمنة حتّى في ظلّ تدفُّق اللاجئين السوريّين بأعدادٍ كبيرة، علماً أنّ القيود المَفْروضة على حركة المجتمعات النازحة وتعبيرهم كثيرة جدّاً. غير أنّ الإحتكاكات الإجتماعيّة التي أُبْلِغ عنها في منطقة البترون تُحرِّض عليها المنافسة على الأشغال في القرى حيث يفوق عدد اللاجئين عدد السكّان المحليّين41.
وفي شبعا، فذكرى الإحتلال الإسرائيلي تؤثِّر على الإجابات على الأسئلة حول الأمن في المنطقة، رغم أنّ العديد مِمّن أُجْرِيَتْ معهم المقابلات يميلون إلى التّقليل من أهميّة الإحتلال مُشدِّدين على أنّ صفحة الماضي طُوِيَت وزمنٌ جديدٌ قد بدأ. فقد أقام الجيش الإسرائيلي قاعدته الرئيسيّة على رأس واحدٍ من الجبال المحيطة مُستخدِماً ضوءاً كاشِفاً كبير الحجم لِيُراقب المنطقة ليلاً. يذكر المُقيمون أنّهم لم يخرجوا ليلاً ولم يكُنْ باستطاعتهم أنْ يناموا بسبب الضّوء الذي راح يُمشِّط القرية مراراً وتكراراً.
على العموم، يُدرك مَنْ أجرَيْنا المقابلات معهم ماهيّة النّظرة إلى قريتهم: هي غير آمنة وهي مُعرّضَة لنزاعات عنيفة بسبب موقعها الجغرافي الحسّاس ووضع مزارع شبعا المُتنازَع عليه. تصوّرٌ يُناقضه التّأكيد المُستمِرّ على انتظام القرية واستقرارها داخليّاً؛ بل يأتي الإستقصاء الإجتماعي والسّياسي والإقتصادي وحالة اللاأمن لِيُبْطِلا هذا التّأكيد كَوْن شبعا قرية سنيّة تُحيط بها منطقة يحكمها حزب الله وحركة أمل، ويُطوّقها نظامان سياسيّان مُعاديان: النّظام الإسرائيلي والنّظام السوري. هذه الحالة الرّاهنة غالباً ما يُضرَب مثلٌ عنها عبر سَرْد قصّة مستشفى شبعا، وهو مُجمَّع جديد وضخم بُنِيَ على مشارف القرية بفضل التّمويل الكويتي، لكنّه لم يُفتَتَح بعد حسبما أُعْلِمنا.
"تتمتّع المستشفى بتجهيزات أفضل بكثير من تجهيزات مستشفى الجامعة الأميركيّة. لقد استُكمِل العمل بها. هذا واضحٌ، لكنْ لا يُسمَح لنا بأنْ نفتحها. أيمكنكَ تخيُّل مَنْ قد يكون الطّرف المُعارِض لافتتاحها؟ هناك مستشفى في النبطيّة؛ هم لا يريدون المنافسة. على ضوء هذا الواقع، يجب علينا أنْ نذهب إلى مرجعيون أو إلى النبطيّة لِتلقّي الرّعاية الطبيّة في حالات الطّوارئ. ويموت النّاس على الطّريق لأنّهم لا يستطيعون بُلوغ المستشفى في الوقت المناسب"42.
ويتشارك اللاجئون السوريّون تصوّراً مماثلاً، اللاجئون الذين استقرّوا في شبعا بفعل التّاريخ الطّويل من التّفاعلات مع السكّان المحليّين، وأوجه الشّبه الإجتماعيّة والجغرافيّة مع بيت جنّ على حدٍّ سواء. ويستمرّ هؤلاء بالإشتكاء من العزلة الإقتصاديّة للقرية في ظلّ عدم استعدادهم لِتَرْك القرية للعمل في مناطق أخرى. "شبعا رائعة، وسكّانها رائعون. نحن ننعم بكلّ ما نتمنّى أنْ ننعم به، ما عدا فُرَص العمل لشبابنا ودَعْم المنظّمات. لا نعرف كم نستيطع أنْ نبقى هنا بعد"43.
أما بالنّسبة للعديد من اللبنانيّين الذين أجرَيْنا معهم المقابلات، فإنّ البقاء في القرية يُعْتَبَر موقفاً سياسيّاً. فقد طمأننا أحد الشّباب قائلاً: "لقد درسْتُ في بيروت ورجعْتُ إلى شبعا. وسوف أبقى هنا رغم كلّ الصّعوبات. فالبقاء هنا هو فِعْل مقاومة بالنّسبة لي"44.
إنّ تواجُد اللاجئين السوريّين بأعدادٍ كبيرة في شبعا لم يبدُ أنّه سببٌ للتوتُّر هنا. فقد شدّد معظم مَنْ قابلناهم على التّفاعُل السلميّ بين المجتمعَيْن اللبناني والسّوري في القرية الذي ينسبونه إلى واقع أنّ "جميعهم يعرفون بعضهم البعض". يُشير هذا العامِل على ما يبدو إلى قانون أخلاقيّ وسلوكيّ مُعيّن يعرفه كلا اللبنانيّين واللاجئين السوريّين ويؤيّدونه: "يجب على الغريب أنْ يُطيع ما تُمليه عليه أخلاقه"45.
|
الفواصل غير الواضحة ما بين الأمن البشري والحماية القانونيّة يرجع النّقص في الحماية القانونيّة للاجئين السوريّين في لبنان إلى الأسباب نفسها الكامِنة وراء عدم قُدرة اللاجئين على الوصول إلى أنظمة الأمن بغضّ النّظر عن مكانتهم الإجتماعيّة في المجتمعات المُضيفة. حين قابلنا اللاجئين السوريّين وسألناهم عن تصوّراتهم للأمن في المواقع الثلاثة، ذكر العديد منهم التحدّيات المُتعلِّقة بأوراقهم ووضعهم القانونيّان، إضافةً إلى القوانين البيروقراطيّة غير الواضحة المُتعلِّقة بالتّسجيل (لدى مفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين) والوصول إلى المُساعدات (سِلَل غذائيّة وقسائم من برنامج الأغذية العالمي مثلاً). وقد رصدنا في ظاهرة شائعة جدّاً الإنتقال إلى موقعٍ آخر في لبنان، للبحث عن أجار أرخص وفرصة عمل على الغالب، لكنّ هذه الظاهرة هي في تراجُعٍ حاليّاً بسبب تصوّرات انعدام الأمن – وهو شعور يُفاقمه غياب أوراق الإقامة القانونيّة46. في هذا السّياق، وفي مُقابلة أُجْرِيَتْ في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر عام 2013، في الضاحية الجنوبيّة لبيروت47، قالَتْ علياء، وهي لاجئة عراقيّة من البصرة، إنّها انتقلَتْ من عين الرمانة إلى الشيّاح لأنّها لم تشعر بالأمان ذاكِرةً بأنّها تعرّضَتْ للمُضايقة ثلاث مرّات وللإهانات اللفظيّة بينما كانَتْ تسير في الشّارع. بالنّسبة لها هي الأخرى، فغياب الأوراق القانونيّة كان المصدر الأساسي لانعدام الأمن، ما جعلها عاجزة عن الحصول على أيّ مساعدة رسميّة حين تعرّضَتْ للتّهديد أو المُضايقة أو الهجوم. وحسبما أظهرَتْ النّتائج، يبدو أنّ اللاجئين السوريّين المُسجَّلين لدى مفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في عبرين وعاليه يصلون فعليّاً إلى أنظمة تَوْفير الأمن اللبنانيّة، مثل الشّرطة البلديّة التي تُمثِّل المصدر الوحيد للحماية والأمن المحليَّيْن. وقد أقرّ اللاجئون السوريّون الذين أُجْرِيَتْ المقابلات معهم بأنّهن اتّصلوا بالشّرطة طلباً للحماية، إلّا أنّهم أُحيلوا إلى الشّرطة البلديّة. وهذه الأخيرة هي جِهة فاعِلة رسميّة، تتبع لِقوى الأمن الدّاخلي، بل هي تتّصف بالجهة غير الرسميّة على حدٍّ سواء فيما يتعلّق بتَطْبيق الإجراءات الأمنيّة والتي لا تندرج ضمن صلاحيّاتها. لذلك، لا يُشير اللاجئون في سَرْدهم إلى انعدام الثّقة بالدّولة اللبنانيّة فحسب، بل يُشيرون أيضاً إلى آليّة التّنسيق الضمنيّة بين الجِهات الفاعِلة الرسميّة منها وغير الرسميّة والمعنيّة بتَوْفير الأمن. ولم يشعر اللاجئون الذين تمّت مقابلتهم في عاليه بأنّهم مَحْمِيّون، لكنّهم لحظوا بأنّ عاليه كانت منطقة آمنة في لبنان. وكمِثالٍ إضافيٍّ على ترسُّخ اليأس في ظلّ غياب المساءلة تجاه المؤسّسات الرسميّة حيث يعيش اللاجئون، قالَتْ سيّدة سوريّة48: "يطلبون منّا أنْ نكون مُلتزِمين. فنحن ندفع الضّرائب. كما أنّنا ندفع بدل الإيجار والمياه. لكنّنا لا نتمتّع بأيّ حقوق". من هنا، يتبيّن أنّ اللاجئين السوريّين، وخاصّةً الذّكور منهم، في عاليه كما في عبرين، يستطيعون أنْ يصلوا إلى الأمن من خلال قنوات غير رسميّة عبر الإعتماد على الأغلب على السّلطات المحليّة مثل المخاتير والأعيان المحليّين والمسجد المحلّي الأقرب، وفي النّوادر على الهيئات الأمنيّة الرسميّة. أمّا في شبعا، فلا يملك السّواد الأعظم من اللاجئين السوريّين أوراقاً ثبوتيّة قانونيّة، وهم نادراً ما يُغادرون القرية. وهم يتّكلون في شؤونهم الأمنيّة بشكلٍ رئيسيٍّ على العائلات النّافذة، ناظِرين إلى مُزوِّدي الأمن نظرة شكّ وريبة بكلّ بساطة. |
٣.تَفْكيك الإنقسام ما بين "الدّولة الضّعيفة – والآليّات غير الرسميّة القويّة"
غالباً ما توصَف المظاهر المحليّة للأمن على أنّها إستجابات تقوم بها أجهزة الدّولة أو تتمّ بواسطة الكليشيه الشرقيّ لـِ "القبضاي" الحضريّ أو يتولّاها قائد محلّي يكون هو بدوره في خدمة زعيم، أي قائد قرية أو بلدة. ويكون هذا الزّعيم موظّفاً نموذجيّاً يجمع في شخصه ترسّبات النّظام الطائفي والزبائني49. يُحاول هذا التّقرير أنْ يتجاوز هذا الإنقسام التخطيطيّ ليُحلِّل كيف يُمارَس الأمن وكيف يُعاش في التّجربة. لذلك، أولِيَ اهتمامٌ خاصّ بالمؤسّسات أو الأفراد اللذَيْن يقومان بأداء أشبه بأداء الدّولة ويُمارسان السّلطة العامّة. فهذه المؤسّسات قد تُنافس الدّولة، وهي غالباً ما تعتمد على مظاهر شرعيّة هذه الأخيرة الإجرائيّة والرمزيّة لِتَعْزيز سلطتها الذاتيّة أو ترسيخها. في هذا السّياق، لا يجوز تَعْريف تَهْجين الأمن على أنّه تجزئة لأجهزة الأمنيّة والجِهات الفاعِلة والآليّات، ولا على أنّه "تَقْسيمٌ للعمل" بين الجِهات الفاعِلة الحكوميّة منها وغير الحكوميّة. بل يُسلِّط التّهجين الضّوء على الإجراءات التي تجتمع الجهات الفاعِلة المُختلفة لاتّخاذها، فتتعايش تُفاوض وتتشابك وتتنافس وغالباً ما تُكمِّل بعضها البعض وتتعاون.
ضَبْط الدّولة للأمن وسياسات الأمن الرسميّة
تُركِّز أكثريّة المنشورات عموماً على قوى الأمن كفرصة مَسْنوحة أمام اللبنانيّين كي يحظوا بأسسٍ مُشترَكة بين جميع الطوائف لبناء دولة-وطن. ويُمكن إرجاع أهميّة التّمثيل الطائفي في القوات المُسلَّحَة اللبنانيّة أي الجيش اللبناني إلى عهد الإنتداب (1920-1946). فبين عامَيْ 1958 و1970، تمّ تَسْييس دور الجيش اللبنانيّ على نحوٍ مُتزايدٍ. ومنذ إستقلال البلاد عام 1943، ظلّ الجيش اللبناني خاضعاً للحوكمة السياسيّة من دون أنْ يحاول القيام بأيّ انقلاب. ويُمكن وَصْف نظام الحوكمة اللبناني بأنّه مدنيّ (وإنْ حصلَتْ بعض الإستثناءات)، لا بل مَطبوع بتاريخ طويل من المقاربات التي تُركِّز على الأمن. وبتعبير أدقّ، فولاية الجنرال فؤاد شهاب (1958-1964) قد كرّسَتْ تكريساً عظيماً دور الجيش على أنّه المُهَيْمِن. وبعد الإنسحاب السّوري من لبنان عام 2005، وصل إميل لحود (1990-1998) وميشال سليمان (1998-2008)، وكلاهما قائدا جيش ترعرعا على الشهابيّة، إلى رئاسة الجمهوريّة. إنّ ذكرى الشهابيّة كعقيدة وطنيّة ومُتمحوِرة حول التّنمية يُساعد على شَرْح السّبب وراء اعتبار الجيش اللبناني حتّى يومنا هذا على أنّه مؤسّسة جديرة بالثقة في لبنان. ولكنْ، تبدو الشعبيّة التي صوّرها المُراقِبون50 تتناسب عكسيّاً مع الوسائل الحاليّة للمؤسّسة العسكريّة. ففي حين "عملَتْ" سوريا "على تَرْويض القوّات المسلَّحة اللبنانيّة"51 خلال الإحتلال السّوري، راحَت الأجهزة الأمنيّة تُصَوَّر في نهاية المطاف على أنّها رأس الحربة الجديدة للرّوح الوطنيّة الوطني بعد الحرب الأهليّة وبعد انسحاب الجيش السّوري عام 2005، وفي أعقاب النّزاعات العسكريّة الأخيرة مع مُقاتلي الدّولة الإسلاميّة على الحدود اللبنانيّة-السوريّة.
وتُركِّز الغالبيّة العُظْمى من العُلماء والخُبراء الإجتماعيّين على الفواصل غير الواضحة بين الأجهزة الأمنيّة المختلفة، رغم سمعتها - والتي بُنِيَتْ مدماكاً وراء مدماك - على أنّها ركن من أركان الوطنيّة اللبنانيّة "المُتخيَّلَة"، ضمن الدّولة اللبنانيّة وعلى تزايُد الظّاهرة النّاتجة عن هذه الفواصل المُتماهية ألا وهي عدم النظاميّة والخصخصة. وتأتي القوانين والإجراءات لِتُعزِّز هذا المنحى، ما أعطى للشّرطة العسكريّة قوّة مُساوِية لقوّة القوى الأمنيّة الأخرى. ومنذ السّنوات الأولى للإستقلال، كان مُتوقَّعاً من الجيش اللبناني أنْ يلعب دور الوسيط والحكم في النّزاعات السياسيّة والإجتماعيّة الكبرى التي ألمّت بالبلد52. وبعد انتهاء الحرب الأهليّة، جاء إتّفاق الطّائف (1989-1990) لِيُؤكِّد على دور الوساطة هذا ولِيُعزِّزه حتّى53. في هذا الإطار، لا يُعَدّ دور الجيش القائم على ضَبْط الأمن إستثنائيّاً54: بل هو واحد من المهام الرئيسيّة المُلقاة على عاتق الجيش اللبناني، والذي يتنافس مع أو يتكامل مع القوى الأمنيّة الأخرى55. وتُضيف مُضاعفة الأدوار هذه إلى الإلتباس الذي يُحيط بالمهام الخاصّة بكلٍّ من الجهاز الأمنيّ، في سياقٍ تولى فيه الأولويّة لِمجرّد "حماية النّظام" بحدّ ذاته56.
وقد تكثّفَتْ السّياسات المُتمحوِرَة حول الأمن مؤخّراً في أعقاب النّزاع السوري والذي أدّى إلى تدفُّق اللاجئين إلى لبنان. وفي حين تنطوي الإجراءات الأمنيّة المُعتمَدَة، وفي كثيرٍ من الأحيان، على طبقاتٍ عدّة، فهي استهدفَتْ بشكلٍ رئيسيٍّ وجود اللاجئين السوريّين كجزءٍ من المحاولات لضَبْطه ومُراقبته وإضفاء صفةً رسميّة عليه، مانِعةً التّهديدات الأمنيّة المَزْعومة النّاجمة عن مثل هذه الضّغوط. وقد شاركَتْ جهات فاعِلة مختلفة تابعة للدّولة في تَصْميم هذه الإجراءات وتَطْبيقها. ويُمكن ملاحظة ردود فعل الدّولة هذه بشكلٍ رئيسيٍّ في الوجود الفعليّ على الحواجز، كما في الوجود المُعزَّز للجيش اللبناني ولِقوى الأمن الدّاخلي على حدٍّ سواء، وفي وَضْع إجراءات لسياسات عامّة تتعلّق بإقامة السوريّين وعملهم في لبنان (والمُسمّاة بقوانين تشرين الأوّل/أكتوبر عام 2014). ورغم نيّة الإجراءات الأمنيّة بإضفاء صفة الرسميّة على وجود اللاجئين السوريّين وضَبْطهم، فقد أتَتْ هذه الإجراءات بنتائج عكسيّة على الأغلب ممّا زاد من حدّة اللاشرعيّة، واللارسميّة، واللاأمن57.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أنّ الجيش اللبناني يتدخّل في حالة الجرائم الأكبر والقضايا الأمنيّة، تتمثّل الشّرطة البلديّة، غير المُسلَّحَة في الغالب، بأنّها أضعف مؤسّسة أمنيّة رسميّة عمليّاً، لا بل تُشكِّل في الوقت نفسه جزءاً من المجتمع المحلّي. وكلّما برزت قضيّة أمنيّة إلى السّطح، تُعتبَر قوى الأمن الدّاخلي على أنّها الجهة الفاعِلة الأقوى، رغم أنّ نتائج العمل الميدانيّ في المواقع الثلاثة تُظهر بأنّها لا علاقة لها مُطلقاً بالمجتمع المحلّي، ومشاعره، واهتمامه بأرضه.
بما أنّ الدّرك (أي قوى الأمن الدّاخلي) والشّرطة البلديّة هما خاضِعان لوزارة الداخليّة، على خلاف الجيش اللبناني والذي يتبع لوزارة الدّفاع، يُمكن تسمية هؤلاء المزوِّدين الثلاثة بالـ "رسميّين" واعتبارهم كذلك معياريّاً. في الممارسة، كلّ فرد يتمّ توقيفه على يد الشّرطة البلديّة يُسلَّم في النّهاية إمّا إلى قوى الأمن الدّاخلي أو الجيش اللبناني. أمّا عندما يقوم الجيش اللبناني بتَوْقيف أحدٍ ما، فيبقى الفرد المَعْنيّ إمّا في عهدة الجيش اللبناني أو يُسَلَّم إلى قوى الأمن الدّاخلي. وقد تمّ رَصْد نموذج التّنسيق هذا في المواقع الثلاثة كلّها. ورغم أنّ قوى الأمن الدّاخلي، والتي تُمثِّل أقوى هيئة أمنيّة رسميّة في لبنان، يُشار إليها بالغائبة – "حين أتّصل بهم، هم لا يُجيبون أبداً"58 – وبأنّها تجسيدٌ حيٌّ لانحلال الدّولة اللبنانيّة، فهي تُرى أيضاً على أنّها الجهاز الأمني الوحيد الذي يُمكنه أنْ يكون حازماً كفاية لِيُحدِث تغييراً حقيقيّاً على أرض الواقع.
وجاء على لسان عضو في حزبٍ سياسيٍّ في عاليه59: "عندما تقع المشاكل، فلمؤسّسات الدّولة الأولويّة باتّخاذ التّدبير اللازم (أي الدّرك والجيش اللبناني). ونحن مستعدّون لِتَقْديم يد العون متى لزم الأمر. نحن نحترم دور الدّولة، على عكس حزب الله في الضّاحية الجنوبيّة لِبيروت. وقال عضوٌ آخر من الحزب60 مؤكِّداً:
نحن، الحزب القومي الإشتراكي، نتوقّع من الدّولة ومن الجيش اللبناني أنْ يكونا أعلى سلطة رغم أنّنا نمتلك سريّاً جميع أنواع الأسلحة في بيوتنا. هذا لا يعني أنّنا لا نثق بالدّولة. لكنّنا احتفظنا بأسلحتنا منذ أيّام الحرب الأهليّة. أنا لا أفكّر باستخدام سلاحي أبداً. ولا أعرف كيف أستخدمه حتّى".
وتحدّثَتْ لاجئة سوريّة61، بات لها في عاليه أربع سنوات، عن أبناء وطنها الهارِبين من سوريا على أنّهم ليسوا مجرّد ضحايا.
"إنّ الدّولة اللبنانيّة هي دولة مُنحَلّة وشاقّة بالنّسبة للبنانيّين أنفسهم، وبالنّسبة للسوريّين في مقامٍ ثانٍ ... جميعنا نسمع بالسوريّين أكثر في معرض حديثنا عن اللاجئين: ففي كلّ مكان، النّزوح هو تجريدٌ من القوّة؛ هو القشّة التي قصمت ظهر البعير في أيّ قضيّة إجتماعيّة كانَتْ موجودة أصلاً".
في المقابل، يسود حديثٌ بين اللبنانيّين المُقيمين في عاليه يُشدِّد على أهميّة وجود دولة حازمة وعلى المودّة المحليّة السّائدة تجاه الجيش اللبناني كَوْنه يجسِّد أمن الدّولة: "ندعو جميعنا إلى مزيدٍ من الدّعم للجيش اللبناني: فمن المهمّ أنْ يستمرّوا بحماية الحدود، ويُحافظوا على وحدة البلد"62. أمّا بالنّسبة للمُقيمين المحليّين، فالإجراءات التي يُنفِّذها مُزوِّدو الأمن الرسميّون (الجيش اللبناني، وقوى الأمن الدّاخلي، والشّرطة البلديّة) هي ضروريّة للحؤول دون انزلاق المنطقة إلى هاوية العنف. والأهمّ بعد هي إشارة مُقيم63 إلى كيف أنّ التحسُّب للعنف لا يقتصر على إجراءٍ ملموسٍ، بل يُراد منه جَعْل المواطن العادي يشعر بالأمان. "إنّ الشّرطة وقوى الأمن الدّاخلي والجيش اللبناني لا يُظهِرون أسلحتهم. فالواحد منّا لا يشعر بأنّه في بيئة عسكريّة (مش منظر عسكري)، في حين هو مَحْمِيّ".
وتتمثّل سلطة الدّولة المركزيّة أيضاً بدَوْر الوسيط الذي يلعبه المختار المحلّي، والذي غالباً ما يوصَف بأنّه "عين الدّولة"64. في هذا الإطار، يصف مَنْ قابلناهم في عاليه دَعْمهم للحكومة المركزيّة ورغبتهم في رؤيتها تنمو لِتصبح أقوى، وهم بذلك، يُعرِبون عن دَعْمهم للدّولة الأكبر.
في عبرين، كما في شبعا، تلعب قوى الأمن الدّاخلي والجيش اللبناني دوراً متواضعاً على الأرض. وبالتّالي، فتكفي العضويّة في المجتمع المحلّي كمعيارٍ أساسيٍّ للمواطنين المحليّين كي يُشاركوا في جهاز الأمن غير الرّسمي.
ولكنْ، وفي حين أنّ الأمن غير الرّسمي هو الغالب ظاهريّاً في عبرين، يؤكِّد بعض المُمثِّلين عن الأحزاب السياسيّة65 أنّ حظر التجوُّل في عبرين قد نُفِّذ طبقاً لقرارٍ من الجيش اللبناني، والذي يؤدّي عمله من خلال البلديّات المحليّة في المناطق المجاورة لِطرابلس. وكان هدف الجيش هو ضمان أمن المجتمعات المحليّة المُضيفة، مباشرةً عقب اتّخاذ قراره بإنهاء أحداث العنف القائم بين السنّة اللبنانيّين في باب التبّانة، والذين يحقدون حقداً كبيراً على نظام الأسد والذي دمّر منطقتهم عام 198566، والسكّان العلويّين في جبل محسن، والذين يؤيِّدون النّظام. وقال أحد المُمثِّلين عن حزبٍ سياسيٍّ:
"في كلّ بلديّة، تُؤثِّر مخابرات الجيش اللبناني على القرارات البلديّة، فلا يخطر ببالك أنّ الخطوط ما بين القرارات المؤسّساتيّة والقرارات غير المؤسّساتيّة واضحة المعالم للغاية".
ففي نظره، إنّ الأمن المحلّي والذي أعاد الجيش اللبناني إرساءه يجب أنْ يُنْظَر إليه على أنّه نتيجة لإنْهاء الإشتباكات التي طال أمدها في طرابلس67، وليس كعنصريّة مُتجذِّرة تجاه اللاجئين، كما يُعتقَد على نطاقٍ واسعٍ في لبنان. وهذا الواقع يطمس وبشكلٍ كبيرٍ التّمييز ما بين تَوْفير الأمن الرّسمي وغير الرّسمي ويُضعِف دلالته. علاوةً على ذلك، فالإجراءات الأمنيّة على أرض الواقع تُعتمَد أكثر من الآليّات الرسميّة وغير الرسميّة لِدَعْم الأمن68.
وفي شبعا، يُشدِّد مَنْ قابلناهم محليّاً على قلّة النّفوذ التي يتمتّع بها مُزوِّدو الأمن الرسميّون في القرية، وخاصّةً الشّرطة البلديّة، والتي وُصِفَتْ بأنّها ضعيفة وقليلة العدد. ويروي لنا أهل القرية بفخر بأنّ قريتهم مُحصَّنَة من تدخُّل الجيش اللبناني وقوى الأمن الدّاخلي. مع ذلك، وفي ظلّ تدفُّق اللاجئين السوريّين بأعداد كبيرة، إتّخذَتْ بلديّة شبعا سلسلة من الإجراءات الرسميّة بالتّعاون مع فرع مخابرات الجيش اللبناني لإقامة "يوماً أمنيّاً" مُنتظِماً (كلّ شهر أو كلّ شهرَيْن) يقوم فيه الجيش اللبناني بمداهماتٍ للبيوت التي يقطنها السوريّون. وإنْ تمّ العثور على أسلحة، يُعْتَبَر المالك اللبنانيّ هو المسؤول قانوناً، ما يُشجِّع المُقيمين اللبنانيّين على "توخّي الحذر ومراقبة السوريّين" بحيث "تُضْمَن مصلحة جميع المُقيمين في القرية"69. وفي الوقت الذي ينتقص فيه مَنْ قابلناهم من اللبنانيّين المحليّين من دور الجيش اللبناني ومخابراته، رفع اللاجئون السوريّون المُقيمون في شبعا من شأن هذه المُداهمات، علماً أنّ مسؤولي الجيش اللبناني طمأنوا المواطنين بأنّ المُداهمات لا تستهدف إلّا الشّبان الذين يُشتبَه بانتمائهم للدّولة الإسلاميّة أو جبهة النصرة. وهم غالباً ما عبّروا عن هذا الإستهداف الجندري للشبّان على أنّهم مُشتبَه بانتمائهم للحركات الإسلاميّة قائلين إنّه يؤثِّر على حياتهم اليوميّة، وعلى حريّتهم في التحرُّك، وعلى فرص العمل. في المقابل، تُستبعَد اللاجئات السوريّات عن هذا الإشتباه السّابق افتراضه.
من هنا، وكما تبيّن في المواقع الثلاثة، فإنّ مُضاعفة الجِهات الفاعِلة وقوى الأمن بالإضافة إلى أدوارهما غير الواضحة المعالم، كلّ ذلك أدّى إلى إعادة عسْكرة المجتمع بصورةٍ عشوائيّةٍ. ويظهر هذا جليّاً في مجموعةٍ واسعة من الجِهات الفاعِلة التي عادَتْ وانبثقَتْ (الزّعماء المحليّون70، أو الأعيان، أو رجال الميليشيات السّابقة، أو قادة الأحزاب السياسيّة)، والجِهات الفاعِلة الجديدة (مثل شركات الأمن الخاصّة71)، وممارسات التّرهيب الفرديّة والجماعيّة المُتعدِّدة االوجه.
التّرهيب الهجين: تمثيلات وممارسات رمزيّة
منذ اندلاع النّزاع في سوريا، إستخدمَتْ الأحزاب السياسيّة اللبنانيّة وأصحاب المشاريع السياسيّة كلا النّزاع وتدفُّق اللاجئين المُترتِّب عليه كأداتَيْن على جداول أعمالهم72. وتتأرجح هاتان الأداتان ما بين الخوف من "تسرُّب" النّزاع واعتبار اللاجئين السوريّين ككبش محرقة73 في الخطابات السياسيّة، فضلاً عن وسائل الإعلام، ما خلق بالتّالي حالة من الذّعر العامّ في سياقٍ أرهقَتْهُ التوتُّرات السياسيّة والإجهاد الإقتصادي الهيكلي. على هذه الخلفيّة، عمّم مُزوِّدو الأمن غير الرسميّين، وعلى نحوٍ مُتصاعدٍ، إجراءات كي يتعاملوا مع التحسُّب للعنف والذي بات روتيناً74. وفي حين سلّطَتْ دراسات أخرى الضّوء على آليّات عشوائيّة لِضَبْط الأمن اعتمدها بعض اللاجئين السوريّين من تَلْقاء أنفسهم (على سبيل المثال، عبر استخدام اللهجة اللبنانيّة في تفاعلاتهم اليوميّة أو عبر تجنُّب الخروج من المنزل بعد مغيب الشّمس)75، تُظهِر القصص النّاتِجة عن العمل الميداني أيضاً غيرها من آليّات التّرهيب الضمنيّة منها أو الأكثر جليّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ قصص العمل الميداني تحكي عن فصول مُتنوِّعة من العنف الرّمزي ضدّ الوافدين الجُدُد والتي تتراوح ما بين الإحتكاكات بين الأطفال والمُراهِقين وقصص العنف التعسّفي وشعور مُتصوَّر بالإقصاء الممنهج من الحقوق الأساسيّة76، ماضِيةً بذلك إلى ما وراء القضايا الأمنيّة البحتة.
تعميمات حَظْر التجوُّل كمَثَل تجريبيّ على التّداخُل ما بين الإجراءات الرسميّة والإجراءات غير الرسميّة
نادراً ما يذكر اللاجئون تعميمات حَظْر التجوّل على أنّها الأداة الوحيدة والرئيسيّة خلف عدم الإرتياح والتّهويل الإجتماعيَّيْن. وبالتّالي، تُشكِّل تعميمات حَظْر التجوّل حالةً رمزاً لِلمناخ الأوسع من الخوف والتّمييز الإجتماعي وعدم الثّقة المُتبادَلَة في المواقع الثلاثة. وبالفعل، قال أحد العامِلين في منظّمة غير حكوميّة في قضاء البترون77:
"إنّ حَظْر التجوّل هو وسيلة للضّغط على النّاس: فلا يُمكن لِشرطة البلديّة أنْ توقِف النّاس لفترات طويلة، وعادةً ما تدوم التّوقيفات لبضعة أيّام أو ساعات. والإنتهاك لا يؤثِّر بالنّاس بهذا القدر إذا ما قورِن بالعنف الذي اعتاد عليه اللاجئون بعدما هربوا من سوريا. أنا لا أقول إنّه ليس إجراءً عدائيّاً، ولكنْ أنا أراه على أنّه أقلّ أهميّة مِمّا يُصوِّره الإعلام".
وتؤكِّد النّتائج على الطّبيعة الهجينة لِتَنْفيذ تعميمات حَظْر التجوّل. فهي تُطبَّق على يد مُزوِّدي أمن مختلفين رسميّين (هؤلاء يرتبطون بالدّولة وهم مسؤولون قانونيّاً عن الإجراءات الأمنيّة) وغير رسميّين (هؤلاء الذين يُطبِّقون هكذا إجراءات على الأرض بصورةٍ غير شرعيّة)، يتحرّكون على أُسُس قانونيّة غير واضحة المعالم في المواقع الثلاثة. قالَتْ سيّدة سوريّة تقطن في عاليه78: "لا يُطبَّق حَظْر التجوُّل. فالمسألة مسألة سياسيّة أكثر من أيّ شيءٍ آخر". وعندما سألناها إنْ كانَتْ تتذكّر حالة مُحدَّدة، قالَتْ إنّ الشّرطة البلديّة أوقفَتْ مرّة رجالاً سوريّين خلال حَظْر التجوُّل بدون أيّ استخدامٍ للعنف وإنّهم لم يُعتقَلوا إلّا لساعتَيْن.
أضِفْ إلى ذلك أنّ السوريّين الذين ينشدون المساعدة عادةً ما يميلون إلى اللجوء إلى معارفهم – أي الواسطة – بدل أنْ يلجأوا إلى مُزوِّدي الأمن الرسمّيين أو المُحامين. فقد حكى لنا بعض مَنْ قابلناهم من السوريّين79 أنّ الشّرطة البلديّة تتحقّق من أوراق أيّ سوريّ يخالف حَظْر التجوُّل. لكنْ وفي اليوم التّالي، ينبغي على السّوري أنْ يقصد مركز الشّرطة البلديّة لِيوقِّع على ورقة يتعهّد فيه بألّا يتجوّل تقريباً بعد السّاعة السّابعة مساءً. وفي حين أكّد البعض بأنّهم لم يخفوا من الأمن البلدي ولم يمتثلوا لِحَظْر التجوُّل، شعر آخرون بأنّهم تعرّضوا للتّمييز وسوء المعاملة، لذاك هم فضّلوا أنْ يبقوا مُنزوين داخل منازلهم ليتجنّبوا المخاطر. وذكر آخرون أنّ قيادة الدرّاجات الناريّة أو حَمْل الأكياس الكبيرة كانا العنصرَيْن الوحيدَيْن اللذَيْن كان من شأنهما أنْ يُثيرا ريبة الشّرطة البلديّة ويدفعاها إلى إيقاف السوريّين.
في هذا الإطار، يُعَدّ الأمن إجراءً عمليّاً يُتَّخَذ لإبقاء وثائق اللاجئين تحت المراقبة. فحدّد مُقيمٌ لبنانيٌّ80، على سبيل المثال، أنّه لن يُواجه المشاكل مع "تجوُّل السوريّين ليلاً متى كانوا جميعهم مُسجَّلين في البلديّة ... وإذ [وعندئذٍ تعرف الحكومة] مَنْ هم وإنْ هم على صلة مع الجماعات المُسَلَّحَة في سوريا".
وقال سوريٌّ آخر إنّ حَظْر التجوُّل طُبِّق فقط في الشّهرَيْن الأوّلَيْن بعدما أُعْلِنَ الحَظْر عبر لافتات عُلِّقَتْ في الأماكن العامّة.
في عبرين، قال مُقيمٌ محليٌّ أجَرْينا مقابلة معه إنّ اللبنانيّين يعتمدون إجراءات قَمْعيّة تجاه الأزمة السوريّة بسبب الإحتلال السّوري للبنان والذي امتدّ من عام 1976 إلى العام 2005، وبسبب حالة انعدام الثقة العامّة تجاه الأجانب والذين يأتون من خلفيّات ثقافيّة ودينيّة مختلفة. وقيْل لنا إنّ الإسلاموفوبيا أي الرُّهاب من الإسلام يرتبط بالفكرة الشّائعة بأنّ اللاجئين يستوردون العادات الإسلاميّة إلى جانب المشاكل الإجتماعيّة. ومن وجهة مُقيم محلّي آخر، فإنّ البطالة والتّهميش لم يكُنا العاملَيْن اللذَيْن أطلقا العنان لِحالة "الخوف من السوريّين".
وأشار مُقيمٌ محليٌّ آخر إلى أنّ القرية لم تشهد يوماً أحداث عنف، لا بل شدّد أنّ هذه الإجراءات ما زالَتْ مطلوبة كونها "ضروريّة" و"وقائيّة". بالنسّبة له، فأكثر الأخطار التي كانَتْ القرية لتتعرّض لها كانت السّرقة والتحرُّش. وبالنّتيجة، اعتُمِد التحسُّب للعنف على أنّه ضمانة للأمن المحلّي.
على المقلب الآخر، دافع شيخٌ في قضاء البترون عن الإجراءات التي إتّخذها البلديّات المحليّة بقَوْله إنّها جاءَتْ طبيعيّاً نتيجة المشاكل التي طرحها اللاجئون السوريّون والسكّان المحليّون. وبالتّالي، فمَنْع الدرّاجات الناريّة بالنّسبة للسوريّين جاء كـَ "عاقبة للسّرقات وعمليّات النّشل والتحرُّش الجنسي في الشّارع. فهذه الجرائم الصّغيرة تُرتكَب بشكلٍ عامٍّ على الدرّاجات الناريّة كَوْن هذه الأخيرة تسمح لِمُرتكبيها بالفرار بسهولة لِسرعتها"81. وبدا أنّ السوريّين الذين وظّفهم المسجد لِتَوْفير المساعدات يوافقون مع هذه السّياسة وعقيدة الأمن هذه والتي تتّفق مع منطق التحسُّب للعنف.
وأشار قائمقام قضاء البترون، وهو المسؤول إداريّاً عن عبرين، إلى تعميمات حَظْر التجوُّل على أنّها "قرار أمني وحماية). فقد أكّد على أنّ هذه الإجراءات قُصِد منها استهداف كلا المجموعتَيْن السوريّة واللبنانيّة "لِضمان أمن الإثنَيْن معاً"، فيما شدّد على أنّ القرية لا تواجه مخاوف أمنيّة. إضافةً إلى ذلك، أفاد القائمقام أنّ الكثافة السكّانيّة الصّغيرة نسبيّاً والتي تتميّز بها هذه القرية82 هي عامِلٌ رئيسيٌّ لِتجنُّب الإحتكاك والتوتُّر الإجتماعيّ.
عمليّاً، إنّ حظر التجوُّل هو بمثابة إعلان مكتوب يُعَلَّق على جدران الشّوارع لِمَنْع السوريّين من مغادرة منازلهم بعد السّاعة الثّامنة ليلاً في فصل الصّيف والسّابعة مساءً في فصل الشّتاء. أوّل حَظْر تجوُّل فُرِض في عبرين كان في العام 2014. غير أنّ إجراءات مماثلة ليسَتْ مَلْحوظة عمليّاً: فكلا اللاجئين والسكّان المحليّين يُؤكِّدون بأنّهم لا يُدرِكون تماماً ما إذا كانَتْ تعميمات حَظْر التجوُّل ما زالَتْ قائمة، وإنْ كانَتْ كذلك، هم لا يُدركون في أيّ ساعة من اليوم كانَتْ تُطَبَّق وما إذا كانَتْ إجراءات مماثلة مؤسّساتيّة أو غير شرعيّة، وإنْ كانَتْ تُطبَّق من قِبَل الجيش اللبناني أو قوى الأمن الدّاخلي أو الأحزاب السياسيّة أو الشّرطة البلديّة. وفي الوقت الذي أكّد فيع الشّيخ في مسجد في البترون أنّ الإجراء قُصِد منه فقط مَنْع إستخدام الدرّاجات الناريّة، أفاد آخرون أنّ المَنْع طال اللاجئين أيضاً عبر مَنْعهم من مغادرة منازلهم بكلّ بساطة.
وأيضاً، إعتقد بعض مَنْ قابلناهم أنّ حَظْر التجوُّل تطبّق على السّوريين واللبنانيّين معاً، في حين اعتبر الآخرون أنّ الرّجال السوريّين كانوا الهدف الأوحد. وشدّد المُقيمون المحليّون الأكثر جرأةً على الكلام قائلين: "إنْ خالف السوريّون حَظْر التجوُّل، يتعرّضون للضّرب وتتحقّق الشّرطة من أوراقهم"، رغم قلّة الحالات التي تمّ التَّبْليغ عنها. في هذه الحالات، عُرِّفَتْ تعميمات حَظْر التجوُّل على أنّها "ذريعة للقَمْع"83.
وعبّر عضوٌ تابِعٌ لِحزبٍ سياسيٍّ محليٍّ84 عن رأيه قائلاً: "تُطبِّق الدّولة اللبنانيّة حَظْر التجوُّل أيضاً حين تُقام الإحتجاجات أو الإشتباكات. أمّا وفي ظلّ أزمة اللاجئين، فهذا الإجراء عاديّ ويُقصَد به حصراً حِفْظ الأمن العامّ". فبحسب رأيه، لا تأتي الإضطرابات المحليّة من تعميمات حَظْر التجوُّل والإجراءات الأمنيّة بحدّ ذاتها، بل تأتي من عدم دَعْم قطاع الزّراعة في عبرين، خاصّةً وأنّ معظم المُقيمين يعملون خارج القرية، ولا يُركِّزون بعد الآن على تَعْزيز الموارد المحليّة. وأضاف: "إنْ استطعنا أنْ نصبح مُكْتَفين ذاتيّاً، لأصبح الأمن في قريتنا عندئذٍ أكثر استدامةً.
وعلى حسب تأكيد منظّمة غير حكوميّة محليّة85، فالجِهات الفاعِلة غير التّابعة للدّولة لا يمكنها أنْ تتدخّل بسهولة بقيود أمنيّة مماثلة، إذ تتطلّب برامجها عادةً موافقة البلديّات، وهي تلك المؤسّسات نفسها التي تُطبِّق حَظْر التجوُّل بصورة غير شرعيّة. وفي غياب بلديّة فاعِلة في عبرين، لا تتمتّع إجراءات وقاية الأمن إلّا بنفوذٍ قليل. من ناحية أخرى، فالعلاقة ما بين المنظّمات غير الحكوميّة والمجتمع المحلّي تُصبح غير مباشرة على وتيرةٍ مُتصاعدة بسبب دور الوسيط لِما يُسمّى بالشاويش، وهو ممثِّل عن اللاجئين السوريّين (ويتواجد أيضاً ضمن مجتمعات اللاجئين الفلسطينيّين) ويلعب دور الوسط بين المنظّمات غير الحكوميّة واللاجئين والأجهزة الأمنيّة لدى بُروز أيّ قضيّة أمنيّة. لكنْ، وفي المواقع الميدانيّة الثلاثة، لا يلعب الشاويش أيّ دور ذات صلة في حَلّ القضايا الأمنيّة من وجهة نظر اللاجئين السوريّين الذين قابلناهم. فلا تلعب المنظّمات غير الحكوميّة أيّ دور مهمّ في تَوْفير الأمن المحلّي، ولا تتعاطى أغلبيّة الوقت بالقضايا الأمنيّة قصداً. على الرّغم ذلك، يُبلِّغ اللاجئون الذين يعيشون في قضاء البترون عن تعميمات حَظْر التجوُّل أو الجرائم التي يُتَّهَمون بها للأمم المتّحدة. فجاء على لسان ممثِّل لِمفوضيّة الأمم المتّحدة لِشؤون اللاجئين86: "يحدث هذا أيضاً في المناطق السنيّة التي تستضيف لاجئين. وخِلافاً للإعتقاد العامّ، فإنّ الإحتكاكات الإجتماعيّة لا ترتبط بالضّرورة بالمُعتقدات الدينيّة المُشترَكَة أو المختلفة.
وما يُثير الإهتمام هو أنّ لا اللبنانيّين ولا السوريّين أشاروا إلى قلّة الأمان المحلّي على أنّه السّبب وراء تعميمات حَظْر التجوُّل. فقد أشار مُقيمٌ محليّ إلى حادثة سرقة واحدة تلَتْ وصول اللاجئين السوريّين إلى عبرين، وقد ارتكبها جانٍ لبنانيّ حسبما اكتشفت الشّرطة البلديّة في النّهاية87. وقد أضاف88: "قبل حَظْر التجوُّل، لم يتمّ التّبليغ عن أيّ خلافات أو مشاكل إجتماعيّة. ولم تُطلَق التوتُّرات جزئيّاً إلّا بعد اتّخاذ إجراءات الوقاية هذه". وفي الإطار نفسه، شدّد عضوٌ في حزبٍ سياسيٍّ محليٍّ89 على أنّ اللاجئين لم يتسبّبوا بأيّ مشاكل أمنيّة ذات صلة.
بالنّتيجة، فإنّ فَرْض الأمن من خلال فَرْض حَظْر التجوُّل هو وسيلة يؤكِّد بواسطتها المُقيمون المحليّون ملكيّتهم للأرض ومكانتهم الإجتماعيّة، إذ يمدّهما الإثنان بشعورٍ مُعزَّزٍ بالتّمكين. لذلك، تتّخذ تعميمات حَظْر التجوُّل قيمةً أكثر رمزيّة: فهي تُطبَّق وإنْ كان اللاجئون لا يُغادرون بيوتهم في العشيّة عادةً، وإنْ كان التّبليغ عن جرائم صغيرة غير موجود. وكدليلٍ على ذلك، قال لاجئٌ سوريٌّ90 من جسر الشّغور:
"لَسْتُ أكيداً بشأن حَظْر التجوُّل ... إنْ كان مؤسّساتيّاً أم لا، وإنْ كان ساري المفعول بعد. فأنا وعائلتي لا نخرج من البيت بأيّ حال. لقد قيْل لي: "إنْ احتجْتَ إلى أيّ شيء بعد السّاعة السّابعة مساءً، إتّصِل بالبلديّة. لا يُمكنك الخروج من البيت". ولا بأس بذلك. نحن لا نريد أنْ نتّخذ أيّ مجازفات، لذا فالخيار الأفضل هو البقاء في المنزل".
باختصار، إنّ تعميمات حَظْر التجوُّل هي عمليّاً إجراء أمنيّ ضمنيّ مَقْبول بين الجميع ومُعترَف به معنويّاً في المجال العامّ للقرية.
وفي شبعا، أعلنَتْ البلديّة حَظْر تجوُّل عام 2014 إلى جانب "إجراءات أمنيّة" أخرى تستهدف وجود اللاجئين، بما في ذلك شَرْط تَسْجيل اللاجئين السوريّين لأسمائهم في البلديّة إضافةً إلى "اليوم الأمني" الذي سبق وتحدّثنا عنه. وتعزو البلديّة هذه الإجراءات إلى ضرورة "إبقاء السوريّين تحت المراقبة الدّائمة"91، للحؤول دون إثارة ردود أفعالهم على الأقلّ، مهما كان نوعها، تجاه الأحداث الأمنيّة، كما هو الحال في الموقعَيْن الآخرَيْن. بدلاً من ذلك، يُشير مُزوِّدو الأمن الرسميّون إلى الخوف المَزْعوم من السوريّين المُنْتَمين لداعش أو لجبهة النُّصرة وإلى الإضطراب المُترقَّب الذي قد يخلقه هؤلاء في القرية. واللافت للنّظر هو واقع أنّه وفيما أكّد اللبنانيّون والسوريّون الذين قابلناهم على "اليوم الأمني" (والذي تقوم به مخابرات الجيش اللبناني) والمراقبة المُستمرّة (والتي يقوم بها أهل القرية)، هم لم يلحظوا على ما يبدو حَظْر التجوُّل المَفْروض، وحين سُئِلوا عنه، أعربوا عن لامبالاة تجاهه وجهلٍ به.
إعادة خَلْق للهويّة المجتمعيّة
في حين تمّ تَعْريف فَرْض تعميمات حَظْر التجوّل في عدّة بلديّات لبنانيّة على أنّه في المقام الأوّل مسألة مُتنازَع عليها سياسيّاً وقانونيّاً، فهي ما زالَتْ تولِّد دلالات مجتمعيّة وطرق جديدة لإدارة الحياة الإجتماعيّة. فقبل الأزمة السياسيّة السوريّة وتدفُّق اللاجئين إلى لبنان، عاش بضعة آلاف السوريّين الذين هاجروا بغية العمل وعملوا في المواقع نفسها حيث هم الآن. ولم يُفْرَض عليهم حظر تجوُّل آنذاك، لا بل جاء تَنْفيذ حَظْر التجوُّل عقب إعترافٍ دوليٍّ بحالة الطّوارئ في الجارة سوريا، ما دفع المجتمعات المحليّة في لبنان إلى الإستجابة للأزمة المُجاورة واعتماد إجراءات أمنيّة مماثلة. لذلك، فتعميمات حظر التجوُّل هي جزء من ظاهرة التحسُّب للعنف على مستوى عمليّ وإستطراديّ، ما يسمح بالتّعامُل مع نتيجة مُتوقَّعَة للأزمات السياسيّة92 والقَمْع كطوارئ مُفاجئة وجب إعطاؤها الأولويّة على احتياجات طويلة الأمد كانَتْ موجودة سابقاً.
المرجعيّات التقليديّة كآليّات رقابة وتماسُك
يبدو أنّ السّلوك الذي توجِّهه القِيَم الأخلاقيّة والتّقاليد يلعب دوراً محوريّاً في المُساومة على الأمن والحماية، كما على عمليّات إعادة خَلْق الوضع الرّاهن. وبالتّالي، فديناميّات حِفْظ قواعد السّلوك تُسهم في خَلْق شعورٍ بالتّماسُك بين المجموعات الإجتماعيّة. كما يبدو أنّ المرجعيّات المعياريّة تُغذّي ديناميّات الحذر المُتبادَل. فالعديد من الذين أجرَيْنا المقابلات معهم (لبنانيّون وسوريّون) أخبرونا بأنّهم شعروا بالأمان لأنّهم كانوا على إلفة مع القرية وأهلها، وهم عرفوا كيف يتصرّفون. فقال لنا سوريٌّ مِمّن شملتْهُم المقابلات في شبعا: "نحن نعرف جميع مَنْ في القرية، والنّاس هم طيِّبون معنا. إنْ كنتَ تعرف كيف تتصرّف، لن تواجه أيّ مشاكل"93.
هذه المرجعيّات المعياريّة تُنقَل إلى الوافِدين الجُدُد من خلال المعرفة المُتناقَلَة لفظيّاً. ويبدو أنّ اختيار الموقع أيضاً يقوم على أساس أوجه شبه إجتماعيّة وجغرافيّة مُتَصَوَّرَة مع مكان المنشأ. فما إنْ يستقرّ اللاجئون السوريّون، حسبما ما أُعلِمنا خلال المقابلات، في المواقع الثلاثة، هم لا يلجأون بعد ذلك إلى إجراءات الحماية أو الأمن الرسميَّيْن، وخاصّةً بسبب افتقادهم للوضع القانوني مثلما ذكرنا آنفاً. بدلاً من ذلك، هم يميلون إلى الإلتجاء إلى الجِهات الأمنيّة الفاعِلة غير الرسميّة لِطلب الحماية، ويخضعون بفعل ذلك إلى الطّريقة المُرمَّزَة المُتّبَعة في المجتمع المحلّي حيث يعيشون. وفي حالاتٍ عديدة، يعتمد اللاجئون السوريّون على مُهاجرين سوريّين سكنوا في البلاد لمدّة أطول منهم أو على مَنْ يتمتّعون بعلاقة جيّدة مع السكّان المحليّين لكي يتوسّطوا لهم ويختاروا لهم النّظام الأمني الأنسب لهم. وطلب الأمن، مثلما أخبرنا العديد من السوريّين الذين قابلناهم، كان وإلى حدٍّ كبيرٍ نتيجة اتّباع قانونٍ سلوكيٍّ معيّنٍ لعدم لفت الإنتباه ومواجهة معضلة البحث عن مُزوِّد أمن.
ففي عاليه، قال معظم مَنْ قابلناهم من السوريّين إنّهم شعروا بأنّهم مَحْمِيّون في المدينة لأنّهم تشاركوا المعتقدات المذهبيّة نفسها مع المجتمع الدرزيّ المحلّي القاطِن في المنطقة. ولكنْ، يبدو أنّ الموقف السياسي من الأزمة السوريّة يهيمن على المجتمع المحلّي مُسبِّباً عدم إرتياح إجتماعي94. فقد حدّثنا مواطنٌ سوريٌّ قائلاً: "إنّ السويداء الواقعة في جنوب سوريا هي منطقة موالية للنّظام السّوري، فالنّاس هنا لا يُعاملوننا بشكل جيّدٍ جدّاً"، وكان يُشير بقَوْله إلى عقيدة الحزب التقدُّمي الإشتراكي الشّائعة في عاليه والمُعادية لنظام الأسد.
تُذكَر تعميمات حَظْر التجوُّل وإرسال الدوريّات إلى الشّوارع على أنّها واحدة من الطُّرُق التي تجعل المرء يُحافظ على هويّته الخاصّة، ويُطالب بالأرض على أنّه له، ويُدقِّق بالنّاس الذين يُحتمَل أنّ المعلومات حولهم لا تُسَجَّل على أساسٍ منتظمٍ. لذلك، يُعَرَّف الأمن أيضاً على أنّه طريقة لحِفْظ هويّة مجتمعيّة معيّنة. فتَوْفير الأمن القائم على المجتمع هو مَدْعوم بفكرة أنّه بالإمكان بناء "رصيد إجتماعي رابِط"95.
وبما أنّ الذّاكرة هي مجرّد شكل من الأشكال التي يتواصل من خلالها المُقيمون مع بعضهم البعض، فإنّ أشكال العنف المُتوقَّعَة والتي يتمّ تصوّرها على الأغلب كتهديدات تتأتّى من الذّكور هي طريقة تعبير عن رجاءٍ بعالم أفضل بدل التذكُّر بأنّ الحرب والعنف ممكن أنْ يثورا مجدّداً، ويجب التصدّي لهما. بهذا المعنى، يرتبط الأمن بثقافة المجتمع المحلّي إذ يُمكِّن من حفظ نمط ثقافي معيّن يُنشَر في المجال العامّ. "إنْ كانَتْ الثقافة تتمحور حول الماضي، وهي محدودة وثابتة، فالأمن إذاً هو ذات توجُّه مستقبليّ، وُجِد ليتصدّى للإضطرابات التي قد تطال الحالة الثقافيّة المُستقِرّة"96 أو "وُجِد كوسيلة للفَهْم والتدخُّل في مستقبلٍ مُحتمَل أنْ يكون كارثيّاً"97.
تعدُّد الجهات الفاعلة
يُستَبَق الإخلالُ بالنظام الاجتماعي الحالي في المناطق الثلاث، ويجري التعامل معه عبر آليات الرصد والمراقبة اليومية العادية، وعبر التدابير الأمنية الاستثنائية، التي وُضِعَت بشكل غير شرعي وتُطبَّق بانتظام. على ضوء هذه الاعتبارات، تسود ثقافة الوقاية في هذه المناطق اللبنانية الثلاث، التي تشكّل محطّ تحليلٍ وبحثٍ في الدراسة الحالية.
صحيح أن هذه العمليات الوقائية تؤدّي في معظم الوقت إلى تعايش غير احتكاكي إجمالاً، إلا أنها تتيح لعدد كبير من الجهات الفاعلة التدخّل على الفور في حال "انتهاك المعايير".
وإذ تعزّز الجهات الأمنية الرسمية الفاعلة السرديةَ القائلة بضمان الحماية التامة وصون التواجد على الأرض، لا يبدو أنها تصطدم بالتدابير الأمنية للأحزاب المحلية الرئيسة التي لها القدرة على المحافظة على الحماية الفعلية في المناطق الثلاث (من خلال عناصر الشرطة البَلَدية، أو المواطنين العاديين، أو شخصيات محلية نافذة أخرى).
يُظهِر العمل الميداني أن الأحزاب المحلية هي إلى حدّ بعيد أحد مزوّدي الأمن الأساسيين في المناطق الثلاث التي درسناها، ولا سيما في عاليه وعبرين. بيد أن الناس العاديين الذين يمكن أن يكونوا إما أعضاء في أحزاب سياسية، وإما مستقلين سياسياً، يتولّون مهام المراقبة الأمنية باعتبارها "وظيفة بدوام جزئي"، مع أنهم نادراً ما يتواجدون في البلدة أيام الأسبوع. وكما قال أحد الممثّلين عن حزب سياسي،98 يُعَدّ إجراء الدوريات في الشارع ليلاً بحدّ ذاته عملاً غير رسمي: "أحياناً يتّصل بنا الشرطي من بلديتنا ليسأل: لمَ لا تأتي للاهتمام بهذا المبنى معي الليلة؟ هكذا تجري الأمور عملياً..."
في المقابل، يبدو أن الروابط والحوافز العائلية تتفوّق على السياسات الحزبية في المناطق الثلاث. بعبارة أخرى، تسود المحسوبية وصلات القربى على أي مواقف سياسية وسياسات حزبية. يلجأ الناس عملياً إلى شرطة البَلَدية وموظّفيها، بما أنهم يمثّلون أخلاقياتهم المجتمعية الخاصة وهمومهم السياسية، وذلك بشكل منفصل عن السياسات الحزبية. وبالتالي تُناقَش السياسات المحلية على أنها لا تولّد الانقسامات كما في أماكن أخرى، ذلك أن صلات القربى والحاجة إلى التضامن والتجانس لمجابهة التهديدات الخارجية، هما السائدان في هذه الحال. وهنا أكّد عضو في إحدى البلديات قائلاً: "لا سياسة في البلدية؛ فالمجلس البلدي لا يقوم على الأحزاب السياسية... نحن نقرّر في ما بيننا مَن سيكون عضواً فيه".99
لا يتدخّل الحزب التقدّمي الاشتراكي في عاليه رسمياً في الشؤون الأمنية. فالمجتمع المحلي يتماهى بشكل عام أكثر مع الشرطة البَلَدية التي يشعر أنها تمثّله. بيد أن الأحزاب كافة تحاول الحرص على أن يتطابق النظام الاجتماعي القائم إلى أقصى حدّ ممكن مع أجنداتها السياسية. على سبيل المثال، يتألّف المجلس البَلَدي والشرطة البَلَدية في الغالب من أعضاء في الحزب التقدّمي الاشتراكي، ينخرطون بشكل فاعل في الأمن المُدُني. لكن على مستوى رسمي،100 نكرت الأحزاب السياسية الاضطلاع بأدوار عسكرية، قائلةً إن تدخّلها محدود بخوض الانتخابات السياسية والحرص على المسؤولية المدنية (شؤون النفايات). فالخطوط القائمة ما بين الشبان العاديين الذين يتولّون مراقبة الأراضي وهم ينتمون رسمياً إلى الأحزاب السياسية، هي مبهمة كما الخطوط القائمة ما بين الأحزاب وأعضاء البلدية وقراراتها.
يرى العديد ممَّن حاورناهم في الحزب التقدّمي الاشتراكي خيارَهم الوحيد ليشعروا بالأمان. فعلى سبيل المثال، قالت سيدة من سكان101 عاليه ما يلي:
"ثمة مؤسسات عدة تتولّى حماية المنطقة. إلا أن معظم الناس يلجأون إلى "أهل الأحزاب" من أجل حمايتهم... أُفضّل شخصياً الوثوق بعناصر الشرطة، إلا أني لا أعرفهم شخصياً، وهنا يكمن الفارق. أضِف إلى ذلك أن مهمتهم الرئيسة هي مراقبة السير في الشوارع: إذا ركن أحدٌ ما سيارته في وسط الطريق ولم يكن صديقاً مقرّباً لهم، فهم يميلون أكثر إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة. لذلك تبقى الروابط الشخصية الخيار الأكثر أماناً".
أما في عبرين، فسلّط جميع مَن حاروناهم من السكان المحليين الضوءَ على وجود أعضاء من أُسَرِهم في مختلف الأحزاب السياسية. والأهم من ذلك هو أن معظم السكان المحليين الذين حاورناهم أكّدوا102 أن "الاختلافات ما بين الأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسة في البلدة تضمحلّ عندما يتعلّق الأمر بتدفّق اللاجئين السوريين... فالناس جميعاً يحتشدون ضد وجود اللاجئين، كما اعتادوا أن يحتشدوا ضد النظام". فضلاً عن ذلك، يشكّل كلّ من المعتقدات الدينية المشتركة والتاريخ السياسي العام للبلدة ضد النظام السوري، عاملَين أساسيَّين في العلاقات المتينة التي جرى بناؤها. وكمثالٍ على ذلك، أشار ممثّل عن حزب سياسي آخر في عبرين إلى احتفالات رأس السنة الفائتة، حيث اجتمعت الأحزاب السياسية كلها ونظّمت عشاءً جماعياً في البلدة. هذا ولا يعكس عدد بطاقات العضوية الحزبية الهيمنةَ الفعليةَ لأيّ من الأحزاب في عبرين. في هذا الإطار، قال أحد الممثّلين103 عن الأحزاب إن "البلدة تُعَدّ تاريخياً مهد السياسة الكتائبية، لكني الآن لا أستطيع القول إن ثمة حزباً أكثر نفوذاً من غيره". ويمكن تفسير هذا الأمر أيضاً، على حدّ قول أحد السكان في عبرين، بواقع أن إنشاء فروعٍ للأحزاب السياسية ظلّ مُحظَّراً حتى انسحاب القوات السورية في نيسان/أبريل 2005.104
يمكن النظر إلى ما يُعرَف باستباق العنف في عبرين على أنه لحظة اجتماعية ما بين السكان المحليين أياً يكن موقفهم السياسي: فالسكان يرتبطون طبعاً بعضهم ببعض، وبالآخرين والمؤسسات المحلية، من خلال دعمهم التدابير الأمنية غير الرسمية. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه اللحظة ما بين الأفراد تنطوي على الأمل بانتفاء العنف، وبأن ما يُتوقَّع لن يتحقّق في نهاية المطاف.105
إضافة إلى الأحزاب السياسية، برزت مخابرات الجيش بصفتها ملجأً رئيساً للعديد ممَّن حاورناهم في حال وقوع مشكلة أمنية. بيد أن آخرين قالوا إنهم يشعرون بالراحة أكثر عندما يبلّغون مختار القرية عن الحادثة. ومع أن المختار لا يضطلع بأي دور في الشؤون الأمنية، إلا أنه ينبغي أن يشهد على توقيف أي شخص في القرية من قبل قوى الأمن الداخلي أو القوات المسلحة اللبنانية، ليكون بذلك حارس المجتمع المحلي. وهذا الأمر يحصل إجمالاً في أرجاء لبنان كافة، ويُثبِت العلاقة الغريبة بين توفير الأمن رسمياً وتوفيره بشكل غير رسمي، إضافة إلى التطبيق العملي للأنظمة عبر الطرق غير الرسمية، الأمر الذي يجعل الوجود الملموس لمزوّدي الأمن الرسميين على الأرض ثانوياً، وحتى فائضاً عن الحاجة في الغالب.
لفت أحد السكان الآخرين إلى أن الأشخاص العاديين لا يبلغّون الأحزاب السياسية عن الحوادث التي تحصل على الفور، ذلك أن هذه الأحزاب لا تتدخّل مباشرةً. وقال إن "الشرطة هي التي لا تزال تتدخّل على الفور. أما الأحزاب السياسية، فتتدخّل على المدى الطويل".106 وقد أقرّ رئيس الشرطة البَلَدية في المقابلة التي أُجريَت معه، بأن الشرطة البَلَدية هي المؤسسة الرسمية الأولى التي يتعامل الناس العاديون معها. ولفت إلى أن "الشرطة تستدعي قوى الأمن الداخلي في حال تسبَّب الناس بانعدام الأمن ولم يفهموا كيف يجب أن يتصرّفوا. لكننا المرجع الرئيس للناس المحليين، إذ يتوجّهون جميعاً إلينا".107
تتمتّع الأحزاب السياسية في عبرين وعاليه بشرعية اجتماعية تُمكّنها من منح الناس المحليين حسّاً بالأمان، الأمر الذي يستحوذ على عواطف السكان. وهي تتمتّع بهذه الشرعية بصفتها مزوّداً للأمن، لا بصفتها جهةً سياسيّةً فاعلةً. مع ذلك، تتدخّل الأحزاب السياسية بشكل مباشر في توفير الأمن في بلدة عبرين فقط من خلال أعضاء الأحزاب السياسية الرئيسة الثلاثة (القوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر، والكتائب). ويشكّل حرّاس عبرين غير الرسميين دعماً مؤقّتاً متفرّقاً للشرطة البَلَدية. "حماة المجتمع المحلي" هؤلاء، على حدّ تعبير عضو في أحد الأحزاب المحلية،108 ينتمون إلى مختلف الأحزاب. كما شدّد ممثّل آخر عن أحد الأحزاب على أن "القيام بالدوريات ليس بالأمر السياسي، بل هو يعني الأمن للبلدة بأكملها".109
أما في شبعا، فيبدو أن الأحزاب السياسية لا تؤدّي أي دور في الشؤون الأمنية، نظراً إلى الشرعية الاجتماعية الضعيفة التي تتمتّع بها. الواقع أن الشعور العام بالإهمال من الجهات السياسية الرسمية يؤدّي إلى الضعف العام الذي تعانيه الأحزاب السياسية. فكما قال أحد الأشخاص الذين قابلناهم، "من الصعب على أي حزب في شبعا أن يستمر. شبعا هي مقبرة الأحزاب السياسية".110 ومع أن أعضاء البلدية كافة انتُخِبوا على لائحة مشتركة بين تيار المستقبل والجماعة الإسلاميّة، لا يتمتّع تيار المستقبل بأي تواجدٍ في الشارع. أما الجماعة الإسلاميّة فطوّرت نوعاً من التواجد في الشارع مع وصول اللاجئين السوريين. ومع ذلك، لا تتمتّع بالكثير من الشرعية، وبالتالي لا تضطلع بدور في مجال توفير الأمن. وهكذا، لا ينتمي الشبان الذين يتولّون مهمة تأمين الشوارع والتدخّل في حال وقوع حوادث أمنية، إلى أي حزب سياسي، بل تُطلَق عليهم تسمية "شباب العِيَل" (أي شبان الأُسَر). وقد وصف لنا أحد الذين حاورناهم كيف طُبّقَت هذه الآليات بعد وصول اللاجئين السوريين:
"عندما وصلت الدفعة الأولى من اللاجئين، اعتمدنا بدايةً أسلوب الانتظار والترقّب، وراقبنا عن كثب الوضع استباقاً للمشاكل التي قد تقع. بعد ذلك بوقت قصير، وقعت حادثة بسيطة: تحرّش رجل سوري بفتاة من بلدتنا في الشارع. فقرّرنا عندئذ التدخّل. جمعنا اللاجئين كلّهم في الجامع، حيث تحدّثت لجنة إليهم. شرحنا الوضع وكنا واضحين بأننا لن نستسيغ أي مشكلة. وكان ذلك بمثابة تحذير. فقلنا لهم: "أنتم على الرحب والسعة عندما تتّبعون القواعد، وإلا سنتعامل مع الأمر على طريقتنا". والأمور على ما يرام مذّاك الحين. لكن عندما يحدث شيء ما، شبان الأحياء هم على أهبة الاستعداد للتدخّل. يجب أن يكون معلوماً أننا جميعاً مسلّحون. جميعنا يحمل السلاح، بطريقة شرعية وغير شرعية، ونحن لا نأبه". في مقابلة أُجريَت في شباط/فبراير 2016، شبعا.
فضلاً عن ذلك، عبّر الأشخاص الذين حاورناهم في شبعا عن نفورهم تجاه نفوذ الأحزاب السياسية في ما يتعلق بالشؤون الأمنية المحلية. كما سبق وذكرنا، أقرّ العديد ممَّن قابلناهم بأن مجموعة صغيرة من مناصري حزب الله يُفترَض أن تراقب الأمن في البلدة. لكن شعبية هذه المجموعة ضئيلة إلى حدّ أن أعضاءها لا يريدون حتى أن يُلاحَظ وجودُهم. "يُعَدّ تواجد عناصر حزب الله محدوداً في شبعا، إذ يبلغ عددهم حوالى 20 شخصاً أو أكثر بقليل، وهم يتقاضون 150 دولاراً في الشهر. هؤلاء الأشخاص مستعدون لتغيير انتماءاتهم في ليلة وضحاها في مقابل كسب بعض المال". في مقابلة أُجريَت في شباط/فبراير 2016، شبعا.
يضمّ مزوّدو الأمن غير الرسميين الآخرون المسجلّون في وزارة الداخلية، شركات أمن خاصةً لا تنشط إلا في المناطق المُدُنية (عاليه). ويقوم دور هذه الشركات الرئيس على حماية القصور، أو الجهات والأبنية الخاصة، أو المصارف. ويُقال أيضاً إن الوجهاء الذين يزورون المنطقة يعتمدون أحياناً على الشركات الخاصة لتعزيز أمنهم الشخصي. فأمير قطر، على سبيل المثال، اشترى قطعة أرض في عاليه، وقد زوّدته البلدية بمُراقِب للشارع. في مقابلة أُجريَت مع أحد السكان المحليين في نيسان/أبريل 2016، عاليه.
في المقابل، نادراً ما تنخرط وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميةفي مقابلة أًجريَت مع ممثّل عن منظمة غير حكومية في آذار/مارس 2016، البترون. في تطبيق الأمن المحلي. ففي المقابلات التي أجريناها، أكّدت هذه الوكالات والشركات أنها تسعى عادةً إلى دعم اللاجئين في الشؤون القانونية. بيد أن اللاجئين غالباً ما يسحبون طلباتهم مخافة اتّخاذ إجراءات عامة ضد السكان اللبنانيين في البلدة حيث يقطنون، الأمر الذي يعيق إمكانات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على المناداة. منعُ شرطة بلدية عبرين الأطفال السوريين من أن يدخلوا أحد الملاعب هو أحد الأدلة على عجز المنظمات غير الحكومية عن المناداة بشكل غير رسمي بحماية اللاجئين. ففي حين أن العديد من السكان المحليين أكّدوا شرعية هذا الإجراء، لم تُعَدّ التدابير التي اتّخذتها وكالات الأمم المتحدة في وجه هذه المسألة فعّالةً بما يكفي لتغيير السلوك المحلي، ووضع حدّ للأنظمة (غير الشرعية) التي يُطلِقها المجتمع المحلي. وقد أقرّ العديد من السوريين ممَّن قابلناهم في الأماكن الثلاثة بأنهم لا يشعرون بالإهمال من المنظمات غير الحكومية في ما يتعلّق بتقديم الخدمات فحسب، بل أيضاً في ما يختصّ بالتدابير الحمائية.
صحيح أن انتماء مزوّدي الخدمات الرسميين وغير الرسميين إلى المجتمع المحلي هو معيار الثقة الأول بالنسبة إلى السكان المحليين، إلا أن المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة – التي تمثّل المجتمع الدولي – هي الهيئات الرئيسة التي يتوقّع اللاجئون السوريون أن تزوّدهم بالحماية القانونية والوصول إلى الأمن وهيئات العدالة.
تعود التحديات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية في مجال حماية اللاجئين جزئياً إلى التفويض غير الرسمي الذي تحظى به لتحقيق هذا الهدف – باستثناء تفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – وإلى أنظمة المنظمات غير الحكومية التي تحظّر معالجة القضايا السياسية أو الدينية في المساحات الاجتماعية المخصّصة للاجئين. وبالتالي يُحرَم اللاجئون من إمكانية البحث بحريةٍ وراحةٍ عن سُبُلٍ من شأنها أن تسهّل وصولهم إلى آليات العدالة والحماية الذاتية. كما أن بيروقراطية عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصعوبة تواصل اللاجئين مع وكالات الأمم المتحدة عموماً، يعيقان أكثر بحث اللاجئين عن الأمن والحماية.
وفقاً لنتائج العمل الميداني، لا يبدو أن المنظمات غير الحكومية توفّر الأمن على الأرض، إلا أنها تُنتِج خطاباً حول الأمن يركّز على الإضاءة على التهديدات الأمنية القائمة في مختلف المناطق أو "الأماكن الساخنة"، وذلك بغية ترجمة التصوّرات حول الأمن وغيابه إلى سياسات عامة خاصة بالاستقرار.
الخاتمة
حلّل هذا التقرير كلاً من الآليات الأمنية متعددة الأوجه، والجهات الفاعلة، ومعاني الأمن، في مناطق لبنانية ثلاث تأوي لاجئين سوريين. وقد استعرض كيف أن مفهوم الأمن يُعاد البحث فيه باستمرار، ولا سيما منذ وصول اللاجئين السوريين. كما أظهر التقرير كيف اعتُمِدَت آليات الحماية والوقاية المختلفة بحجّة الحفاظ على النظام الاجتماعي. وقد ثبُت أن التهجين هو تعريف إرشادي، إذ يُبرِز كيف تعتمد مختلف الجهات الفاعلة معاني الأمن، وتبحث فيها، وتُعيد إنتاجها بحسب السياق. وهكذا، لا يشير الأمن الهجين إلى دولة لبنانية ضعيفة، ولا إلى توزيع العمل ما بين الجهات الأمنية الحكومية الرسمية الفاعلة والجهات المحلية غير الرسمية الفاعلة، بل إلى تفاعلٍ معقّدٍ ما بين الجهات الأمنية الحكومية الرسمية الفاعلة ومزوّدي الأمن غير الرسميين، الذين يكمّل أحدُهم الآخر.
تُربَط آليات الأمن الذاتي إجمالاً بالمناطق التي يسيطر عليها حزب الله، ولكنها في الواقع تنتشر في أرجاء لبنان كافة. فالمفاهيم والممارسات المتعلقة بالأمن (أو انعدامه) هي متجذّرة بشكل متنوّع في التاريخ المحلي للبلد. صحيح أن هذه المفاهيم والممارسات تساهم في بناء تعريفٍ متجانسٍ للمجتمع المحلي، إلا أنها تستلزم آليات إقصائيةً من شأنها أن تُفاقِم وضع اللاجئين السوريين. وقد أتاح تحليلُ توفير الأمن باعتباره عاملاً في الانتماء إلى المجتمع المحلي، وفي الوضع الاجتماعي، البحثَ في مدى تجانس المجتمع المحلي على الرغم من الاختلافات السياسية الراسخة. وبالتالي يوضَع الأمن رسمياً في إطار مشروع مجتمعي يضع مجتمعات اللاجئين على هامش الأنماط المحلية، ويقوّض إمكانيات الاندماج مع القادمين الجدد، هذا الاندماج الذي تحبطه السياسات الحكومية في لبنان. وهكذا يصبح الأمن في نهاية المطاف أداةً مبهمةً للتجانس الاجتماعي والتجزئة الاجتماعية في الأزمات الإقليمية. بعبارة أخرى، يعزّز كلٌّ من الخطابات الرسمية حول الأمن، وإظهار اللاجئين السوريين على أنهم تهديد، التجزئةَ الاجتماعيةَ ويقوّض الجهود المبذولة لتقوية الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل. وهكذا يشكّل حظر التجوّل جزءاً من استجابة وقائية أشمل للتهديد المتصوَّر
على الرغم من تردّدنا في تصنيف السرديّات من خلال الثنائيات "لبناني" و"سوري" أو "محلي" و"لاجئ"، غالباً ما يقدّم اللاجئون سرداً مختلفاً عما يقدّمه المواطنون المحليون حول الأمن. فاللاجئون يشعرون بعدم الأمان بطبيعة الحال بسبب هذا الاستباق للتدابير العنفية، وذلك على الرغم من الانخفاض النسبي لحوادث العنف في المناطق الثلاث التي اخترناها. وهذا الأمر يحفّزه القلق الاجتماعي العام ومناخ الخوف الذي يعيش اللاجئون حياتهم اليومية في ظله.
في السياق نفسه، غالباً ما يرتبط عجز اللاجئين عن حماية أنفسهم ضد هذه التدابير بوضعهم غير الشرعي. وبالتالي يفهم اللاجئون المشروعية على أنها وسيلة تقود إلى "الأمن". ومن خلال طريقة التفكير هذه، يميلون إلى ربط تحقيق السلامة الجسدية والأمن الحضري بوضعهم الشرعي (أو غير الشرعي).
فضلاً عن الحاجة إلى الحماية القانونية، التي من شأنها أن تتيح للاجئين الوصول إلى الأمن، رمى هذا التقرير إلى التشديد على أهمية إعادة تصميم أشكال الحماية التي لا تهدف إلى معالجة الخطر الفعلي فحسب، بل تتركّز أيضاً حول التدابير الوقائية غير الرسمية الهادفة إلى استباق العنف. ويبدو أن السياسات المنبثقة عن جهود التنسيق ما بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومة المحلية، تتقاطع لتُنتِج الوضع القائم. فعوض أن ترمي هذه السياسات فقط إلى تقوية الجهات الرسمية الفاعلة – التي تلقى في الواقع الدعم حالياً من برنامجٍ للاتحاد الأوروبي، يزوّد عملية إصلاح قطاع الأمن بالمساعدة التقنيةيمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على الرابط التالي: – ينبغي أن تأخذ في عين الاعتبار أكثر كلاً من مزوّدي الأمن غير الرسميين وأشكال توفير الأمن المبهمة، مثل الجهود المُنسَّقة للشرطة البَلَدية وأنظمة حكم المجتمعات المحلية.
تُعَدّ عاليه وعبرين المنطقتَين الأكثر أماناً نسبياً من المناطق الثلاث بالنسبة إلى اللاجئين السوريين. هنا تتماشى الميول السياسية السائدة مع المصلحة الوطنية التي تقضي بالمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والنظام السياسي. بيد أن تحقيق السلامة الجسدية يحدث على حساب مناخ عام من الخوف والتهويل، حيث يشعر اللاجئون بأنهم ضعفاء وبأن حرياتهم محدودة. أما في شبعا، فيُنظَر إلى اللاجئين على أنهم جزء من المجتمع المحلي، وذلك بفضل الروابط التاريخية بين سكان البلدة وبلدة المنشأ السورية. مع ذلك، يشكّل استباق العنف جزءاً من مناخٍ يسوده انعدام الثقة المتبادلة، حيث السياسة عائلية التوجّه. يجدر الذكر أن شبعا هي مرتع لمجموعات المعارضة السورية المسلحة، وبالتالي مركز لبعض العوامل المحتملة المُزعزِعة للاستقرار في لبنان. هذا ويتعرّض اللاجئون السوريون إلى مداهمات من أطراف أمنية رسمية، فيشعرون بالتالي بعدم أمان أكبر مما يشعرون في عاليه وعبرين. ومع ذلك، وجد بعض اللاجئين السوريين في شبعا، كما سبق وذكرنا، نسخةً عن مساحتهم الاجتماعية وأخلاقياتهم.
تقع حماية اللاجئين، في الحالات الثلاث، تحت رحمة السياسة المحلية، وتعكس رغبةً مشتركةً في إرساء الأمن المحلي.
ختاماً، تُعَدّ التدابير الأمنية غير الرسمية فعّالةً في الحفاظ على النظام الاجتماعي المحلي، على الرغم من نمطها المَرِن. ومع ذلك، لا تزال الجهات الرسمية الفاعلة تضطلع بدور أكبر في إعادة بسط الأمن عندما تبرز مسائل أمنية حادّة.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات الفاعلة التي تتمتّع بالموثوقية الأكبر – أي الشرطة البَلَدية، والأُسَر المحلية النافذة أو الزعماء المحليون النافذون، والأشخاص المحليون المنتمون إلى أحزاب سياسية – وُصِفَت في المقابلات التي أجريناها مع المجتمعات المحلية اللبنانية في المناطق الثلاث، على أنها الجهات الفاعلة الأضعف، على عكس القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.






