نظام الحماية الاجتماعية في لبنان منذ نشأته، وعبر مختلف مراحل تطوره التاريخي، هو نظام مجزأ يتميز، من جهة، بخطط متفرقة قائمة على الاشتراكات، ومن جهة أخرى، ببرامج مساعدة اجتماعية غير فعالة ومحددة زمنيًا. يتناول هذا التقرير الجوانب المختلفة لإخفاقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانهياره الوشيك في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان منذ العام ٢٠١٩. ومن خلال تقديم لمحة عامة عن التطورات التي شهدها الصندوق عبر تاريخه، يُظهر التقرير أنَّ الأزمة قد كشفت النقاب عن أوجه القصور التي طال أمدها في الصندوق، والمرتبطة حُكمًا بتصميمه وهيكليته منذ العام ١٩٦٣ وحتى اليوم. وتؤكد هذه الدراسة أن عجز الصندوق عن حماية المستفيدين/المستفيدات منه من تأثير الأزمة الاقتصادية الحادة الحالية يجب أن يُفهم على أنه جزء من عجز عام في نظام الحماية الاجتماعية اللبناني ككلّ.
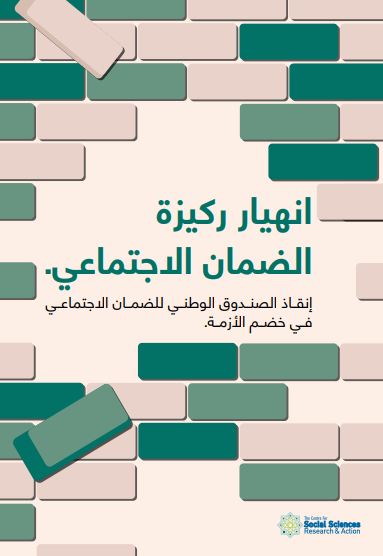
المقدمة
"يفتقر لبنان إلى نظام حماية اجتماعية يستند إلى ضمانات دورة الحياة ويرتكز على حق الإنسان في الضمان الاجتماعي. فهو يفتقر إلى التأمين ضد البطالة، وبدلات إعالة الأطفال، ومعاشات الشيخوخة أو العجز، واستحقاقات المرض والأبوة. وللنظام بصيغته الحالية تأثير محدود على الحد من الفقر، وله تأثير ضئيل على عدم المساواة، ويميل إلى حد كبير نحو حماية ذوي الدخل المرتفع." (الأمم المتحدة ٢٠٢٢، ١٥)
الاقتباس الوارد أعلاه هو مُقتطَف من تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إلى مجلس حقوق الإنسان بعد زيارته إلى لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ٢٠٢١. وتشير الملاحظات المذكورة حول نظام الحماية الاجتماعية في لبنان وقيوده وثغراته وتحدياته إلى الخلل الموجود منذ فترة طويلة في هذا النظام والذي يعود إلى تاريخ إنشائه رسميًا في الستينيات. فنظام الحماية الاجتماعية في لبنان منذ نشأته، وعبر مختلف مراحل تطوره التاريخي، هو نظام مجزأ يتميز، من جهة، بخطط متفرقة قائمة على الاشتراكات، ومن جهة أخرى، ببرامج مساعدة اجتماعية غير فعالة ومحددة زمنيًا (عبده ٢٠١٩؛ أبي ياغي ويمين ٢٠١٩؛ سكالا ٢٠٢٢). يتألف النظام القائم على الاشتراكات من برامج إلزامية للضمان الاجتماعي وضعتها الدولة ونُفِّذَت على الطبقة العاملة بشكل نظامي (في القطاعين الخاص والعام) وأُسَرِهم/نّ. وفي سياق سوق العمل الذي يتّصف بطابعه غير النظامي بدرجات عالية (تتراوح بين ٥٤% و٦٦% وفقًا للبيانات المتوفرة قبل الأزمة في ٢٠١٩، بحسب منظمة العمل الدولية وإدارة الإحصاء المركزي ٢٠١٨/٢٠١٩؛ البنك الدولي ٢٠١٤)، تبقى غالبية السكان من دون أي نوع من الحماية بسبب برامج الضمان الاجتماعي الوطنية هذه.
يتطرّق هذا التقرير إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ركيزة أساسية لنظام الضمان الاجتماعي في لبنان. أسس الرئيس الراحل فؤاد شهاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام ١٩٦٣، وهو مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تغطي العاملين/ات في القطاع الخاص. وجاء تأسيسه مباشرةً بعد إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي للعاملين/ات في القطاع العام، وهي "تعاونية موظفي الدولة" في بداية العام ١٩٦٣.[1]
يوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تغطية التكاليف الطبية والمخصصات العائلية وكذلك تعويضات نهاية الخدمة للعاملين/ات في القطاع الخاص. وهو يعتمد على اشتراكات يسددها صاحب العمل والموظف/ة، بالإضافة إلى الإعانات الحكومية. قبل الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية في البلد. ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية مؤخرًا، كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "أول ممول للإنفاق الصحي بنسبة ٢٠% من إجمالي الإنفاق على الصحة في العام ٢٠١٧" (منظمة العمل الدولية ٢٠٢٠، ١٢). ووصف أحد مُحاورينا الصندوق بأنه "إلى حد بعيد - وعلى الرغم من كل القيود - أكبر مساهم في الحد من الفقر في هذا البلد."[2]
واليوم، أصبح الصندوق في وضعٍ متدهور جراء الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها البلد منذ العام ٢٠١٩. فلا يزال الصندوق يسدد التعويضات للمستفيدين/ات على السعر الرسمي البالغ ١ دولار أمريكي = ١،٥٠٧ ليرة لبنانية (بينما ارتفعت قيمة سعر الصرف الحقيقي بأكثر من ٢٠ ضعفًا وهي تتراوح بين ٣٥٠٠٠ و٣٩٠٠٠ ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي الواحد في وقت إعداد هذا التقرير)، وبالتالي تُعتبر هذه التعويضات وكذلك تعويض نهاية الخدمة ذات قيمة منخفضة أو معدومة.
في موازاة ذلك، وبالإضافة إلى الأزمة المالية، لم تتخذ الحكومة أي خطوات جدية لإصلاح الصندوق الذي كان يغطي في العام ٢٠١٩، أي قبل الأزمة الحالية، ما يُقارب ٢٣% من السكان بحسب بعض المصادر (داغر وزغيب ٢٠٢٢).
في العام ٢٠٢١، اقتصرت الحماية الاجتماعية، بمختلف أشكالها، على شخص واحد من بين كل شخصين لبنانيين وشخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص غير لبنانيين مقيمين في لبنان (منظمة العمل الدولية ٢٠٢١، ٥ و٩).
إنَّ معدلات الإقصاء الملحوظة هذه تعكس النظام المُشرذم والقائم على التمييز والإقصاء في لبنان، والذي يحمي فئات منفصلة من السكان. فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يغطي الأفراد الذين يعملون بشكل نظامي خلال سنوات عملهم/نّ، لا يشكل سوى ركيزة واحدة فقط - وإن كانت ركيزةً أساسية - في هذا الإطار المجزأ للحماية الاجتماعية.
يتعمق هذا التقرير في تاريخ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطوره منذ العام ١٩٦٣، ويتناول ثغراته الهيكلية واستغلاله من قبل الجهات السياسية، كما يُقيِّم الوضع الحالي للصندوق في خضم الأزمة، ويناقش عددًا من الإصلاحات المقترحة بالنسبة إلى الجهات المعنية المختلفة.
ونظرًا لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو إقصائي بطبيعته، نرى أنه لا يمكن صياغة أي إصلاح للصندوق من خلال تدابير بسيطة، بل يجب اعتبار الصندوق كجزءٍ من نظام الحماية الاجتماعية في لبنان. فالإصلاح المتكامل لنظام الحماية الاجتماعية بمجمله، ليصبح نظامًا شاملًا للجميع وقائمًا على حقوق الإنسان، هو الطريقة الوحيدة التي من شأنها أن تُحسِّن قدرة الصندوق على حماية الأفراد من المخاطر وجوانب الهشاشة في مختلف مراحل دورة الحياة.
|
المنهجية يستند هذا التقرير إلى مراجعةٍ للمنشورات والدراسات الصادرة حول هذا الموضوع، وكذلك البحوث التجريبية. أُجريت سلسلة مؤلفة من سبع مقابلات معمقة ومستهدفة وشبه منظمة مع خبراء في الحماية الاجتماعية في لبنان بشكل عام وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل خاص، يعملون في منظمات غير حكومية محلية ودولية، وذلك بين شهرَيْ نيسان/أبريل وآب/أغسطس من العام ٢٠٢٢. بالإضافة إلى ذلك، أُجريت ثلاث مقابلات مع موظفين/ات مدنيين/ات يشغلون مناصب مختلفة وبدرجات متفاوتة من المسؤولية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأُجريت ثماني مقابلات مستهدفة ومعمقة مع مستفيدين/ات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم تصنيفهم/نّ وفقًا للخلفية الاجتماعية-الاقتصادية والنوع الاجتماعي والوضع العائلي. وسمحت الملاحظات الإثنوغرافية في مواقع مختلفة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت ومنطقتين إضافيتَيْن بجمع المزيد من البيانات النوعية. |
۱. الضمان الاجتماعي في طور التأسيس: لمحة تاريخية عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ إنشائه
يعود إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى عهد الرئيس اللبناني فؤاد شهاب، الذي عُين في العام ١٩٥٨ بعد أشهُر من الاضطرابات والنزاعات المسلحة في البلد، التي تُعزى بجزءٍ منها إلى "أشكال عدم المساواة الاجتماعية-الجغرافية والطائفية الحادة التي أنتجتها المرحلة الانتقالية بعد الاستقلال نحو ما يسمى بالنموذج الاقتصادي "للجمهورية التجارية"" (توفارو ٢٠٢١، ١٢). كان فؤاد شهاب لواءً في الجيش، وكان الهدف الرئيسي من حكمه يتمثل في استعادة دولة القانون والنظام. وعادةً ما يشير عهده والمصطلح المرتبط به - "الشهابية" - إلى مقاربة تنموية للسياسة والدولة. وفي حين أدخل الرئيس شهاب عناصر "حديثة" إلى السياسة اللبنانية، إلا أنه حافظ أيضًا على توازنٍ معين من خلال الإبقاء على الهياكل والعمليات القديمة (هدسون ١٩٨٥). وكانت جهود التحديث هذه تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من سلطة النخبة السياسية والاقتصادية التقليدية (ما يُسمى بالزعماء) التي كانت المصدر التقليدي لتوفير الحماية الاجتماعية عن طريق مسارات الرعاية الاجتماعية الطائفية (هوتنجير ١٩٦٦؛ يحيا ٢٠١٥). وكان يُعتقد أن مقاربته للحماية الاجتماعية والأمن، التي تنطلق من الدولة كأساسٍ لها، تُساهِم في نهاية المطاف في تحجيم دور هذه المسارات (سكالا ٢٠٢٢، ١١).
تم تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يتماشى مع "أيديولوجية الرعاية الاجتماعية المعتدلة هذه، المُفصَّلة على قياس الوضع اللبناني" (هدسون ١٩٨٥، ١٦١). وهي مقاربة "معتدلة" بالدرجة الأولى لأنَّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يشمل سوى العاملين/ات بشكل نظامي في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم/نّ: لم يكن الغرض من الصندوق تقديم الضمان الاجتماعي أو المساعدة الاجتماعية إلى جميع المواطنين/ات اللبنانيين/ات أو المقيمين/ات في لبنان. واستُوحيَ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من النموذج الفرنسي للصندوق الوطني للتأمين ضد المرض (Caisse nationale de l’assurance maladie – CNAM). وكلاهما يتبعان النموذج البسماركي للحماية الاجتماعية الذي يربط التغطية بالعمل النظامي. وعلى غرار الصندوق الوطني الفرنسي للتأمين ضد المرض، صُمم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليكون مؤسسة مستقلة، إداريًا وماليًا، ضمن مظلّة وزارة العمل ومجلس الوزراء.
أقر الرئيس شهاب مرسوم "قانون الضمان الاجتماعي" في أيلول/سبتمبر من العام ١٩٦٣. وبعد عامَيْن، وتحديدًا في شهر أيار/مايو من العام ١٩٦٥، دخل المرسوم حيز التنفيذ. وكما ذكرنا أعلاه، جاء إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تأسيس "تعاونية موظفي الدولة" التي تقدم لموظفي/ات القطاع العام تقديمات وخدمات أكثر سخاءً في مجال التأمين الاجتماعي. ويؤكد إنشاء الصندوقين في العام نفسه على اتّباع نهج بسماركي بقيادة الدولة حيال الحماية الاجتماعية. واستبعد الصندوقان شرائح واسعة من المجتمع منذ البداية، لا بل ساهما في إنشاء تسلسل هرمي بين القطاعين الخاص والعام في ما يتعلق بالتقديمات والخدمات الممنوحة (سكالا ٢٠٢٢).
ولكن، لا يمكن النظر إلى عملية إنشاء برامج الضمان الاجتماعي من منظور سياسة تنازلية تمنحها القيادة التنموية (من الأعلى إلى الأسفل). يجب النظر إليها أيضًا في سياق الحركة العمالية التي استمرت على مدى عقد من الزمن في البلد والتي كانت تُنادي بعدة مطالب عمالية واجتماعية، "بما في ذلك إقرار قانون الضمان الاجتماعي" (توفارو ٢٠٢١، ١١). وفي السنوات التي أعقبت إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واصلت الحركة العمالية أنشطتها من أجل الدفع باتجاه التنفيذ الكامل لقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإصلاحه (سكالا ٢٠٢٢، ١١).
وفي موازاة المساعي التنموية للرئيس شهاب، تعزّزت الدولة البوليسية خلال عهده: فعمدت أجهزة المخابرات إلى احتواء أي معارضة اجتماعية وكذلك التحركات العمالية خلال تلك الفترة (طرابلسي ٢٠٠٧، ٥٦).
استمر عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية في العام ١٩٧٥. ففي أثناء الحرب الأهلية، أدى العنف وتشرذم الدولة إلى زعزعة كل مؤسسات الدولة، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وانتهت الحرب بأزمة اقتصادية ونقدية حادة في العام ١٩٩٠: فكان البلد مُدمَّرًا والاقتصاد منهارًا. وأدى ذلك إلى سياسات تقشف نيوليبرالية، وموجة من الخصخصة، و(إعادة) تطوير الاقتصاد الريعي واقتصاد الخدمات في عهد رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري منذ العام ١٩٩٢ (بومان ٢٠١٧). ومن أجل الحد من الخسائر التي تكبدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرر الاستثمار في سندات الخزينة، نظرًا لأسعار الفائدة المرتفعة على هذه السندات. وفي العقود التالية، استمرَّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الاعتماد بشكل كبير على الاستثمار في سندات الخزينة. في الواقع، كان هذا يعني أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتمدَ على مصدر واحد فقط للاستثمار، وإن كان ذلك يُعتبَر محفوفًا بالمخاطر. كذلك، كان يدعم ديون الدولة ويُموِّلها بشكل غير مباشر.
في السياق نفسه، ومنذ نهاية الحرب الأهلية، لم تُسدِّد الحكومات المتعاقبة مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[3]، ما ساهم في إضعاف الاستدامة المالية للصندوق. وبالمثل، في السنوات الأولى من الألفية، تدخلت الحكومة بشكل مباشر وخفضت اشتراكات أصحاب العمل من ٣٨،٥% إلى ٢١،٥%، ما زاد الصعوبات المالية للصندوق (مجلة إكزيكيوتيف ٢٠١٢).
في شهر آذار/مارس من العام ٢٠٢٠، تخلفت الدولة اللبنانية عن سداد ديونها، ما أدى إلى ضوابط غير رسمية على رؤوس الأموال من قبل النظام المصرفي، ما أسفر بدوره عن تجميد أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي المتأخرات المستحقة على الدولة (مرهج وشهيب ٢٠٢٢). في الواقع، على مدى السنوات القليلة الماضية، يدفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستحقاته للمستشفيات بحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، ما أدى إلى رفض الأطراف الثالثة لمدفوعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي بات يترتب على المرضى دفع ما يقارب ٩٠% من فاتورة الاستشفاء.
وتجدر الإشارة إلى أن ديون الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تُقدَّر بـ ٥٠٠٠ مليار ليرة لبنانية، أي حوالي ٢،٨ مليار دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي (المؤسسة اللبنانية للإرسال - أخبار لبنان ٢٠٢١).
إضافةً إلى ذلك، إنَّ تدخل السياسيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ساهمَ في استغلاله كأداة للأجندات السياسية واتباع المنطق الزبائني. على سبيل المثال، قال/ت أحد الأشخاص الذين أجرينا معهم/نّ مقابلات: "أعضاء مجلس الإدارة صريحون بهذا الخصوص، ويخبروني مَنْ الذي يتعين عليهم تقديم التقارير إليه، والحزب السياسي الذي يحدد قراراتهم."[4]
ويُعتبر التدخل السياسي في شؤون التوظيف والتعيينات الرسمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحد أعراض الحوكمة والإدارة المغلوطة في الصندوق، التي تخضع للتدخل السياسي والزبائنية والفساد.
۲. أوجه الخلل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: نتيجة للهيكلية القديمة والتدخل السياسي
تُنظَّم هيكلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوكمته بموجب المرسوم رقم ١٣٩٥٥ ("قانون الضمان الاجتماعي") الذي صدرَ في ٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣.
يُعرَّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنه "مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري." (المرسوم رقم ١٣٩٥٥ - ١٩٦٣، ٢). ويملك كلٌّ من وزارة العمل ومجلس الوزراء الحق والواجب في التدخل في الشؤون التالية: تعديل النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإقرار الموازنة السنوية، وتعيين المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الفنية. ووفقًا لما يحدده القانون، يتميز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهيكلية ثلاثية: مجلس الإدارة وأمانة السر واللجنة الفنية.
من المفترض أن يتألف مجلس الإدارة من ٢٦ عضوًا، ويمثل عشرة أعضاء منهم لجنة الموظفين، وعشرة أعضاء يمثلون لجنة أصحاب العمل، وستة أعضاء يمثلون الحكومة. ويجب اتخاذ القرارات داخل المجلس بالحصول على الأغلبية في كل مجموعة (والأغلبية في المجلس بأكمله في الاقتراع الثاني في حال عدم الحصول على الأغلبية في الاقتراع الأول). أما النصاب القانوني لاتخاذ القرارات فهو١٥ شخصًا. وتم تعيين كل مندوب لمدة أربع سنوات. وفي حين يحدد مجلس الوزراء عدد مندوبي لجنتَيْ الموظفين وأصحاب العمل، غير أن اللجنتين تقرران أسماء المندوبين عن طريق الانتخابات. وبعد انتخاب المندوبين، يصادق مجلس الوزراء على الانتخابات. ويملك مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ القرارات داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعني إقرار موازنة سنوية، واعتماد النظام الداخلي للصندوق وتعديله، واعتماد نظام المُستخدَمين بالإضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كذلك، يتولى المجلس البتّ في أي اقتراحات تُقدِّمها اللجنة الفنية.
تُناط السلطة التنفيذية بأمانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويرأسها المدير العام الذي يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير العمل. تُلقى على عاتق المدير العام وأمانة السر مسؤولية تنفيذ أي قرار يتخذه المجلس؛ كما أنه/ا يـ/تـعمل كصلة وصل بين المجلس وأمانة السر من خلال حضور اجتماعات المجلس. المدير العام الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ العام ٢٠٠١ هو الدكتور محمد الكركي. ومدة ولاية المدير العام غير محددة بموجب القانون.
أما اللجنة الفنية فتتولى دورًا رقابيًا داخليًا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تتكون من ثلاثة أعضاء، أي رئيس واحد وعضوين. وهي مسؤولة عن التدقيق في الشؤون المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنويًا، ويمكنها طرح الاقتراحات على مجلس الإدارة. لكنَّ اقتراحاتها وملاحظاتها ليست مُلزِمة، على الرغم من أنها تستطيع محاكمة المجلس.
تتألف الهيكلية الإدارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ١٢ وحدة إدارية عاملة (أي المديريات) في مركزها الرئيسي في بيروت: المديرية المالية، والمديرية الإدارية، ومديرية العلاقات العامة، والمديرية الفنية، ومديرية التفتيش المالي، ومديرية التفتيش الإداري، ومديرية التفتيش والمراقبة، ومديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل، ومديرية الإعداد والتدريب، ومديرية ضمان المرض والأمومة، ومديرية شؤون مجلس الإدارة، ومكتب المدير العام. وهناك مديريتان تم التخطيط لإنشائهما (الجودة/التخطيط والتطوير)، لكنهما لم تتحوّلا إلى وحدات عمل فعلية. هناك أيضًا وحدةٌ إدارية إضافية تعمل وكأنها مديرية، وهي مصلحة المراقبة الطبية، ما يجعل العدد الإجمالي للمديريات ١٣. ويوجد ١٣ مكتبًا إقليميًا في مختلف المناطق، بالإضافة إلى المركز الرئيسي في بيروت، و١٧ مكتبًا محليًا و٨ مكاتب للمراسلة. وعلى الرغم من أن هذه الهيكلية تبدو وكأنها هيكلية إدارية شاملة، تواجه إدارة الصندوق أوجه خلل متعددة تحد من فعالية العمل.
في الواقع، يتكون مجلس الإدارة اليوم من ١٦عضوًا فعليًا فقط، وبالرغم من أنّ المدة القانونية للمجلس الحالي انتهت منذ العام ٢٠٠٧، إنّما تم التمديد له بشكل غير قانوني كل أربع سنوات. بالتالي، يُعتبر مجلس الإدارة مجلسًا مؤقتًا بصلاحيات محدودة، غير أنه يتخذ القرارات مثل أي مجلس إدارة شرعي. إضافةً إلى ذلك، يكفي أن يتغيّب عضوان فقط من أعضاء مجلس الإدارة عن الاجتماعات لإبطال النصاب القانوني اللازم لأي قرار استراتيجي، مما يجعل سلطة اتخاذ القرار في الصندوق عُرضة للتدخل والتعطيل.
علاوةً على ذلك، ما زالت اللجنة الفنية شاغرة منذ العام ٢٠٢١. وكان آخر رئيس للجنة الفنية هو سمير عون الذي تقاعد في العام ٢٠٢١، بعد فضائح فساد عدة واستدعاءات من النيابة العامة المالية. ولم يتم تعيين أي خلف له حتى الساعة.
وُصِفَت هذه الهيكلية الإدارية بأنها "نموذج إداري قديم"[5] يفتقر إلى الإصلاحات والابتكار، بالإضافة إلى أنه يفتح المجال للممارسات الزبائنية.
ويـ/تُعطي أحد/إحدى موظفي/ات الصندوق مثالًا على ذلك، قائلًا/ـةً: "ما زالت معظم المعاملات تُنفَّذ على الورق، في حين أن استخدام التكنولوجيا ما زال شبه معدوم للتنسيق بين المستشفيات والأطباء والصيدليات. ولا يزال الناس يُحضِرون الوصفة الطبية والفاتورة وعلب الأدوية الفارغة إلى مكتب الصندوق لتحصيل مستحقاتهم/نّ."[6] وتُعتبر مكننة الصندوق مشروعًا طويل الأمد يتولاه مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ويموله الاتحاد الأوروبي (ياسين ٢٠٢١)، وما زالت نتائجه غير ملموسة.
بالإضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، هناك مشكلة أساسية تتمثّل في نقص الموظفين/ات في الصندوق. كما أشار الكثير من الأشخاص الذين أُجريت المقابلات معهم/ن، يجب أن يوظف الصندوق ما بين ٢٠٠٠ و٢٥٠٠ موظف/موظفة، في حين لديه في الوقت الحالي ١١٠٠ موظف/موظفة و١٠٠ مياوم/مياومة فقط وفقًا لآخر دراسة حول هذا الموضوع (لووير ٢٠١٣، ٤٦- ٤٧). وفي إطار تدابير التقشف المُعتمدة منذ التسعينات، تباطأت عملية تعيين موظفي/ات القطاع العام حتى أنها توقفت تمامًا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبارًا من العام ١٩٩٨ (لووير ٢٠١٣، ٤٠).
وفقًا للمياومين/المياومات الذين/اللواتي شاركوا/شارَكْن في المقابلات، أُجريت كل التعيينات في الصندوق على أساس العمل اليومي، وعُين/عُينت المياومون/المياومات على أساس المحسوبيات: "حصلت على هذه الفرصة بفضل العلاقات السياسية لأنه آنذاك، كانت الوظيفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وظيفةً لا بأس بها براتب جيد نوعًا ما حتى بالنسبة إلى المياومين/المياومات. ما زلت أعمل كمُياوم/ة حتى اليوم، ولكن منذ تقرير اللجنة الفنية في العام ٢٠١٦، يستفيد جميع المياومين/المياومات في الصندوق من تقديمات مماثلة جدًا للتقديمات التي يحصل عليها الموظفون/الموظفات العاديون/العاديات، أي الضمان الاجتماعي والإجازات السنوية والتقديمات الأخرى"[7].
وعلى غرار مؤسسات الدولة الأخرى، يُصبح توظيف المياومين/المياومات أداة سياسية وزبائنية لأحزاب المؤسسة.[8]
وبالرغم من هذه المحسوبيات في أساليب التوظيف، لا يزال الصندوق يعاني نقصًا في عدد الموظفين/ات. منذ العام ٢٠٢٠، تفاقم هذا الوضع بسبب الإضرابات المستمرة للعاملين/ات في الصندوق للاحتجاج على تدهور قيمة الرواتب المنخفضة أساسًا، وللمطالبة بتحسين ظروف العمل. لكنَّ الإضرابات تؤثر أيضًا على العمليات المُزعزعة أساسًا في الصندوق.
٣. الإقصاء والتمييز والتشرذم: تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفروعه
إنَّ طبيعة التشرذم والإقصاء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعكس الخصائص الهيكلية لإطار الحماية الاجتماعية العام في البلد.
بموجب القانون، يشتمل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أربعة فروع: أ) ضمان المرض والأمومة، ب) ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية، ج) نظام التعويضات العائلية والتعليمية، ود) نظام تعويض نهاية الخدمة. وحتى يومنا هذا، تُنفذ كل الفروع فعليًا باستثناء ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية.
الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلزامي لجميع العاملين/العاملات في القطاع الخاص وفي المؤسسات التي تملكها الدولة، مثل مؤسسة كهرباء لبنان أو المرفأ. وهو أيضًا إلزامي للعاملين/العاملات في القطاع العام الذين لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية الخاصة بالخدمة المدنية أو العسكرية (أي العاملين المتعاقدين/العاملات المتعاقدات)، على الرغم من أن ذلك لم يُطبق أبدًا من الناحية العملية. بالإضافة إلى ذلك، يُحدد القانون فئات معينة من خارج القطاع الخاص، مثل سائقي سيارات الأجرة وطلاب/طالبات الجامعات والمدرسين/المدرسات في المدارس الخاصة والعمال/العاملات في مجال الزراعة وعمال البناء والعاملين في الموانئ والسفن والأطباء باعتبارهم/نّ مؤهلين/ات للاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يُغطّي الصندوق أيضًا أفراد أسرة الشخص المُنتسِب ("الذين يعيشون تحت سقف واحد مع المضمون/المضمونة"): أ) أولاد المضمون/ة حتى بلوغهم/نّ سن الثامنة عشرة مكتملةً أو حتى سن الخامسة والعشرين مكتملةً في حال كانوا يتابعون دراستهم/نّ؛ ب) الزوجة (الزوجة الأولى فقط في حال تعددهن)؛ ج) الوالد والوالدة البالغان ٦٠ عامًا أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته ود) زوج المضمونة البالغ ٦٠ عامًا أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة عقلية أو جسدية (المرسوم رقم ١٣٩٥٥، ١٩٦٣، المادة ١٤).
بموجب القانون، تُستثنى بعض الفئات والمجموعات المهنية في القطاعين الخاص والعام من الحصول على الضمان الاجتماعي. وهذا الإقصاء يطال المجموعات التالية التي لا تستفيد أيضًا من أي خطط أخرى للحماية الاجتماعية في لبنان:
العاملون/ات غير النظاميين/ات: يشير هذا المصطلح إلى العاملين/العاملات الذين/اللواتي ليس لديهم/لديهن عقود عمل قانونية، مثل المياومين/المياومات والعمال الموسميين/العاملات الموسميات والعمال/العاملات في مجالَيْ الزراعة والبناء. ذُكرت بعض هذه المهن في قانون الضمان الاجتماعي كمستفيدين/ات شرعيين/ات وإلزاميين/ات، ولكنهم/نّ في الواقع لا يستفيدون من أي تقديمات. وفي الوقت الحالي، يشكل العاملون/ات غير النظاميين/ات الغالبية العظمى من الشريحة السكّانية العاملة، وتُقدَّر نسبتهم/نّ بين ٥٤ (منظمة العمل الدولية وإدارة الإحصاء المركزي ٢٠١٨ -٢٠١٩) و٦٦% (البنك الدولي ٢٠١٤) من المقيمين/ات في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن ترتيبات العمل غير النظامي آخذة في الارتفاع حاليًا. وتبلغ النسبة التقديرية من "العمل غير النظامي" ٢٠% في أماكن العمل النظامية (منظمة العمل الدولية ٢٠٢٠، ٣٢).
العاملون/العاملات الأجانب في القطاع الخاص: ينص قانون الضمان الاجتماعي على أن أصحاب العمل مُلزَمون بدفع الاشتراكات عن العاملين/العاملات الأجانب، غير أن هؤلاء العاملين/العاملات لا يستفيدون/يستفدن إلا من تعويض نهاية الخدمة. وفي حال كان بلدهم/نّ الأصلي يمنح للعاملين/للعاملات اللبنانيين/ات أحكام الضمان الاجتماعي نفسها، عندها يحصلون على كلّ تقديمات الصندوق. (المرسوم رقم ١٣٩٥٥، ١٩٦٣، المادة ٩). وحتى الآن، وقعت فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإيطاليا فقط اتفاقًا ثنائيًا للضمان الاجتماعي مع لبنان، ليستفيد مواطنوها من كل تقديمات الضمان الاجتماعي إذا كانوا مُسجَّلين في الصندوق (منظمة العمل الدولية ٢٠٢٠، ١٩).
عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام الكفالة: تستثني المادة ٧ من قانون العمل اللبناني عاملات المنازل من قانون العمل (قانون العمل ٢٠١٠، ٢). بالتالي، لا يخضعن أيضًا لقانون الضمان الاجتماعي. وغالبية العاملين في المنازل في لبنان هنّ من العاملات المهاجرات من جنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وتُنظَّم إقامتهن في لبنان وكذلك ظروف عملهن من خلال ما يُسمى بنظام الكفالة، وهو عبارة عن سلسلة من القوانين والمراسيم التي تلزمهن قانونًا بصاحب العمل.
الأشخاص غير العاملين والعاطلون عن العمل: لا يشمل الضمان الاجتماعي أي تأمين ضد البطالة ويتوقّف الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجرد أن يترك الشخص عمله/عملها، وبالتالي لا يحصل على أي نوع من المخصصات أو الخدمات أو التقديمات.
بعض العاملين/العاملات النظاميين/النظاميات: تشمل هذه الفئة العاملين/العاملات الذين/اللواتي وقعوا/وقعن بالفعل عقدَ عملٍ، ولكن لم يسجلهم/يسجلهن صاحب العمل في الضمان الاجتماعي، على الرغم من أن التسجيل إلزامي عند توقيع عقد العمل. يصعب تحديد نسبة انتشار هذه الظاهرة، ولكن يُزعم أنها موجودة على نطاق واسع في عدة شركات خاصة (سكالا ٢٠٢٠).
من الواضح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يُنصِف الفئات التالية:
النساء: يمكن للنساء أن ينتسبْنَ إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا لم يكنّ مُسجّلات تحت اسم رجل، ولكن لا يمكنهن دائمًا منح التغطية لأزواجهن. ولا يحق للمرأة الحصول على منحة أمومة. إضافةً إلى ذلك، لا تُمنَح أيّ إجازة أبوة، وهذا ينطوي على اعترافٍ ضمنيّ بأن رعاية الأطفال من واجب النساء فقط، مما يعزز الهياكل والسلوكيات الذكورية في المجتمع اللبناني.
المتقاعدون/المتقاعدات في القطاع الخاص: كبار السن الذين عملوا في القطاع الخاص يحصلون على تعويض نهاية الخدمة عند التقاعد ولا يحصلون على معاش شهري. في السابق، كانت تتوقف تغطية التأمين الصحي عند التقاعد، ولكن في العام ٢٠١٧، تم إقرار التأمين الصحي الإلزامي للعاملين المتقاعدين/العاملات المتقاعدات في القطاع الخاص. (القانون رقم ٢٧/٢٠١٧، راجع/ي منظمة العمل الدولية ٢٠٢٠، ١٩).
٣. ۱. ضمان المرض والأمومة
يتألف فرع ضمان المرض والأمومة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل أساسي من التأمين الصحي وتغطية الرعاية الطبية المتعلقة بالحمل. ويغطي التأمين الصحي بالدرجة الأولى تكاليف الاستشفاء والرعاية الطبية في العيادات الخارجية (الطبيب العام والأخصائي) بالإضافة إلى الأدوية وخدمات المختبرات/التصوير. وتُغطى تكاليف الاستشفاء بنسبة ٩٠% (بما في ذلك الفحوصات المخبرية ولكن باستثناء تكاليف الطوارئ)، بينما تُغطى الأدوية وخدمات المختبرات وخدمات التصوير وكذلك رعاية المرضى في العيادات الخارجية بنسبة ٨٠%.[9] أما المبالغ المتبقية فيجب أن يدفعها المريض/المريضة نفسه/نفسها أو تُسدَّد عبر أحد الصناديق المتعددة أو شركات التأمين الخاصة التي تدفع المبلغ المتبقّي بعد تغطية الضمان (ما يُسمى بـ "فرق الضمان"). وبشكل غير مباشر، إنَّ نظام التأمين الصحي الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشجع على استخدام المستشفيات، وبالتالي الرعاية الصحية الثانوية أو الثلاثية. في الواقع، على عكس الرعاية الطبية في العيادات الخارجية، يدفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المستشفى مباشرةً ولا يتعين على المريض/ة الدفع مسبقًا ثمّ الحصول على التعويض لاحقًا. فالتأخير في سداد فواتير الأدوية أو فواتير رعاية المرضى في العيادات كان يُمثِّل مشكلة كبيرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدة سنوات، ونتج عنه الكثير من الشكاوى من المستفيدين/المستفيدات. وكما قالت إحدى النساء في مقابلةٍ أجريناها معها: "في كلّ شهر، كنتُ أُقدِّم الوصفة الطبية وفاتورة الدواء لمرض القلب الذي يُعاني منه زوجي. وكانت الكلفة تُساوي ٥٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية تقريبًا، أي أنها كانت تساوي ٣٠٠ دولار أمريكي قبل الأزمة. ثم كنت أتصل بأحد معارفي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسريع عملية السداد. كُنت أَسْتَرِدّ ٨٠% من التكاليف بشكل سريع نسبيًا – ولكن فقط بفضل معارفي. لولا ذلك، كانَ عليك أن تنتظر أحيانًا لمدة ستة أشهر أو أكثر، وأحيانًا أقل من ذلك، لا أحد يعلم كم هي الفترة."[10] لذلك، فإنَّ السهولة النسبية في الحصول على تغطية تكاليف الاستشفاء (تغطية مباشرة بعد موافقة مسبقة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) مقارنةً بزيارة الطبيب (الدفع مسبقًا ثمّ استرداد المال لاحقًا) تُشجِّع على الإفراط في استخدام الرعاية الثانوية الأعلى كلفةً. إضافةً إلى ذلك، لا تتوفّر أيّ آلية للإحالة أو الرقابة من أجل منع ذلك. وهناك عامل آخر يؤدي إلى الاستخدام المفرط وإهدار الأموال المحتمل، وهو أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدفع رسمًا محددًا مقابل كل خدمة، وليس مقابل كل حالة، ما قد يدفع بمُقدِّم الخدمة (عادةً ما يكون جهة خاصة تُعني بتقديم الرعاية الصحية) إلى فرض المزيد من الخدمات غير الضرورية لزيادة تكاليف العلاجات والخدمات التي سيُسدّدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح (منظمة العمل الدولية ٢٠٢٠، ٢١). وهذا يؤدي إلى عبء غير ضروري على الأموال (العامة) في الصندوق.
وهناك انتقاد آخر يتعلق ببرنامج الرعاية الصحية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الاعتراف بالأدوية ذات العلامات التجارية كأدوية واجبة للسداد من الصندوق. لكنَّ الأدوية العامة المُدرَجة على القائمة محدودة جدًا، وهي ممارسة تعود بالفائدة على شركات الأدوية الكبرى وموزعيها، لكنَّها تأتي على حساب المرضى والصندوق نفسه. وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، يحق للمؤسسة أيضًا أن تستورد الأدوية نفسها وأن تبيعها إلى المنتسبين بالسعر الأصلي. وعلى الرغم من أن الصندوق حاولَ القيام بذلك عدة مرات في السنوات الأولى بعد الحرب الأهلية، دائمًا ما كانت الحكومة تمنع استيراد الأدوية مباشرةً من الصندوق من أجل حماية احتكار شركات الأدوية الكبرى وموزعيها المحليين (المفكرة القانونية ٢٠٢٠).
وتُعتبر تسمية الفرع باسم "ضمان المرض والأمومة" مُضلِّلة نوعًا ما إذ هناك جوانب عدة من الفرع - على الرغم من ذكرها في القانون - لم تُنفَّذ بعد. من الناحية العملية، تتضمن رعاية الأمومة، بشكل أساسي، تغطية الرعاية الطبية المتعلقة بالحمل، أي قبل الولادة وأثناءها وبعدها، لكنها لا تُقدِّم أي تعويض عن خسارة أجر المرأة أثناء الحمل. ينطبق الأمر نفسه على الحالات المَرَضية وما قد ينتج عنها من خسارة في الأجور. والمكونات الثلاثة هي جزء من قانون العمل، وبالتالي هي من واجب صاحب العمل، وليس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في المادتين ٢٨ و٢٩ من قانون العمل، تُحدَّد إجازة الأمومة بسبعة أسابيع، ويتعين على صاحب العمل دفع كامل الراتب للحامل ولا يمكنه فصلها من العمل. وتُنظِّم المادة ٤٠ الإجازة المرضية والراتب بحسب مدة الإجازة. كذلك، لا يجوز فصل الشخص من العمل خلال الإجازة المرضية (المادة ٤٢). ولا يمنح قانون العمل ولا قانون الضمان الاجتماعي أي إجازة أبوة. وكما ذُكِر أعلاه، ينص القانون ضمنًا على أنَّ رعاية الأطفال هي مهمة جندرية محصورة بالإناث.
في العام ٢٠٠١، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برنامج رعاية صحية اختيارية لتغطية الأفراد الذين لا يمكنهم/نّ الانتساب إلى الصندوق. يُفترَض أن يغطي هذا البرنامج الاختياري أي شخص خارج العمل النظامي في القطاع الخاص، بما في ذلك العاطلين/ات عن العمل أو العاملين/ات غير النظاميين/ات. وكان التأمين الصحي الاختياري في الواقع جزءًا من القانون الأصلي عام ١٩٦٣، لكنه لم يُنفذ حتى شهر شباط/فبراير من العام ٢٠٠١ من خلال المرسوم الحكومي رقم ٧٣٥٢. أُنشئ الضمان الاختياري كصندوق منفصل من دون تأمين أي مُبادلَة أو دعم مخطط بين الصندوق الجديد والصناديق الأخرى. وبما أنه كان من المفترض أن يكون برنامجًا اختياريًا للرعاية الصحية، لم تكن استدامته المالية واضحة منذ البداية. وبحسب ما أشار إليه الجردلي وآخرون (٢٠١٤)، فإنَّ الضغوط دفعت الحكومة في ذلك الوقت إلى إقرار المرسوم ٧٣٥٢. وسرعان ما واجه البرنامج الاختياري تحديات مالية وبدأت المستشفيات في رفض المرضى المسجلين في هذا الصندوق. بعد ثلاث سنوات، فقط الأشخاص الذين كانوا مسجلين سابقًا في الفروع الإلزامية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحق لهم/نّ أن يبقوا في الفرع الاختياري (يشكلون ما يقارب ٢% من جميع الأشخاص المسجلين في الصندوق أو ما يناهز ١٠٠،٠٠٠ منتسب/ة). تبلغ الاشتراكات السنوية في الضمان الصحي الاختياري ١،٥٠٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية (١٠٠٠ دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي) على أصحاب العمل، و١،٠٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية (٧٥٠ دولارًا أمريكيًا بحسب سعر الصرف الرسمي) (منظمة العمل الدولية ٢٠٢٠، ٧؛ مركز دعم لبنان ومؤسسة البحوث والاستشارات ٢٠٢١).
في العام ٢٠١٧، تم توسيع نطاق الضمان الصحي الإلزامي ليشمل المتقاعدين/ات إذا كانوا قد سدّدوا الاشتراكات على مدى ٢٠ عامًا وبلغوا ٦٤ عامًا (سن التقاعد الرسمي). في هذه الحالات، يـ/تدفع المتقاعد/ة ٦٠ ألف ليرة لبنانية شهريًا. وفي المرسوم نفسه، رُفِعَت حصة أصحاب العمل من الضمان الصحي من ٧ إلى ٨% وحصة الموظف/ة من ٢ إلى ٣%.
٣. ۲. فرع ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية
صُمم الفرع الثاني ليكون بمثابة تأمين ضد الطوارئ/الحوادث والأمراض المتعلقة بالعمل ومكان العمل. حتى يومنا هذا، لم يوضع هذا الفرع حيز التنفيذ. ويغطي الفرع الأول حوادث العمل والأمراض (خلافًا لنصوص القانون). وفي حين أن التصميم الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاولَ أن يعكس جوانب الهشاشة في دورة الحياة، إلا أنَّ التأخيرات والثغرات في الصندوق قد أعاقت التنفيذ الفعلي لهذه البرامج بعد أكثر من ٦٠ عامًا على تأسيسه.
٣. ٣. فرع التعويضات العائلية والتعليمية
تدعم هيكلية فرع التعويضات العائلية والتعليمية الآليات التمييزية المتأصلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (بحسب التصميم والممارسة) والمتعلقة بالنوع الاجتماعي والظروف الاجتماعية-الاقتصادية. يُخصّص هذا الفرع مبلغًا شهريًا عن كل ولد للعامل وعن زوجة العامل. أما النساء فيحصلن على مخصصات عن أولادهن عندما يكون الزوج غير مسجل في الصندوق. وهذا يُعَد بمثابة اعترافٍ ضمنيّ بأن الرجل هو المعيل الأساسي في المجتمع ويجب أن يكون هو المعيل الأساسي الذي يضمن الحماية الاجتماعية للأسرة من خلال نشاطه المهني. بالتالي، يؤدي ذلك إلى تعزيز الهياكل والسلوكيات المرتبطة بالسيطرة الذكورية في المجتمع واعتماد المرأة على الرجل.
أما المخصصات التعليمية فما زالت غير مُنفَّذة حتى الساعة. تبلغ التعويضات العائلية، التي تُقدَّم بشكل أساسي من خلال العامل الرجل، ١١% من الحد الأدنى للأجور عن كل ولد. ومنذ تحديد الحد الأدنى للأجور بـ ٦٧٥،٠٠٠ ليرة لبنانية شهريًا في العام ٢٠١٢ (بموجب المرسوم ٧/٤٢٦)، أصبحت هذه التعويضات تُساوي ٧٤،٢٥٠ ليرة لبنانية عن كل ولد شهريًا. أما قيمة المخصصات عن زوجة العامل فتبلغ ٢٠% من الحد الأدنى للأجور، أي ١٣٥،٠٠٠ ليرة لبنانية شهريًا على أساس الحد الأدنى للأجور للعام ٢٠١٢. ومع الانخفاض المستمر في قيمة الليرة اللبنانية منذ العام ٢٠١٩، وبما أنَّ الحد الأدنى للأجور لم يُعدَّل (في وقت إعداد هذا التقرير)، تبلغ [1] المخصصات الشهرية اليوم أقل من ٢،٢٥ دولارًا أمريكيًا عن الزوجة و١،٢٣ دولارًا أمريكيًا عن كل ولد.[11] قبل الأزمة الحالية، وبفضل الضمان الاجتماعي من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كان العاملون/ات النظاميون/ات يُشكِّلون فئة عاملة محظوظة نسبيًا كونها مؤهلة للاستفادة من بعض التقديمات على الأقل، مثل التعويضات العائلية، في سوق عمل تُهيمن عليه الترتيبات غير النظامية. ولكنْ في ظلّ الأزمة الحالية، باتت فوائد الضمان الاجتماعي شبه معدومة، ما ساهم في تدهور الظروف الاجتماعية-الاقتصادية للطبقة العاملة بشكلٍ ملحوظ، بما في ذلك العاملون/ات النظاميون/ات الذين كانوا "محظوظين" سابقًا (سكالا ٢٠٢٢).
٣. ٤. تعويض نهاية الخدمة
إنَّ أنماط التمييز والتسلسل الهرمي المتجذّرة في أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات في لبنان تظهرُ أيضًا من خلال غياب معاشات الشيخوخة للعاملين/العاملات النظاميين/النظاميات في القطاع الخاص. تتوافر لدى العاملين/العاملات في القطاع العام معاشات التقاعد من خلال تعاونيات مختلفة (تعاونية موظفي الدولة والمعلمين/ات وموظفي/ات القطاع العام، وتعاونيات القوى العسكرية والأمنية)، بينما لا يحصل/تحصل موظفو/موظفات القطاع الخاص إلا على تعويض نهاية الخدمة: أي مبلغ مقطوع محدد يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند نهاية خدمة العامل/العاملة.
ينص قانون الضمان الاجتماعي على أن فرع تعويض نهاية الخدمة كان من المفترض أن يكون حلًا مؤقتًا إلى حين تنفيذ نظام معاشات التقاعد. ومنذ العام ٢٠٠٤، ناقش عددٌ من الحكومات مسألة تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى نظام معاشات تقاعدية. لكنَّ القانون لم يُعتمَد على الرغم من أنَّ جهات مختلفة تطرح مشروع القانون من فترة لأخرى.[12]
يُدفَع تعويض نهاية الخدمة إذا كان/ت العامل/ة مُسجَّلًا/ـةً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجموع سنين عمله/ا عشرون سنة على الأقل وذلك إذا كان عمره/عمرها يفوق الستين عامًا أو "أنه/أنها كان/كانت مصابًا/مصابة بعجز بمعدل ٥٠% على الأقل" (المرسوم رقم ١٣٩٥٥، ١٩٦٣، المادة ٥٠). كما ذُكِر سابقًا، التعويض هو مبلغ نقدي مقطوع "يعادل عن كل سنة خدمة الأجر الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشوء الحق بالتعويض" (المرسوم رقم ١٣٩٥٥، ١٩٦٣، المادة ٥١). ولتقديم مثال عملي على ذلك، إذا كان الراتب الأخير للمنتسب/ة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل التقاعد يبلغ مليون ليرة لبنانية وكان/ت قد عمل/عملت لمدة ٢٥ عامًا متتاليًا، يبلغ تعويض نهاية خدمته/خدمتها ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية (ما يقارب ١٦،٠٠٠ دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي). أشارَ أحد خبراء الحماية الاجتماعية في إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية إلى أوجه القصور المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة قائلًا: "تعويض نهاية الخدمة شبيه بحصالة نقود سيئة؛ تُوفّر/تُوفّرين بعض المال فيها وعندما تتقاعد/تتقاعدين تحصل/تحصلين عليه. لكن النقود لا تكفي لتلبية احتياجاتك في فترة التقاعد. كان من المقرر أن يكون ذلك مؤقتًا في السنوات الأولى حتى يجمع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعض المال ثم يتم تحويله إلى نظام تقاعدي عادي. لكن في لبنان، كل ما هو مؤقت يبقى إلى الأبد. لذلك حتى يومنا هذا، ما زالت تُطبق الدفعة الشاملة الواحدة."[13] ولبنان هو البلد الوحيد في المنطقة الذي لا يخصص معاشًا تقاعديًا للعاملين/للعاملات في القطاع الخاص (منظمة العمل الدولية ٢٠٢٠، ٣).
وتجدر الإشارة إلى أن تعويض نهاية الخدمة كان عرضة للانتقاد لسنوات عدة، ولا سيما انتقادات المنتسبين/ات للصندوق، لأنه لا يشكل سوى تعويض لمرة واحدة ولا يضمن الأمان الطويل الأمد والمستدام أثناء الشيخوخة. إضافةً إلى ذلك، منذ العام ٢٠١٩، يُدفع تعويض نهاية الخدمة بالليرة اللبنانية، وهو خسر حاليًا ما يُقارب ٩٠% من قيمته السابقة.
"تقاعدَ والدي منذ بضعة أشهر واستلم تعويض نهاية الخدمة. والمبلغ الإجمالي بعد ٤٤ سنة من العمل وتسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدى ٣٢ عامًا هو ٤٥٠٠٠٠٠٠ ليرة لبنانية، أي ما يعادل ١،٣٥٠ دولارًا أمريكيًا اليوم، أو راتبه الشهري تقريبًا [قبل الأزمة]. ووفقًا لسعر الصرف السابق أي ١،٥٠٠ ليرة لبنانية، كان يساوي تعويضه ٣٠،٠٠٠ دولار أمريكي تقريبًا. حاليًا، أنا أُساعد أهلي لكي يغطيا نفقاتهما."[14]
ولكن، لا بد من الإشارة إلى أن فرع تعويض نهاية الخدمة هو الفرع الوحيد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي حقق أرباحًا فعلية منذ تأسيسه. من ناحية، سمح ذلك للصندوق باستثمار جزء من أمواله في سندات الخزينة والحسابات المصرفية. ومن ناحية أخرى، سمحَ ذلك بتغطية العجز والديون في الفرعين الأول والثالث - رغم أن الدعم من فرع إلى آخر غير مسموح بموجب قانون الضمان الاجتماعي (مرهج وشهيب ٢٠٢٢).
٣. ٥. الشرذمة والنقص والتمييز والإقصاء في التغطية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ضمن الفروع الثلاثة العاملة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا تتوفّر آليات حماية دورة الحياة الأساسية. وأهمها هو غياب المخصصات التعليمية ومنحة الأمومة ومخصصات البطالة، وكذلك غياب المعاش التقاعدي. بالإضافة إلى ذلك، إنَّ عنصر إعادة التوزيع محدود جدًا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فالعاملون/العاملات الذين/اللواتي يتقاضون/يتقاضين رواتب أعلى يدفعون/يدفعن مع أصحاب عملهم/عملهن اشتراكات أعلى (من حيث القيمة وليس من حيث النسبة المئوية)، مع أن جميع المنتسبين/المنتسبات يحصلون/يحصلن على الخدمات نفسها. ومع ذلك، لا يوجد نظام قانوني لإعادة التوزيع والدعم من فرع إلى آخر، ولا أي نوع من أنواع إعادة توزيع الأموال لتغطية الفئات الهشة والمحرومة في دورات الحياة المختلفة. ومن بين الأشخاص المسجلين، يُعتبر الأطفال والنساء وكبار السن محرومين في تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - على الرغم من أنه ينبغي أن يكونوا هم الأكثر حمايةً في نظام الحماية الاجتماعية الشامل والقائم على الحقوق. وحاليًا، الأشخاص المحرومون والفقراء المسجلون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هم الأكثر حرمانًا لأنهم لا يستطيعون تحمل عبء تكاليف التأمين الخاص ولا الفرق الكبير بين معدل التغطية الحالي للصندوق (بحسب سعر الصرف القديم) والتكاليف الطبية الفعلية (بحسب سعر الصرف الحالي). ومن الواضح أن تعويض نهاية الخدمة غير عادل بالنسبة إلى مَنْ يتقاضون رواتب أدنى لأن التعويضات التي يستلمونها هي كذلك أدنى. بالتالي، هم/هنّ معرضون/معرضات لخطر الفقر في الشيخوخة – والآن أكثر من أي وقت مضى نظرًا لانخفاض قيمة المبلغ الإجمالي الذي يستلمونه/يستلمنه كتعويض. علاوةً على ذلك، ونظرًا لعدم توافر أي مخصصات للبطالة، يبقى من فقد وظيفته من دون أي شكل من أشكال التغطية، باستثناء عدد قليل من المسجلين/ات في الضمان الصحي الاختياري.
بالإضافة إلى غياب آليات إعادة التوزيع والتضامن داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتم إقصاء عدد معين من فئات العاملين/العاملات ولا تشملهم/تشملهن برامج الحماية الاجتماعية العامة. يجب أن يوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تغطيةً معينة لبعض فئات العاملين/العاملات - بموجب القانون، مثل العاملين/العاملات في قطاع الزراعة والمياومين/المياومات وعمال البناء. ورغم ذلك، لم ولن تتوفّر لهم/لهنّ هذه التغطية (شالكرافت ٢٠١٩؛ سكالا ٢٠٢٠).
أخيرًا، يُستثنى معظم الأشخاص غير اللبنانيين/غير اللبنانيات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفسه أو من الاستفادة من تغطيته. وفي حين يُستثنى/تُستثنى عاملو المنازل المهاجرون/عاملات المنازل المهاجرات من الصندوق على أساس أن وظائفهم/وظائفهن لا تندرج في قانون العمل، غير أنَّ الأجانب الذين يعملون بموجب عقد عمل "قانوني" يجب أن يُسجَّلوا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنّهم/نّ يحصلون على تغطية جزئية فقط. وتنص المادة ٩ من قانون الضمان الاجتماعي على أنه يحق للأجراء الأجانب الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا كانت الدولة التي ينتمون إليها تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي. بالتالي، لا يستفيد الأجراء الأجانب النظاميون سوى من تعويض نهاية الخدمة على الرغم من أنهم يدفعون الاشتراكات نفسها مثل المنتسبين الآخرين.
"يسمونه مبدأ المعاملة بالمثل: إذا لم تكن بلدانهم عادلة أو شاملة للبنانيين، لن يشملهم الضمان كذلك. لكن لا أحد نفذ فعليًا دراسة للتحقق من البلدان التي يستفيد/تستفيد فيها اللبنانيون/اللبنانيات من تغطية الحماية الاجتماعية، وفي الكثير من البلدان يستفيدون فعلًا من تلك التغطية. لذلك، يُستخدم [هذا المبدأ] كذريعة لإبقاء الأجانب خارج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."[15]
بشكلٍ عام، صُممت تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كنموذج شامل ومتكامل للحماية الاجتماعية للعاملين/للعاملات النظاميين/النظاميات في القطاع الخاص. وعلى الرغم من أن بعض المكونات كانت مفقودة أو غير مكتملة، إلا أنَّ الفكرة الأولية كانت تتمثل في تطوير العناصر الحالية تدريجيًا حتى يتمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تقديم نموذج تغطية شامل. ولكن، حتى يومنا هذا، أي بعد ٦٠ عامًا على تأسيس الصندوق، ما زالت التغطية التي يوفرها الصندوق مُشرذمة وإقصائية وبعيدة كل البعد عن مبدأ التغطية الشاملة والمتكاملة. وعمليًا، لا يغطي الصندوق سوى أقلية من العاملين/العاملات في لبنان، ما يترك كل ما يُسمى بالقطاع "غير النظامي" من دون أي ضمان اجتماعي. وتعكس أنماط الشرذمة والإقصاء والتمييز في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتُعزِّز أيضًا، التسلسلات الهرمية الاجتماعية المتجذرة وأنماط التمييز المتقاطع في المجتمع اللبناني (سكالا ٢٠٢٢).
4. التدخل السياسي ونقص التمويل والإفلاس: تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
على الرغم من عدم وجود أي صورة واضحة عن الوضع المالي الفعلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهناك إجماع عام على أنه باتَ على شفير الإفلاس (زغيب وصغير. ٢٠٢٢). وبحسب ما ذكر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في تموز/يوليو ٢٠٢٢، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "بأسوأ أيامه"[16]. من ناحية، خسرت معظم استثمارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جزءًا كبيرًا من قيمتها بسبب تدهور الليرة. ومن ناحية أخرى، لا يمكن استرداد أموال الصندوق الحالية من المصارف التي تُنفذ آليات مراقبة رأس المال غير الرسمية ("الكابيتال كونترول") منذ بداية الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، يستمر الصندوق في تحصيل اشتراكاته بالليرة اللبنانية، بحسب سعر الصرف الرسمي البالغ ١ دولار أمريكي = ١٥٠٧ ليرة اللبنانية. لذلك، لا يزال يُوثّق تعويضاته وتسديداته بحسب سعر الصرف الرسمي، ولا يُعدِّل قيمة تغطيته لتتوافق مع التضخم الحالي. ومن أجل فهم الأزمة المالية الحالية التي يشهدها الصندوق، يتعين علينا أن نرى أبعد من التأثير المباشر للتطورات الاقتصادية الأخيرة في البلد، ولا بد من تحليل التجاذبات السياسية في الإدارة المالية للصندوق. لذلك، يدرس هذا القسم قيود نموذج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتدخلات السياسية في إدارته.
٤. ۱. التبعية (الاستقلالية) المالية والتضامن المفقود: نظام الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
منذ إطلاقه، صُمم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كبرنامج مُموَّل من خلال الاشتراكات، ومن المفترض أن يُموِّل نفسه بشكل ذاتي وأن يحافظ على الاستقلال المالي. لكنه كان يفتقر إلى مبدأ التضامن والمعاملة بالمثل بين الأجيال والفئات السكانية. وعلى مر السنين، أدى ذلك إلى استحالة تحقيق الاستدامة الذاتية وتعزيز التدخلات السياسية المختلفة التي أعاقت تدريجيًا الاستقلال المالي للصندوق. وبشكل عام، شكّلت التحديات المالية الهيكلية في تصميم الصندوق أرضيةً خصبة للتدخلات السياسية، ما سَبَّبَ نقصًا هيكليًا في التمويل وأدّى في نهاية المطاف إلى الإفلاس.
بحسب تصميمه، كان ينبغي تحقيق الاستقلال المالي للصندوق من خلال اشتراكات المنتسبين/المنتسبات. فأصحاب العمل والموظفون/الموظفات يدفعون/يدفعن الاشتراكات العادية، وتُحسب هذه الأخيرة على أساس نسبة مئوية من الراتب الشهري للموظف/الموظفة. ويُعتبَر دفع هذه المستحقات بمثابة شرط لتمكين العامل/العاملة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق. في وقت تأسيسه، كانت الاشتراكات تُحتسب بنسبة ٣٨،٥% من الراتب الشهري لكل موظف/موظفة. لكن، في شهر كانون الثاني/يناير من العام ٢٠٠١، مارست حكومة رفيق الحريري، التي تم تشكيلها آنذاك، ضغوطًا عدّة على الصندوق بهدف خفض الاشتراكات إلى ٢٤،٥%، وذلك في سياق المساعي الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص. وفي العام ٢٠١٧، عُدلت النسبة مرة أخرى بعد توسيع نطاق الضمان الصحي ليشمل المنتسبين/ات المتقاعدين/ت. تمّت زيادة حصة أصحاب العمل والموظفين/الموظفات بنسبة ١%. ومن مجموع الاشتراكات التي تبلغ ٢٥،٥%، يدفع صاحب العمل ٢٢،٥% ويدفع الموظف/الموظفة ٣%. ومن بين هذه النسب، تُخصص نسبة ۱۱% (أي ٣% من حصة الموظف/الموظفة و٨% من حصة صاحب العمل) لفرع المرض والأمومة، و٦% (من حصة صاحب العمل) لفرع التعويضات العائلية والتعليمية، و٨،٥% (من حصة صاحب العمل) لتعويض نهاية الخدمة. ومقارنةً بالبلدان الأخرى في المنطقة وفي أوروبا، يحتل لبنان مركزًا وسطيًا لناحية الحصص الموزعة بحسب النسب المئوية.
لطالما كانت الاشتراكات محط نزاع على مر السنين. حاولَ ممثلو الدولة وأصحاب العمل خفض الحصة المتوجّبة على صاحب العمل في حين عارض ممثلو العمال طلبهم زاعمين أن التخفيض سيزيد من تفاقم المشاكل المالية التي يعاني منها الصندوق. ومنذ تخفيض الاشتراكات في العام ٢٠٠١، أصبح الوضع المالي للصندوق غير مستقرّ. وفي فرع ضمان المرض والأمومة وفرع التعويضات العائلية والتعليمية تحديدًا، كانَ هناك رصيدٌ سلبي منذ العام ٢٠٠١. وفي العام ٢٠١٨، بلغ العجز في فرع ضمان المرض والأمومة ١،٣٧٨ مليار دولار أمريكي (مرهج وشهيب ٢٠٢٢). وفي العام نفسه، حقق فرع التعويضات العائلية والتعليمية ربحًا قدره ٣٤ مليون دولار أمريكي، إلا أن العجز فيه تراكم وبلغ ١٥٠ مليون دولار أمريكي خلال السنوات السابقة (بيزنيس نيوز ٢٠١٨). ويُعمَل على تعويض العجز في الفرعين بانتظام بواسطة الفائض في فرع تعويض نهاية الخدمة - وهو شبه فائض لأنه يحوي احتياطيات تعود للأشخاص الذين يتوقعون استلام تعويضهم في مرحلةٍ ما. علاوةً على ذلك، إنَّ تحويل الأموال بين الفروع هي مسألة لا تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي إذ من المفترض أن تكون فروعه مستقلة ماليًا وذاتية الاكتفاء. ومع ذلك، تُنفذ هذه الممارسة على أساس سنوي.
باختصار، إن النظام المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات غير فعال، كما أن استقلالية الصندوق باتت على المحكّ. ويُسهِم عاملان مهمان آخران في عدم الاستقرار المالي للصندوق. أولًا، لم تدفع الدولة اللبنانية حصتها البالغة ٢٥% للصحة والأمومة منذ نهاية الحرب الأهلية. بالتالي، تدين الدولة بما يناهز ٥٠٠٠ مليار ليرة لبنانية (أي ٣ مليارات دولار أمريكي تقريبًا بحسب سعر الصرف الرسمي) للصندوق. وفي موازنة العام ٢٠٢٢، المادة ١٢٤، وعدت الحكومة بشكل غير واضح بسداد الديون المتراكمة حتى نهاية العام ٢٠٢١ على فترة ١٠ سنوات. وكان يتوجب دفع هذا المبلغ في شهر أيلول/سبتمبر من العام ٢٠٢٢. ولكن، لم تحدد الحكومة المبلغ الذي يتعين سداده (الجمهورية اللبنانية، وزارة المالية ٢٠٢٢). رفض مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد الكركي بشكل مباشر المادة ١٢٤ من الموازنة المقترحة وطالب بـ "مجموعة من التعديلات الأساسية [للقانون] التي تحمي الأموال والمضمونين/المضمونات" (صوت بيروت انترناشيونال ٢٠٢٢). إضافةً إلى ذلك، في شهر شباط/فبراير من العام ٢٠٢٢، انتشرت الشائعات حول حذف المادة ١٢٤ بذريعة القانون الشامل الجديد للحماية الاجتماعية ونظام التقاعد الذي تجري مناقشته منذ العام ٢٠٠٥ من دون أي تنفيذ أو تحقيق على أرض الواقع (بعلبكي ٢٠٢٢). وإذا حُذفت أو لم تُحذف، يبقى احتمال سداد مستحقات الدولة شبه معدوم في ظل الظروف السياسية الحالية. وكما هو موضح في التقييم المالي للإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية الذي أجراه معهد باسل فليحان في العام ٢٠٢٠، هناك تباين على مدار عام كامل بين النفقات المدرجة في الموازنة والنفقات الفعلية. ويرجع سبب ذلك، من بين أمور أخرى، إلى عدم سداد الحكومة لمستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (معهد باسل فليحان ٢٠٢١، ٩٢). وهذا يدل، من جهة، على أن تحقيق الاستقلال المالي للصندوق من خلال نظام قائم على الاشتراكات شكَّلَ رؤيةً غير واقعية منذ البداية. ومن ناحية أخرى، يكشف ذلك كيف أن القرارات ضمن الصندوق، وكذلك من جانب الحكومات، منعت الاستقرار المالي للصندوق واستدامته.
بالإضافة إلى ذلك، تُعد آليات الرقابة النادرة على اشتراكات أصحاب العمل بمثابة عامل مهم يُساهِم في نقص تمويل الصندوق. فمن الشائع أن يتمّ التصريح عن رواتب أدنى من الرواتب الفعلية لتجنب دفع اشتراكات عالية. وكما أظهر عملنا الميداني، غالبًا ما يُطلب من الموظفين/الموظفات توقيع عقدين، أحدهما بالراتب الفعلي والآخر براتب مزيف منخفض يُسجَّل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من ناحية، لا يمكن للصندوق أن يتأكد من دقة البيانات التي يقدمها أصحاب العمل، ولا سيما بسبب النقص الهائل في الموظفين/الموظفات. ومن ناحية أخرى، لا يوجد أي تبادل للبيانات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة المالية التي تحتفظ أيضًا بمعلوماتٍ حول الرواتب[2] . لذلك، لا يمكن تنفيذ أي آلية تثليث للتأكد من التزام أصحاب العمل بقانونَيْ الضمان الاجتماعي والعمل. بالإضافة إلى ذلك، لم تسدد شركات عدة اشتراكاتها لسنوات على الرغم من أن موظفيها/موظفاتها مسجلون/مسجلات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي تتفق مع الصندوق على سداد جزء من اشتراكاتها المستحقة فقط[17].
٤. ۲. تمويل ديون الدولة: استثمارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
من أجل فهم الأزمة الحالية المتعددة الأوجه التي يعانيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من المهمّ أيضًا أن ننظر إلى الآلية الإدارية (المالية) للصندوق ذات التوجه السياسي. وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، يُسمح للمؤسسة بالاستثمار في أربعة أنواع من النماذج: سندات الخزينة والعقارات غير المنقولة والقروض للهيئات العامة والمؤسسات العامة، وقروض الإسكان لموظفي/ات الخدمة المدنية والأشخاص المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مرهج وشهيب ٢٠٢٢)، على أن تُنفذ كلّ هذه الاستثمارات بالعملة المحلية، أي الليرة اللبنانية. ومنذ أواخر الثمانينيات، استثمر الصندوق جزءًا من أصول تعويضات نهاية الخدمة في سندات الخزينة، وهي ممارسة شائعة نسبيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن، تجدر الإشارة إلى أنه على خلاف بلدان الشرق الأوسط الأخرى، كان لبنان آنذاك في خضمّ حربه الأهلية (١٩٧٥-١٩٩٠). لذلك، كانَ خيار الاستثمار في سندات الخزينة اللبنانية ينطوي على مخاطر عالية. ومع ارتفاع الدين العام للدولة اللبنانية منذ أوائل التسعينيات حتى اليوم، كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمول لسنوات عدة ديون الحكومات، وبالتالي كان يُعزِّز الاقتصاد الريعي غير الفعال في لبنان بعد الحرب الأهلية. وفي العام ٢٠١١، ساهمت صناديق الضمان الاجتماعي بمبلغ ٥ مليار دولار أمريكي، حيث استُثمر ٧٠% في سندات الخزينة والباقي في حسابات مصرفية مجمدة في لبنان. وبحسب التقرير الصادر مؤخرًا عبر منصة "مصدر عام"/“Public Source”، طرحت اللجنة المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مجلس الإدارة في العام ٢٠٠٥ سبعة اقتراحات حول كيفية تنويع إمكانيات الاستثمار في الصندوق، بما في ذلك إمكانية الاستثمار في سندات اليوروبوند، أي العملات الأجنبية. وبحسب التقرير، رفض مجلس الإدارة هذا الاقتراح و"توقف عن تعيين اللجنة المالية" في نهاية المطاف (مرهج وشهيب ٢٠٢٢). وكانَ هذا الخيار مدفوعًا بأجندات سياسية، ما أكد الافتقار إلى الاستقلالية في صنع القرار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الأقل في ما يتعلق بالاستثمارات التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الصندوق. ويتوافر الدليل على ذلك في تصريحات المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد الكركي، في العام ٢٠٢١، الذي اشتكى من عدم تنويع الأموال وألقى اللوم على الحكومة في تقاعسها عن السماح للصندوق بالاستثمار في عملات أخرى: "لم يكن هناك موافقة سياسية في السنوات الإحدى عشرة التي كنت أدير فيها الصندوق لتنويع [الاستثمارات] في عملات أخرى، إذ يتعين علينا الاستثمار بالليرة اللبنانية فقط (...). الاستثمار في العملات الأخرى هو أقل ما يمكن أن نتوقعه لأن الصندوق يسدد كل الاشتراكات بالليرة اللبنانية، لكن التكاليف الطبية بالعملات الأجنبية "(مجلة إكزيكيوتيف ٢٠١٢).
٤. ٣. "أسوأ أيامه" - الوضع المالي الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
"هناك مشكلة تتعلق بالتمويل حاليًا، والحلول مفقودة. فنحن لا نعرف ماذا حدث لأصول الضمان الاجتماعي. التساؤلات كثيرة: ما هو الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ ما هي إمكانياته للاستمرار؟ ماذا حل بالمال الذي سدده المضمونون/المضمونات لسنوات أو عقود؟ لا يمكنهم/يمكنهن أن يخسروا/يخسرن كل الأموال التي دفعوها/دفعنها. لذلك، مسألة التمويل تُمثِّل تحديًا كبيرًا في جميع مسائل الحماية الاجتماعية."[18]
"الضمان الاجتماعي اليوم بأسوأ أيامه." (وزير العمل مصطفى بيرم، نقلًا عن المركزية ٢٠٢٢).
اليوم، تبدو عواقب هذا الركود وسوء الإدارة المالية المستمرَّيْن منذ عقود عدة واضحةً تمامًا. فبسبب الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان منذ العام ٢٠١٩، وما تلاها من تدهور في قيمة العملة المحلية، خسر الصندوق جزءًا كبيرًا من احتياطه. بالإضافة إلى ذلك، جُمدت الأموال المستثمرة في سندات الخزينة بسبب إجراءات الرقابة غير الرسمية على رؤوس الأموال ("الكابيتال كونترول") التي تنفذها المصارف.[19] وبما أنَّ الودائع تأتي حصريًا من "فرع تعويض نهاية الخدمة"، فهي تتكون أساسًا من الأموال - والفائدة على هذه الأموال - التي يدفعها أصحاب العمل اللبنانيون: أي مبلغ يعود قانونًا للمسجلين/المسجلات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند تقاعدهم/تقاعدهن. وإذا حُظرت هذه الأموال، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف ستُدفع تعويضات نهاية الخدمة على المدى البعيد؟ أما الآن، فالأشخاص يقبضون تعويضات نهاية الخدمة على أقساط مختلفة، ولكن بسبب سعر الصرف المطبق (أي الرسمي)، فإن هذه المبالغ باتت ضئيلة. علاوةً على ذلك، في الوضع الحالي، لا يمكن تحديد المدة التي سيتمكن فيها الصندوق من ضمان صرف تعويضات نهاية الخدمة للمنتسبين/للمنتسبات. وبما أن هذه الأموال تُستخدم لتمويل "فرع ضمان المرض والأمومة" وكذلك "فرع التعويضات العائلية والتعليمية"، تُطرَح تساؤلات كثيرة أيضًا حول قدرة الصندوق على الاستمرار في تسديد خدمات هذين الفرعين.
وصفَ لنا أحد مُحاورينا أكبر ثلاث معضلات مالية يواجهها الصندوق في الوقت الراهن، وهي التالية: انخفاض قيمة العملة، والاحتياطيات المحجوزة، وديون الحكومة غير المسددة:
"منذ فترة وجيزة، أخبرني مدير الشؤون المالية [في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي] أنَّ كل تعويض نهاية خدمة يتجاوز الـ۲٠ مليونًا لن يُدفع. وسيبقى [مبلغ التعويض] في المصرف الذي سيمنحه للشخص على دفعات مختلفة على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام. وهذا اتفاق [غير رسمي] بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصارف. تتوافر الأموال في [حسابات] الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنها محظورة. علاوةً على ذلك، لا تدفع الحكومة المستحقات المتوجبة عليها للصندوق. والأمر نفسه ينطبق على المستشفيات: كل أول يوم من الشهر، يُحوِّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغًا مسبقًا. ويجري تقييم هذا المبلغ لكل مستشفى على أساس القدرة الاستيعابية لكل مستشفى، إلخ. ويحاول المستشفى الوصول إلى الأموال المحولة إلى حسابه، لكن المصارف لا تسمح له بسحب الأموال بسبب ضوابط رؤوس الأموال [غير الرسمية]. بالتالي، إذا كنتَ مؤمّنًا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودخلتَ المستشفى، يطلب منك المستشفى تسديد ٩٠% من الفاتورة لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يزال يدفع بحسب سعر الصرف ١ دولار أمريكي = ١٥٠٧ ليرة لبنانية. كذلك، لا يعرف المستشفى على الإطلاق متى سيحصل من المصرف على حصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغة ١٠%."[20]
ورغم العديد من هذه التصريحات الحتمية الكثيرة من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخارجه على مر السنين، فإن الوضع المالي الفعلي للصندوق ليس واضحًا على الإطلاق: "أُجرِيَت آخر مراجعة خارجية لحسابات الصندوق في العام ٢٠١٠. ومنذ ذلك الحين، لم تُجرَ أي مراجعة أخرى. ولكن، أكثر من ذلك، حتى داخليًا، ليس لديهم أدنى فكرة عن وضعهم، ويقولون ذلك بكل صراحة: "ليس لدينا أي بيانات مالية ولا نعرف إلى متى يمكننا الاستمرار". إضافةً إلى ذلك، وفي سياق إعادة هيكلة المصارف، ما مصير أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ هل سيُقِرّون بأن هذه الأموال هي مدخرات الناس، وبأن هذه الأصول مخصصة للحماية الاجتماعية؟".[21] مع مثل هذه الصورة التي يلفها الغموض، تبدو أي فكرة بشأن إصلاح أو إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام التغطية والاشتراكات فيه، فكرة صعبة إن لم تكن مستحيلة.
وبما أن الصندوق لا يزال يسدد بحسب سعر الصرف ١٥٠٧ ليرة لبنانية = ١ دولار أمريكي، فإن تغطيته لم تعد قائمة فعليًا: "منذ سنوات، انتسبْتُ إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال شركة أختي. وفي كل مرة كنت بحاجة إلى الخضوع لفحوصات طبية أو ما شابه، كنت أذهب إلى الصندوق وأقدم لهم الإيصالات. حسنًا، كانوا يتأخرون أحيانًا في إعادة المبلغ، ولكن في نهاية المطاف كنا نسترد مبلغًا ما، وكان الأمر يستحق العناء. قبل شهرين، اضطررت إلى إجراء فحص دم شامل، وبلغت الكلفة ٦٠٠ ألف ليرة لبنانية. كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليُعيد لي منها ١٩٠٠٠ ليرة لبنانية. تخيل! ١٩٠٠٠! ماذا فعلت؟ دفعت المبلغ كاملًا ومزقت الإيصالات."[22] ويـ/تـقول مُحاورٌ/ةٌ آخر/أخرى – وهو/هي موظف/ة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -: "على ما يبدو، كان محمد الكركي يطلب من الحكومة أن تقبض الاشتراكات بحسب سعر الصرف ٣٩٠٠ ليرة لبنانية، وبالتالي يُسدَّد المبلغ بسعر الصرف نفسه. لكن الموقف هو موقف ضعف؛ كان ذلك في تموز/يوليو ٢٠٢٠، وانظر أين أصبحنا الآن. يتم التداول بالليرة اللبنانية بسعر الصرف ٢٩٠٠٠، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يزال يعتمد سعر الصرف ١٥٠٠. قبل أيام، كنت أريد الحصول على موافقة لدخول المستشفى، لشخصٍ أعرفه، وتوجهت إلى مكتب الضمان في بئر حسن. في العادة، كنتَ ترى طابورًا طويلًا من الناس الذين ينتظرون دورهم. أما ذلك اليوم، فلم يكن هناك سوى شخصين. لم يعُد أحد يُعوِّل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…"[23]
وما يفضي إليه هذا التصريح هو السؤال المحوري المطروح في هذا التقرير: ما هي المحاولات التي أُجرِيَت في السابق وتلك التي تُجرى حاليًا لإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ ما هو نوع الإصلاح الضروري بهدف التخفيف من حدة الأزمة الراهنة التي يواجهها الصندوق وكذلك إصلاح مشكلاته المتجذرة في سوء الإدارة، والثغرات في الحوكمة، والتأثير السياسي، وأنماط الإقصاء والشرذمة والتمييز؟ وما هي الخيارات والمسارات الواقعية لمثل هذا الإصلاح (أو هذه الإصلاحات)؟
٥. الإصلاح المُحتمَل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
"إذا أعدنا النظر في الاحتياجات والثغرات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، نلاحظ أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونيات القطاع العام هما، إلى حد بعيد - ورغم كل هذه القيود – أكبر مُساهمَين في الحد من الفقر في هذا البلد."[24]
"أرى أن السياسيين لا يريدون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد الآن. يريدون خصخصته ليصبح أشبه بشركة تأمين."[25]
إنَّ التقييم المُقدم حتى تاريخه يُبين بشكل واضح أهمية فهم أوجه القصور في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعادة إدراجها في تحليلٍ طويل الأمد يأخذ في الاعتبار المسائل الهيكلية الإدارية والمالية، فضلًا عن التجاذبات السياسية. ولكن، في ظلّ تفاقم العيوب وأوجه القصور في الصندوق خلال الأزمة الراهنة - وأكثر من أي وقت مضى – لا بد من إصلاحه بصورة عاجلة وطارئة. واللافت أنه يمكن استخلاص خطاب متباين من الدراسات المتوفرة وآراء الأشخاص الذين أُجرِيَت معهم/نّ المقابلات حول إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من جهة، تُشير الدراسات الحديثة (شهيب ومرهج ٢٠٢٢؛ داغر وزغيب ٢٠٢٢)، وكذلك الأشخاص الذين حاورناهم/نّ، إلى تقييمٍ حتميّ. وهناك عبارة نموذجية سمعناها مرارًا خلال دراستنا وهي التالية:
"على غرار البلد بأكمله، انتهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما من طريقة لإنقاذه، فإنَّهم (السياسيون) سرقوه منا مثلما سرقوا كل شيء آخر."
من جهة أخرى، يُعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمثابة نقطة الانطلاق الوحيدة الممكنة لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في لبنان. يُجمِع/تجمع المنتسبون/المنتسبات إلى الصندوق والموظفون/الموظفات فيه، بالإضافة إلى الخبراء/الخبيرات وصانعي/صانعات السياسات الذين/اللواتي قابلناهم/قابلناهن، على الدور الذي كان الصندوق يؤدّيه قبل الأزمة، على الرغم من أوجه القصور المتعددة فيه: "كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - على الرغم من مشاكله - مؤسسة جديرة بالثقة، كما كان أحد المكونات الهامة في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان – صحيح أنه كان يتضمّن بعض الثغرات في نظامٍ متزعزع أيضًا، لكنه كان محل ثقة بجوانبه الفاعلة".[26] وهم يعتبرون أن أي إصلاح عاجل لنظام الحماية الاجتماعية لا بد من أن يبدأ بإعادة هيكلة المؤسسات القائمة. وهذا ما أشار إليه أحد مُحاورينا قائلًا: "لا يمكن التفكير في إصلاح الحماية الاجتماعية في البلد من دون البدء بالمؤسسات القائمة أصلًا مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولا يمكن أن نمتنع عن القيام بهذا الإصلاح - خصوصًا في ظل الأزمة الراهنة – لكن الإصلاح يحتاج إلى إرادة سياسية من الحكومة".[27]
ومثلما سبقت الإشارة، فإن مسألة إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليست بمسألة جديدة. ولكن، ما هو الجديد بالفعل هو الضرورة الملحة لمثل هذا الإصلاح. يتطرق القسم التالي إلى هذه المحاولات.
٥. ۱. "السُبُل متاحة، لكنَّ الإرادة غائبة" - محاولات الحكومات لإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، تقدمت الحكومة اللبنانية بـ "طلبها للحصول على دعم دولي" في مؤتمر باريس II الذي يهدف إلى جمع المساعدات النقدية الدولية. ودعمًا لطلبها، أشادت الحكومة بقرارها الأخير بخفض اشتراك صاحب العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ٣٨،٥ % إلى ٢٣،٥% باعتباره إنجازًا كبيرًا "لتعزيز الاستثمارات الخاصة" و"جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية" (الجمهورية اللبنانية ٢٠٠٢، ٢٠). وفي المؤتمر التالي، أي مؤتمر "باريس III" الذي عُقِد في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧، اعتمدت الحكومة نبرة مختلفة في ما يتعلق بموضوع الحماية الاجتماعية، وربطت مُطالبتها بالمساعدات الأجنبية بوعود غامضة بالإصلاح في القطاع الاجتماعي "لحماية الفئات الأكثر هشاشةً من السكان." (أبي راشد ٢٠٠٨). وتضمنت هذه الوعود وعدًا طال انتظاره بتحويل تعويض نهاية الخدمة الذي يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى برنامج معاشات تقاعدية - على النحو المحدد في قانون الضمان الاجتماعي الصادر في العام ١٩٦٣.
كانت الصيغة النهائية لمسودة مشروع القانون الخاص بهذا الإصلاح قد وُضِعَت بالفعل في العام ٢٠٠٤، بعد أن شكَّلَ مكتب رئيس الوزراء رفيق الحريري لجنة خاصة لصياغته قبل ذلك بعامين. وفي العام ٢٠٠٤، طُلب من البنك الدولي دراسة مشروع القانون وتقديم توصياته بالتعديلات الممكنة عليه، قبل أن يعتمده مجلس النواب اللبناني. وأسفرت توصيات البنك الدولي عن خلافات سياسية داخل البرلمان. وفي نهاية المطاف، وُضِع مشروع القانون في الأدراج لسنواتٍ عدة. وفي العام ٢٠٠٨، أي بعد مرور عام واحد على مؤتمر باريس III، أعاد البرلمان طرح مشروع القانون على طاولة المفاوضات، وأحاله مرة أخرى إلى لجانه النيابية المختلفة. كذلك، تم تشكيل لجنة خاصة أخرى برئاسة النائب نقولا نحاس، غير أنه لم يتبع ذلك أي إجراءات حكومية أخرى. وفي العام ٢٠١٠، حاولت وزارة العمل إعادة مشروع القانون إلى المناقشة، وأطلقت جولة جديدة من جولات مراجعة مشروع القانون في لجان نيابية مختلفة. مرة أخرى، لم يُنفذ أي إصلاح يُذكر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعد مرور عشر سنوات، أي في العام ٢٠٢٠، أكد النائب نقولا نحاس أن مشروع القانون أصبح في مراحله الأخيرة وأنه "واثق تمامًا" من أن المراجعة "ستبلغ مرحلة متقدمة جدًا في القريب العاجل"، ما يُتيح "البت في هذا القانون" (اللواء ٢٠٢٠). وبعد ذلك بعامين، ضمن مقابلاتنا الخاصة بهذا التقرير (في نيسان/أبريل ٢٠٢٢)، أكد لنا خبراء خارجيون يدعمون اللجنة النيابية التي عيّنها نقولا نحاس أنَّ القانون أصبح في مراحله الأخيرة. وأوضحوا أن مشروع القانون يتضمن، بالإضافة إلى نظام المعاشات التقاعدية، تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة فضلًا عن تعيين مدير الاستثمارات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – على أن يكون مستقلًا عن المدير العام: "إذًا، يوم أمس، عقدنا الاجتماع الأخير مع رئيس اللجنة في البرلمان الذي كان يعمل مدفوعًا بالكثير من دعمنا، والذي وضع نصًا جديدًا للقانون من شأنه أن يؤسس نظامًا جديدًا للمعاشات التقاعدية. ونحن نرى أن هذا الأمر بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لأن نظام تعويض نهاية الخدمة غير فعال على الإطلاق. فالناس، في الواقع، يتقاعدون من دون أن يقبضوا أي فلس. (...) لذلك، ستنتهي هذه اللجنة النيابية من عملها في الأسبوع المقبل وتكون قد وضعَت مشروعَ قانونٍ متكاملٍ. ثم، يُعرض على لجان مختلفة، قبل أن يطرح على البرلمان لإقراره. ولكن، ما حدث في الأشهر القليلة الماضية هو أنه جرى الكثير من النقاشات بين المجموعات الحاكمة المختلفة للتوصل إلى نوع من التوافق على هذا الإصلاح، وبالتالي من الممكن أن تُعطى له الأولوية مع البرلمان الجديد."[28] في تموز/يوليو ٢٠٢٢، بعد مرور شهرين على الانتخابات النيابية، لم يكن مشروع القانون قد أُدرِجَ بعد على جدول أعمال مجلس النواب. ولدى سؤالهم عن إمكانية اعتماد القانون، أعرب الكثير من مُحاورينا عن شكوكهم في الأمر، ليس لأن القانون بقي على "الأجندة السياسية" طوال ١٨ عامًا فحسب، إنما لأنه يتناول ويعالج جانبًا واحدًا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون توفير استراتيجية شاملة لإصلاح الحماية الاجتماعية: "لا نزال نراوح مكاننا. فنحن نفكر في التفاصيل ومن ثم نصلح ما تيسر من هذه التفاصيل وما تيسر من تفاصيل أخرى. ولكن، ما من استراتيجية شاملة للإصلاح. برأيي، إما أن نعمل على استراتيجية كاملة لسياسة الحماية الاجتماعية أو ننسى المسألة بكاملها. ولكن، مع هذا القانون المطروح للنقاش [معاش التقاعد]، ستضيف الحكومة بعض التقديمات للعاملين/ات في القطاع الخاص. ثمّ سيُطالب/تطالب موظفو/موظفات القطاع العام بزيادة معاشاتهم/معاشاتهن التقاعدية، فيتعين تلبية مطالبهم/مطالبهن أيضًا. ثمّ يأتي الأشخاص غير المشمولين بأي حماية اجتماعية على الإطلاق ويُطالِبون بحقّهم/نّ أيضًا، لكن الحكومة غير قادرة على إدراجهم/نّ ضمن التقديمات. المشكلة ليست في القانون، بل في طريقة التفكير. نحن بحاجة إلى التفكير في نظام شامل للحماية الاجتماعية"[29].
بالإضافة إلى ذلك، تؤدي المنافسة السياسية إلى عرقلة أي محاولات لإصلاح بعض مكونات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. منذ فترة وجيزة، اقترح وزير العمل الحالي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ما يعتبره بعض مُحاورينا بمثابة خطة إصلاح "شجاعة" لتغيير تركيبة مجلس الإدارة الحالي. غير أن اقتراحه سرعان ما قُوبل بالرفض.
٥. ۲. "الحماية الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان" - الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في لبنان
"يُعتبر المأزق السياسي الحالي في البلد واحدًا من أهم التحديات. ومعه تأتي الثقة المفقودة في الدولة التي تشكل هي أيضًا تحديًا كبيرًا. لا تزال جميع المناقشات بشأن الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأمد مُعلَّقة منذ سنوات. لذلك، نحن نكتفي بحلول قصيرة الأمد وغير مستدامة مثل البرامج المخصصة لفئات محددة. هذه هي المعضلة الأساسية: بسبب كلّ هذه الإخفاقات على مستوى الاستراتيجيات الطويلة المدى، بدأنا نتجاهل الدولة ودورها، ونميل إلى الاعتماد على الجهات الأخرى كمانحين خارجيين. لكن السؤال الأساسي هو التالي: كيف يمكننا الاستمرار في الاعتماد على المؤسسات العامة، حتى لو كانت لدينا مشكلة مع السياسيين؟ [في هذا السياق] كيف يمكننا وضع استراتيجية على المدى البعيد؟"[30]
إنَّ وصف أوجه القصور الهيكلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يُثبت عدم قدرته على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المنتسبين/المنتسبات إليه فحسب. فهو يقدم كذلك تأكيدًا على الفكرة الرئيسية التي يطرحها هذا التقرير: يجب أن يُدمج أي إصلاح للصندوق ضمن عملية إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية في البلد. بالإضافة إلى ذلك، ولكي يكون إصلاح نظام الحماية الاجتماعية فعالًا وعادلًا على المستوى الاجتماعي، يجب أن يُبنى على نهج الحماية الاجتماعية الشامل والقائم على الحقوق.
تُعتبر الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي وُضِعَت مؤخرًا، وهي نتاج تعاون وتشارُك طوال سنوات، وتضمنت وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع عدد من الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية، أحدث وأبرز الجهود المبذولة في هذا الصدد. وفي ٢٢ أيار/مايو ٢٠٢٢، ناقش مجلس الوزراء المُعَين هذه الاستراتيجية وقرر، من حيث المبدأ، تنفيذها، إنما مع بعض التعديلات (محضر اجتماع مجلس الوزراء ٢٠٢٢).
الهدف من الاستراتيجية هو تطوير "إطار قانوني وسياساتي للحماية الاجتماعية، محدد وشامل على الصعيد الوطني، ويعترف بالحماية الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان". ويشمل هذا الإطار المكونات المختلفة التي تندرج في خانة الحماية الاجتماعية، أي التأمين الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، والوصول إلى الخدمات الاجتماعية وتفعيل سوق العمل (الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية - كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢). وُضِعَت اللمسات الأخيرة على مسودة هذه الاستراتيجية في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ وتم الاطلاع عليها في إطار إعداد هذا التقرير.
ضمن هذا الاقتراح السياساتي، يُنظر إلى إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كجزء من استراتيجية أوسع نطاقًا نحو تطوير عقد اجتماعي جديد بين المواطنين/ات اللبنانيين/ات والدولة اللبنانية. وتأخذ الاستراتيجية في الاعتبار الثغرات والتحديات التي يواجهها الصندوق، وتقترح إصلاحات هادفة في الإدارة والحوكمة وآليات التغطية وتمويل الصندوق.
تقترح الاستراتيجية النقاطَ التالية:
- توسيع نطاق الضمان الاجتماعي الإلزامي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين/ات، من دون استثناء، بما في ذلك العاملين/العاملات غير النظاميين/غير النظاميات والمهاجرين/المهاجرات الذين/اللواتي لا يشملهم/لا يشملهن حاليًا أي برنامج تأمين اجتماعي إلزامي في البلد.
- تطبيق آليات الحماية على مدى دورة الحياة، ومعظمها مُدرَجة في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر في العام ١٩٦٣، لكنها لم تُنَفذ على الإطلاق. ويتضمن هذا الاقتراح السياساتي، على وجه التحديد، إنشاء برنامج للمعاشات التقاعدية، وإعادة النظر في برنامج المخصصات العائلية، وإنشاء صندوق للإصابات المرتبطة بالعمل، وصندوق للتأمين ضد البطالة، بالإضافة إلى تقديمات المرض والأمومة والعجز.
- إنشاء تأمين صحي اجتماعي شامل هدفُه تغطية جميع المقيمين/ات في البلد، ولا يكون محصورًا بالعاملين/ات وعائلاتهم/نّ.
- تعزيز التنسيق المؤسسي بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة العمل ووزارة المالية.
- إصلاح الهيكل الإداري وأجهزة صنع القرار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ والجدير بالذكر أن الاستراتيجية تعتزم الحفاظ على التمثيل الثلاثي، إنما تهدف إلى ترشيد عملية صنع القرار. علاوةً على ذلك، سيتم تقليص حجم مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن يشمل خبراء وممثلين عن جميع الجهات المعنية. ويجب تحسين الشفافية وتبادل المعلومات والتقارير المالية، بالإضافة إلى أن مبدأ اللامركزية يجب أن يُطبَّق في عملية صنع القرار وفي الآلية التنفيذية من خلال نقل هذه الصلاحيات إلى المكاتب الإقليمية.
- تعزيز القدرة المؤسسية لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويلها، بما في ذلك اللامركزية والمكننة.
- وضع خطة جديدة للاستثمار.
تُوفر الاستراتيجية أيضًا خيارات مختلفة للسياسات الممكنة، وتحديدًا لناحية التمويل والحوكمة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك مؤسسات الحماية الاجتماعية الأخرى. وتقترح ثلاثة خيارات ممكنة للإصلاح:
- دمج مختلف مؤسسات الضمان الاجتماعي القائمة (أي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونيات القطاع العام)، أو
- إنشاء مؤسسة جديدة مركزية للحماية الاجتماعية، أو
- إصلاح المؤسسات القائمة.
من بين كل هذه الخيارات، تشدد هذه الاستراتيجية على تحسين التنسيق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة العمل ووزارة المالية، بالإضافة إلى آلية تمويل مشتركة تعتمد على الاشتراكات والضرائب العامة.
ولا شك في أن موضوع تمويل إصلاح الصندوق أو أي مؤسسة أخرى للحماية الاجتماعية يُفضي إلى السؤال المركزي المتمثل في تحديد الحيز المالي اللازم.
٥. ٣. إعادة ترتيب الأولويات في الأزمة - تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد إصلاحه
لدى سؤالهم/نّ عن إمكانية إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أجاب الكثير من مُحاورينا أن العوامل المتمثلة في إفلاس الدولة، وغياب السيولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والإرادة السياسية شبه المفقودة، لا تترك مجالًا كبيرًا لأي مناقشة واقعية بشأن أي إصلاح محتمل لهذه المؤسسة. ويرى عددٌ كبيرٌ منهم/نّ أن الدعم من الجهات المانحة الخارجية هو الطريقة الوحيدة لتمويل أي إصلاح في إطار الحماية الاجتماعية اللبناني. وخلافًا للاعتقاد السائد بأن إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بشكل عام، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل خاص، لا بد أن يعتمد على التمويل الخارجي، نقترح النظر في الحالة الراهنة للإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من أجل تقييم الموارد المتاحة لإصلاح الصندوق.
وعلى الرغم من عدم توافر معلومات مفصلة عن الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى الآن، أجرى معهد باسل فليحان في العام ٢٠٢١ دراسة عامة حول إنفاق الدولة اللبنانية على الحماية الاجتماعية. ينظر التقرير في بيانات الموازنة من العام ٢٠١٧ إلى العام ٢٠٢٠، وفي بيانات الإنفاق من العام ٢٠١٧ إلى العام ٢٠١٩ (معهد باسل فليحان ٢٠٢١، ١٦). أما الهدف من التقرير فيكمن في تقييم "تمويل الإنفاق الجاري وتوزيعه والتأثير الناتج عنه" من أجل اقتراح "إعادة تخصيص وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاجتماعي الحالي" (معهد باسل فليحان ٢٠٢١، ١٣).
غالبية برامج الحماية الاجتماعية في البلد تُمَول من خلال الموازنة العامة التي يأتي جزء مهم منها (ما يقارب ٧۰%) من الضرائب التنازلية على الاستهلاك. بحكم تعريفها، تُدفَع الضرائب التنازلية بالتساوي من جميع شرائح المجتمع، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي-الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، تكاد تنتفي آلية إعادة التوزيع داخل أي من الأنظمة القائمة على الاشتراكات في لبنان. نتيجةً لذلك، يدفع الأفراد الأكثر هشاشةً في البلد نصيبًا كبيرًا من هذا الإنفاق من دون الاستفادة منه فعليًا (معهد باسل فليحان ٢٠٢١، ٨٦). بالتالي، يمكن لأي تغيير نحو نظام أكثر شمولية وأكثر توجهًا إلى إعادة التوزيع أن يوفر فرصة سانحة لتوزيع الأعباء، وكذلك توزيع التقديمات والخدمات الاجتماعية بطريقة أكثر إنصافًا وشمولية.
وبالإضافة إلى نسبة الـ ٧٠% المذكورة آنفًا، إنَّ ما يقارب ٢٧% من إنفاق الحماية الاجتماعية يُستَمد من الأنظمة القائمة على الاشتراكات، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصناديق الأخرى الخاصة بالموظفين/ات. وكما هو موضح في هذا التقرير، حاليًا لا تشمل هيكلية الصندوق أي آليات لإعادة التوزيع. علاوةً على ذلك، فإن الجزء الأكبر من السكان العاملين، أي العاملين غير النظاميين/العاملات غير النظاميات والعاطلين/العاطلات عن العمل، لا يمكنهم/يمكنهن الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (معهد باسل فليحان ٢٠٢١، ٣١).
وعليه، إن الإنفاق على الحماية الاجتماعية في لبنان لا تميل كفته لمصلحة شرائح معينة من السكان فحسب، ولكن العبء الأكبر لتمويله الإجمالي يقع على كاهل شرائح الطبقة الدنيا من المجتمع، ولا سيما من خلال الضرائب التنازلية. وهذه الطبقة هي الأقل استفادةً من هذا النظام. إضافةً إلى ذلك، ووفقًا لتقرير معهد باسل فليحان، معظم الإنفاق على الحماية الاجتماعية تميل كفته في الواقع لمصلحة العاملين/ات في القطاع العام، وخصوصًا العسكريين، والموظفين/ات الذين يشغلون مناصب رفيعة في القطاع الخاص (معهد باسل فليحان ٢٠٢١، ٤٤).
ومع أن هذا التحليل يعطي صورة غير عادلة إلى حدٍ ما عن الإنفاق على الحماية الاجتماعية في لبنان، اللافت هو أن الحصة الفعلية من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق الاجتماعي بين عامَيْ ٢٠١٧ و٢٠٢٠ تراوحت بين ٥% و٦%، وهي نسبة منخفضة نسبيًا على مستوى العالم، لكنها تتجاوز المعايير السائدة في بلدان عربية عدة بمعدل الضعفين تقريبًا (معهد باسل فليحان ٢٠٢١، ٢٧). وإذا عمدنا إلى توسيع نطاق تعريف الإنفاق على الحماية الاجتماعية بما يتجاوز التصنيف التقليدي للميزانية، فإن هذه النسبة ترتفع أكثر لتبلغ ١٣% تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة أدنى قليلًا من المعايير السائدة في أوروبا وآسيا الوسطى (معهد باسل فليحان، ٣٩). وهذا يعني أن إنفاق الدولة اللبنانية على الحماية الاجتماعية ليس هزيلًا، إنما هناك سوء تخصيص وسوء توزيع.
أشارَ الكثير من مُحاورينا وغيرهم/نّ من الخبراء وصانعي/ات السياسات إلى استحالة إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب العبء المالي الذي قد يترتب على مثل هذا الإصلاح الشامل (مجلة اتحاد المصارف العربية ٢٠٢٠). وما يُعزِّز هذا الخطاب هو واقع فقدان الصندوق لمعظم أصوله خلال الأزمات الحالية (زغيب وصغير ٢٠٢٢). ومع ذلك، يُظهر تحليل الإنفاق الفعلي على الحماية الاجتماعية المطروح في هذه الدراسة أن الحيز المالي لمثل هذا الإصلاح يمكن (على الأقل) توفيره جزئيًا من خلال إعادة الهيكلة وإعادة ترتيب الأولويات وإعادة تخصيص آلية التمويل ووضع الموازنة والإنفاق على الحماية الاجتماعية في لبنان. فالفكرة السائدة بأن أي إصلاح لإطار الحماية الاجتماعية يحتاج إلى دعم مالي خارجي من المجتمع الدولي هي فكرة خاطئة. ومما لا شك فيه أن اعتماد نظام ضريبي تصاعدي أكثر، بالإضافة إلى توزيع الإنفاق الاجتماعي الحالي بطريقة مختلفة، يمكن أن يُمهد الطريق نحو إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإطار الحماية الاجتماعية.
٦. الخلاصة
يتناول هذا التقرير الجوانب المختلفة لإخفاقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانهياره الوشيك في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان منذ العام ٢٠١٩. ومن خلال تقديم لمحة عامة عن التطورات التي شهدها الصندوق عبر تاريخه، يُظهر التقرير أنَّ الأزمة قد كشفت النقاب عن أوجه القصور التي طال أمدها في الصندوق، والمرتبطة حُكمًا بتصميمه وهيكليته منذ العام ١٩٦٣ وحتى اليوم.
تؤكد هذه الدراسة أن عجز الصندوق عن حماية المستفيدين/المستفيدات منه من تأثير الأزمة الاقتصادية الحادة الحالية يجب أن يُفهم على أنه جزء من عجز عام في نظام الحماية الاجتماعية اللبناني ككلّ. فأتت الأزمة الحالية لتُعزِّز وتفضح ديناميات التمييز والشرذمة والإقصاء المتجذّرة في إطار الحماية الاجتماعية اللبناني المُجزأ بشكل عام، وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل خاص.
كذلك، يُبين تقييمنا أن أحد الأبعاد الحاسمة للتدقيق في واقع الصندوق وفهمه يتمثل في تقصّي واقع التدخلات السياسية في المؤسسة عبر مختلف مراحل تطوُّرها. فعلى الرغم من استقلاليته القانونية الجزئية، يخضع الصندوق عمليًا لنخب سياسية طائفية قادرة على التأثير في عملية تعيين هيئات صنع القرار فيه، فضلًا عن استثماراته. في هذا السياق، يبدو أن أي إصلاح أو تحوُّل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرهون بالإرادة السياسية أو التقاعس السياسي. وعلى الرغم من أوجه القصور المتعددة، يبقى الركيزة الأساسية للضمان الاجتماعي في البلد، وبالتالي يمكن اعتباره نقطة انطلاق لأي إصلاح لنظام الحماية الاجتماعية اللبناني. ومن هذا المنظور، يشير هذا التقرير إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحتاج إلى عملية إعادة هيكلة وإصلاح شاملة تُعيد إنشاء المؤسسة كركيزة أساسية للضمان الاجتماعي، على أساس الحق الشامل في الحماية الاجتماعية لجميع المقيمين/المقيمات في لبنان.
المراجع
الكتب والمقالات
Abdo, Nabil. 2019. “Social Protection in Lebanon: From a System of Privileges to a System of Rights”. Beirut: Arab NGO Network for Development.
Abi Rached, Cynthia. 2008. “The “Paris III Conference” and the Reform Agenda”, Social Watch. https://www.socialwatch.org/node/11084.
AbiYaghi, Marie-Noëlle, and Léa Yammine. August 2019. “Understanding the social protection needs of civil society workers in Lebanon. Towards strengthening social rights and security for all”. Beirut: Lebanon Support. https://civilsociety-centre.org/sites/default/files/resources/ls-socialprotection-civsocworkers-2019-en.pdf.
Akiki, Viviane. 14.10.2020. “٥ مستوردين يحتكرون أكثر من نصف السّوق: الدّواء في لبنان أكثر مرارة من الدّاء (Importers monopolize more than half of the market: the medicine in Lebanon is more bitter than the disease)”. Beirut: Legal Agenda. https://legal-agenda.com/5-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%
84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84/.
Bauman, Hannes. 2017. Citizen Hariri. Lebanon Neoliberal Reconstruction. London: Hurst.
Chalcraft, John. 2009. The Invisible Cage, Syrian Migrant Workers in Lebanon. Stanford: Stanford University Press.
Dagher, Georgia, and Sami Zoughaib. 2022. “A Collapsing Society: The Urgency of a Social Protection Floor”, The Policy Initiative, June 16, 2022
https://www.thepolicyinitiative.org/article/details/166/a-collapsing-society-the-urgency-of-a-social-protection-floor.
El-Jardali, Fadi, Lama Bou-Karroum, Nour Ataya, Hana Addam El-Ghali, and Rawan Hammoud. 2014. “A retrospective health policy analysis of the development and implementation of the voluntary health insurance system in Lebanon: Learning from failure”. Social Science & Medicine. 123. 45-54.
Hottinger, Arnold. 1966. “Zu’ama’ in historical perspective.” in Politics in Lebanon edited by Leonard Binder, 85 - 105. New York: John Wiley & Sons.
Hudson, Michael C. 1985. The Precarious Republic. Modernization in Lebanon. London: Boulder and London.
International Labor Organization (ILO). 2020. “Towards a Rights-based Social Protection System for Lebanon”. ILO, December 23, 2020.
_____ 2021. “Vulnerability and Social Protection Gaps Assessment – Lebanon. A microdata analysis based on the Labor Force and Household Living Conditions Survey 2018/2019”. Beirut: ILO.
ILO Regional Office for Arab States Social Protection Department. 2020. “Extending Social Health Protection to the uncovered in Lebanon. The role of the National Social Security Fund (NSSF) in achieving Universal Health Coverage”. Beirut: ILO.
ILO and UNICEF. 2021. “Towards a Social Protection Floor for Lebanon: Policy options and costs for core life-cycle social grants”. Policy Note.
ILO and Central Administration of Statistics (CAS). 2018-2019. “Labor Force and Household Living Conditions Survey 2018-2019, Lebanon.” Beirut: ILO and CAS.
Institut des Finances Basil Fleihan. 2021. “Social Protection Spending in Lebanon: A Deep Dive into State Financing of Social Protection”. Beirut: Institut des Finances Basil Fleihan. http://www.institutdesfinances.gov.lb/publication/social-protection-spending-in-lebanon-a-dive-into-the-state-financing-of-social-protection/.
Lebanon Support and Consultation & Research Institute. 2021. “Towards Universality: The National Social Security Fund (NSSF) Voluntary Health Insurance”. https://civilsociety-centre.org/content/towards-universality-national-social-security-fund-nssf-voluntary-health-insurance-%D9%86%D8%AD%D9%88
Lebanese Labor Watch (LOWER). 2013. “المياومون في الإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات. انتهاك لحقوق العمال وتجاوز للقاونين (Daily-workers in public administrations, independent departments, and municipalities. Violation of workers' rights and laws)”, LOWER – Diakonia, Beirut.
Merhej, Karim, and Kareem Chehayeb. 2022. “The Full Story behind the looming collapse of the National Social Security Fund” The Public Source, March 22, 2022. https://thepublicsource.org/social-security-lebanon.
Tabar, Paul, Andrew Denison, and Maha Alkhomassy. 2020. “Access to Social Protection by Immigrants, Emigrants and Resident Nationals in Lebanon”, Migration and Social Protection in Europe and Beyond, Volume 3: 183-198.
Rached, Mounir. 2012. “Social Security and Pensions in Lebanon. A Non-Contributory Proposal”. Beirut: Lebanese Economic Association.
Scala, Michele. 2022. “An Intersectional Perspective on Social (In)Security. Making the Case for Universal Social Protection in Lebanon”. Beirut: Centre for Social Sciences Research and Action.
_____ 2020. Le clientélisme au travail. Une sociologie de l'arrangement et du conflit dans le Liban contemporain (2012-2017), Ph.D. dissertation, Aix-en-Provence: Aix-Marseille University.
Traboulsi, Fawwaz. 2007. A history of modern Lebanon, London: Pluto Press.
Tufaro, Rossana. 2021. “A Historical Mapping of Lebanese Organized Labor: Tracing trends, actors, and dynamics”. Beirut: Lebanon Support.
UNICEF, ILO, Beyond Group. 2020. “Social Protection in Lebanon. Bridging the immediate response with long-term priorities”. Position Paper. Beirut: United Nations in Lebanon.
UNICEF and ILO. 2022. National Social Protection Strategy for Lebanon. Towards a rights-based, shock-responsive and sustainable system, Draft Strategy Document.
United Nations. 2022. “Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights Olivier De Schutter (Visit to Lebanon)”, March 12, 2022. https://lebanon.un.org/en/181582-report-special-rapporteur-extreme-poverty-and-human-rights-olivier-de-schutter.
World Bank (WB). 2014. “Striving for Better Jobs. The Challenge of Informality in the Middle East and North Africa.”
Yehya, Hossam. 2015. La protection sanitaire et sociale au Liban (1860-1963). Ph.D. dissertation in Law. Nice: University Sophia Antipolis.
Zoughaib Sami, and Cynthia Saghir. 2022. “Why does Lebanon not have a Pension System?. The Policy Initiative, October 17th, 2022. https://www.thepolicyinitiative.org/article/details/209/why-lebanon-does-not-have-a-pension-system.
المصادر على الإنترنت
Al-Akhbar. 2022. “قرار لبيرم باستمرار المجلس الحالي لـ«الضمان» بأعضائه (Bayram decides to keep the current council of the NSSF with its members)”, May 13, 2022. https://al-akhbar.com/Politics/336716.
Albawaba Business. 2001. “NSSF in Lebanon agree on reduced employer payments”, February 26, 2001.https://www.albawaba.com/business/nssf-lebanon-agree-reduced-employer-payments.
Al-Liwaa. 2020. “نحاس: ضمان الشيخوخة وصل الى مراحله النهائية (Nahhas: The aging guarantee is in its final stages)”. June 8, 2020. https://aliwaa.com.lb/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%86%d8%ad%d8%a7%d8%b3-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae%d9%88%d8%ae%d8%a9-%d9%88%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/.
Al Markazia. أبرز الأحداث .2022 (“Highlights”), July 18, 2022. https://www.almarkazia.com/ar/news/show/415734/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%85-.
Baalbaki, Salwa. 2022. “الحديث عن إلغاء المادة 124 بالموازنة يستفز الضمان والعمّال... كركي لـ"النهار": ملغومة! (“Talk about cancelling Article 124 of the budget provokes the social security and the workers... Karaki to An-Nahar)”, February 07, 2022. https://www.annahar.com/arabic/section/134-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84/06022022075448927.
BusinessNews.com.lb. 2018. “840,000 people paid by Social Security Fund”, October 12, 2018. http://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails/6736/840,000-people-paid-by-Social-Security-Fund.
Elnashra. 2022. “مشروع قانون موازنة العام 2022 كما جرى توزيعه على الوزراء تمهيدا لنقاشه بجلسة الحكومة الاثنين (The draft budget law for the year 2022 was also distributed to the ministers in preparation for its discussion in the government session on Monday)”. January 21, 2022. https://www.elnashra.com/news/show/1549154/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9.
Executive Magazine. 2012 “Q&A Mohamad Karaki, National Social Security Fund”, September 1, 2012. https://www.executive-magazine.com/business-all/finance/qa-mohamad-karaki.
LBC Lebanon News. 2021. “Director General of NSSF Karaki issues new decision”, December 22, 2021. https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-news/623143/director-general-of-nssf-karaki-issues-new-decisio/en.
LCB International. 2015. “REPORT: New scandal hits Lebanon's NSSF”. November 28, 2015. https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-bulletin-reports/240788/report-new-scandal-hits-lebanons-nssf/en.
Sawt Beirut International. 2022. “NSSF Director comments on Article No. 124 of the draft budget law”. February 28, 2022. https://english.sawtbeirut.com/lebanon/nssf-director-comments-on-article-no-124-of-the-draft-budget-law/.
United against corruption. 2020. “UFL Calls the Minister of Labor to Take the Decision to Stop the Godfather of Corruption at NSSF from work... And a sit-in Strikes this Wednesday”, June 17, 2020.
https://www.unitedforlebanon.com/en/press-health/39/ufl-calls-the-minister-of-labor-to.
Yassine, Hussein. 2021. “Lebanon Will Now Digitize Its Social Security Services”, The 961, Jul7 27, 2021. https://www.the961.com/lebanon-digitize-social-security-services/.
المصادر القانونية/الحكومية
Al-Jareeda al-Rasmiyya. 2017. قانون رقم ٢٧. افادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (“Law No 27. The benefit of the retired insured from the provisions of the sickness and maternity branch of the National Social Security Fund.”), February 16, 2017.
Al-Joumhouriya al-Libnaniyya Wizarat al-Maliyye. 2022. مشروع القانون الموازنة العامة (“The project of the general budget law 2022”).
Al-Joumhouriya al-Libnaniyya Ri’yasat majlis al-wuzara. 2022. رقم المحضر 23, رقم القرار 69 (“Number of the record 23, number of the decision 69”), May 22. 2022.
Decree No. 13955, 26.09.1963.The Law of Social Protection.
L’Argus de la Législation Libanaise. 2010. “A comprehensive English translation of the Lebanese Code of Labor”. 56 (1). https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/710/Labour%20Code%20of%2023%20September%201946%20as%20amended.Publication%202010.pdf.
Lebanese Republic. 2002. “Lebanon: Paris II Meeting, Beyond reconstruction and recovery...towards sustainable growth, A request for international support”.
[1] للاطلاع على جدول زمني يُلخِّص أبرز المحطات في بناء نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، راجع/ي:
https://civilsociety-centre.org/cap/timeline-social-protection-in-lebanon.
[2] مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية دولية، ١٢ .٠٥ .٢٠٢٢.
[3] كما سنُوضِّح لاحقًا، من المفترض أن تساهم الدولة بإعانة نسبتها ٢٥% لفرع التأمين الصحي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[4] مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية دولية، ١٢ .٠٥ .٢٠٢٢.
[5] اقتباس من مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية دولية، ١٢ .٠٥ .٢٠٢٢.
[6] مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية دولية، ١٢ .٠٥ .٢٠٢٢.
[7] مقابلة مع أحد/إحدى الموظفين/ات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ٢٣ .٠٦. ٢٠٢٢.
[8] الديناميات الزبائنية في توظيف المياومين/المياومات هي ممارسة شائعة في الشركات والمؤسسات العامة الأخرى، مثل كهرباء لبنان، راجع/ي سكالا ٢٠٢٠.
[9] كما ذُكِرَ سابقًا، فإن آليات التغطية ومعدلاتها في جميع فروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأثرت بسبب الأزمة المالية في لبنان، وانهيار قيمة العملة الوطنية. ولكن التغطية المقدمة من خلال الصندوق لا تزال - على الورق - كما هي. من الناحية العملية، ترفض المستشفيات اليوم مدفوعات الأطراف الثالثة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطلب من المستفيدين/المستفيدات من الضمان تغطية ما يقارب ٩٠% من الفاتورة، بينما يسدد الصندوق ما يقارب ١٠% من الكلفة الإجمالية. سنُناقِش هذه المسألة بمزيدٍ من التفاصيل في قسم لاحق من هذه الدراسة.
[10] مقابلة مع زوجة سائق سيارة أجرة عاطلة عن العمل بتاريخ ٣٠ .٠٥ .٢٠٢٢.
[11] احتُسب وفقًا لسعر الصرف البالغ ١ دولار أمريكي = ٨٨٠٠٠ ليرة لبنانية في وقت تحرير هذا التقرير.
[12] في العام ٢٠٠٤، طُلب من البنك الدولي دراسة مشروع القانون وتحديد توصياته. وقوبِلت هذه الأخيرة بمعارضة سياسية شديدة، وبالتالي وُضع القانون جانبًا حتى العام ٢٠٠٨ عندما أُعيد طرح مشروع القانون على البرلمان وعلى لجان نيابية مختلفة. في العام ٢٠١٠، أطلقَ وزير العمل نقاشًا جديدًا حول القانون. وحتى اليوم، لم يُعتمَد.
[13] مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية محلية، ٢٣ .٠٥. ٢٠٢٢.
[14] مقابلة مع أحد موظفي قسم المبيعات في إحدى الشركات، ١٢. ٠٥. ٢٠٢٢.
[15] مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية محلية، ٢٣. ٠٥. ٢٠٢٢.
[16] وزير العمل مصطفى بيرم، اقتباس من "المركزية"، ١٨. ٠٧. ٢٠٢٢.
[17] مقابلة مع موظف/ة في المديرية المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت، ٠١. ٠٦. ٢٠٢٢.
[18] مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية محلية، ١٧. ٠٥. ٢٠٢٢.






