يحلّل هذا الموجز للسياسات الثغرات في نظام الحماية الإجتماعية في لبنان ويقارنها مع أشكال التمييز المتقاطعة. ينظر هذا الموجز في نظام الحماية الإجتماعية المشرذم وأوجه القصور فيه ملقيًا الضوء على مظاهر المنطق الإقصائي على أساس النوع الاجتماعي أو الهوية الإثنية أو وضع الإقامة أو الوضع الوظيفي، بالإضافة إلى السنّ و/أو الإعاقة أيضًا. يشدّد هذا الموجز على أن الثغرات في نظام الحماية الإجتماعية تعكس وتحافظ على التسلسل الهرمي الإجتماعي الذي يتصف به الإطار الإجتماعي والسياسي اللبناني وتعيد إنتاجه. أخيرًا، يطرح هذا الموجز مسألة الحماية الإجتماعية الشاملة في لبنان من خلال توفير مقاربة اجتماعية وسياسية للثغرات الحالية، مقدّمًا إياها كالحل الوحيد للإستجابة بشكل فعال وانطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان بما يمكّن من معالجة أوجه القصور الهيكلية في النظام الحالي.
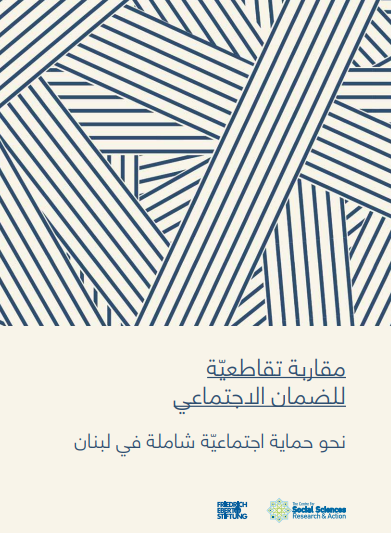
المقدّمة
إنَّ نظام الحماية الاجتماعية في لبنان هو نظامٌ مشرذم قائم على الاشتراكات وتقديم الخدمات الظرفية والمؤقّتة بالتركيز على استهداف الفئات الهشّة. فمن جهة، تُشكِّل برامج الضمان الاجتماعي الإلزامية الركيزةَ الأساسية لنظام الحماية الاجتماعية في لبنان. وترتبط بالعمل النظامي في القطاع الرسمي، في حين أنَّ سوق العمل يُهيمِن عليه العمل غير النظامي الذي يُمثِّل القاعدة السائدة وليسَ الاستثناء. ومن جهة أخرى، تؤكّد البيانات أنَّ المساعدات المُخصَّصة للفئات الهشّة لا تُحقّق أيّ أثر يُذكَر على دخل الفئات المُستهدَفة، إضافةً إلى معدّلات الأخطاء المرتفعة لناحية معايير الأهلية (منظّمة العمل الدولية 2021)، الأمر الذي يحدّ من فعّاليتها.
وإلى جانب الثغرات التقنية، يكشف تحليل نظام الحماية الاجتماعية في لبنان عن أشكال متقاطعة من الإقصاء والحرمان من تقديمات الحماية الاجتماعية، وتحديدًا بسبب الوضع الوظيفي والطبقة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والجنسية ووضع الإقامة والأصل العرقي وغيرها من الخصائص الاجتماعية، مثل الإعاقة أو العمر. وبشكل عام، برهنَ نظامُ الحماية الاجتماعية الحالي عن فشلٍ ذريع في تأمين الحماية مُقصيًا غالبية السكّان من الحماية، فيُساهِم بالتالي في توسيع دائرة انعدام الأمن الاجتماعي.
يسعى هذا الموجز إلى تحقيق هدفَيْن: أوّلًا، يهدف إلى شرح تأثير الهويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على تغطية الحماية الاجتماعية لسكّان لبنان. وثانيًا، يقترح سُبُلًا للإصلاح عبر تحليل أشكال التمييز المتقاطعة والامتيازات التي ينطوي عليها الإطار الحالي للحماية الاجتماعية.
إنَّ تحليل سياسات الحماية الاجتماعية وبرامجها وآلياتها هو طريقة تسمح لنا بالتعرّف على كيفية تعريف المجتمع لمفاهيم التضامن والعدالة الاجتماعية ونظرته لها، وكيف يُحاول بناء عقد اجتماعي على نطاقٍ أوسع. انطلاقًا من ذلك، نستهلّ هذا الموجز بالحديث عن نشوء «المسألة الاجتماعية» وكيفية تطوُّر برامج الضمان الاجتماعي في لبنان من منظور تاريخي وسياسي. نُشير إلى كيفية مساهمة التحرّك الاجتماعي الذي نشأ في تشرين الأوّل/أكتوبر 2019 (أي ما يُسمّى الثورة) في لبنان في (إعادة) تفعيل المطالب الاجتماعية التي كانَ يتمّ «التعتيم» عليها وتُرمى في أسفل جدول الأعمال السياسي خلال حقبة ما بعد الحرب مقابل الأولويات الطائفية وأشكال التحرّك السياسي (أبي ياغي وكاتوس 2011).
بعد ذلك، ننتقل إلى تحليل نظام الحماية الاجتماعية الحالي ونُقيِّم ثغراته، ونُبيِّن إخفاقه في توفير المساعدة للشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع، بالإضافة إلى تحليل مظاهر المنطق الإقصائي في البرامج الحالية للحماية الاجتماعية على أساس الطبقة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والعرق والأصل الإثني وغيرها من أشكال التمييز الاجتماعي.
ختامًا، نتحدّث عن تأثير الأزمة المتعدّدة الجوانب التي تعصف بالبلد على المجموعات التي كانت «تتمتّع بامتيازات» في السابق، وما واجهته هذه الشريحة من تراجُع تدريجي في مكانتها الاجتماعية في ظلّ ظاهرة «الإفقار».
وفي النهاية، نقترح سُبُلًا للمضيّ قدمًا في عملية إصلاح نظام الحماية الاجتماعية من خلال السياسات الاجتماعية الشاملة.
المسألة الاجتماعية: أولوية سياسية «جديدة»؟
شهدَ العام 2019 في لبنان تحرّكًا اجتماعيًا تحت راية المُطالبة بالعدالة الاجتماعية، ممّا سلَّطَ الضوء على مركزية «المسألة الاجتماعية». وهذه المسألة هي في الواقع عبارة عن تساؤلات حول أشكال التضامن التي يرتكز عليها المجتمع، وتَظهَر في هذا الإطار الحاجة الماسّة إلى معالجة أوجه عدم المساواة وتنظيم سياسات اجتماعية ملائمة لضمان الإدماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية. وفي سياق الأزمات المتعدّدة المستويات التي يشهدها لبنان، والتي تستمرّ بالكشف عن الثغرات الموجودة منذ زمن في نظام الحماية الاجتماعية في البلد، تطرح المسألة الاجتماعية نفسها كقضية رئيسية تسترعي الاهتمام.
إنَّ «الكساد المُتعمَّد» للاقتصاد اللبناني، كما عرّفه البنك الدولي (البنك الدولي 2020)، يشمل جميع أبعاد الحياة الاجتماعية، ويُضيّق الخناق على استراتيجيات التكيُّف التي اعتمدتها الأغلبية الساحقة من السكّان اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان. وفي حين يمرّ البلد في أزمة تُعتبَر واحدة من أصعب ثلاث أزمات اقتصادية في القرنَيْن الماضيَيْن (البنك الدولي 2020)، تُشير تقديرات لجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أنَّ 82% تقريبًا من الأُسَر تعيش حالة من «الفقر المتعدّد الأبعاد» حاليًا (الإسكوا 2021). في هذا الإطار، ومع انهيار قيمة الليرة اللبنانية بسرعةٍ فائقة ومُقلقة،وانقطاع الكهرباء وأزمة المحروقات، وإغلاق عدد كبير من المؤسّسات، وارتفاع نسبة البطالة والصرف من العمل، وانتهاك حقوق العمّال (ديراني 2021)، تبرز إلى الواجهة الثغرات التي تشوب نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، بينما أصبحَ الوصول إلى الخدمات الأساسية يُشكّل اليوم أولويةً أساسية للكثيرين/ات. فالنظام الحالي للسياسة الاجتماعية في لبنان يُعتبَر في الحقيقة متخلّفًا وتفاعليًا ومُسيَّرًا بشكلٍ أساسي وفقًا لأجندات الجهات المانحة الدولية. وأكبر دليل على غياب الرؤية والبرمجة المتكاملة للسياسة الاجتماعية بدا واضحًا من خلال غياب الاستجابة السياساتية للأزمات العديدة التي يتخبّط فيها البلد حاليًا. وبقيَ البرلمان حتّى 30 حزيران/يونيو 2021 ليُقرّ «قانون البطاقة التمويلية» المزعوم، في محاولةٍ مُبهَمة منه للتخفيف من وطأة رفع الدعم غير المباشر على المحروقات والطحين والأدوية، بواسطة المساعدات النقدية (المباشرة) إلى الأُسَر المؤهّلة، من خلال بطاقات نقدية مُسبقة الدفع. ولم يُطبَّق بعد هذا القانون ولم يتمّ إصدار هذه البطاقات النقدية في وقت إعداد هذا الموجز.
بالنسبة إلى ظاهرة «انعدام الأمن الاجتماعي» المنتشرة (كاستيل 2003)، استندت الاستجابة إلى «هياكل وخطابات متعارضة» (عبدو 2004) مع ثلاث مقاربات مختلفة على الأقلّ لمعالجة مسألة الحماية الاجتماعية: أوّلًا، استجابة تفاعلية تندرج بالإجمال في إطار المساعدة الطارئة، بما يتماشى مع نهج البنك الدولي (بواسطة برامج مثل البرنامج الوطني لدعم الُأسَر الأكثر فقرًا أو شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ، التي تمّ تفصيلها في المربّع أعلاه)؛ وثانيًا، خطاب طرحته منظّمة العمل الدولية ومنظّمة اليونيسيف، للمطالبة باعتماد أرضية متعدّدة المستويات للحماية الاجتماعية. في ورقة سياساتية مشتركة، تعرض منظّمة العمل الدولية ومنظّمة اليونيسيف السُبُل التقنية لتنفيذ منحة اجتماعية أساسية تمتدّ على كلّ مراحل دورة الحياة، مُشدِّدةً على أنَّ أفضل طريقة لمعالجة الفقر تكون عبر اعتماد نظام شامل للحماية الاجتماعية، وليس عبر البرامج التي تستهدف فئات معيّنة وتستبعد فئات أخرى (وتحمل العديد من الأخطاء والثغرات). ثالثًا، يشدّد بعض الخبراء والباحثين/ات والناشطين/ات في القضايا المدنية على ضرورة الشروع في عملية إصلاح هيكلية لنظام الحماية الاجتماعية من أجل الاستجابة بشكل فعّال للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة. في كانون الثاني/يناير 2021، بعد الإعلان عن التنفيذ الوشيك لشبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ وتوسيع نطاق البرنامج الوطني لدعم الأُسَر الأكثر فقرًا من قِبَل البنك الدولي، برزت أصوات من المجتمع المدني للدعوة إلى تفادي الآليات الظرفية القائمة على أساس الحاجة لمعالجة الأزمات، وطالبت بتطبيق نهج شامل وقائم على حقوق الإنسان لتوفير الحماية الاجتماعية.
بالرغم من هذه المقاربات المختلفة، تُشكّل المسألة الاجتماعية قضيةً أساسية في حياة الأفراد وفي محاولاتهم/هنّ اليومية للحصول على الخدمات والحماية الاجتماعية، سواء في خطابات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أو في التطبيق العملي، وفي نقاشات وبرامج الجهات الدولية والجهات المانحة. وبمعنى آخر، يبدو وكأنَّ المسألة الاجتماعية – وللمرّة الأولى ربّما – تُبنى وتُرسَم ليس فقط من باب الأولوية الإنسانية، بل أيضًا من باب الأولوية السياسية في لبنان. ولكنْ، هل يُفهَم نشوء المسألة الاجتماعية كأولوية سياسية في لبنان بعد العام 2019 بأنَّه النتيجة التلقائية لتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي لغالبية سكّان لبنان؟
إنَّ قضايا العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية ليست «جديدة» على الساحة اللبنانية. وكما ذكرَت ماري-نويل أبي ياغي وميريام كاتوس (2011)، انبثق العديد من التحرّكات الاجتماعية حول مجموعة واسعة من «القضايا الاجتماعية» - وغالبًا ما تمّ التغاضي عنها أو التقليل من شأنها - في الفترة التي تلَت الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1989) (أبي ياغي وكاتوس 2011؛ كاتوس 2020). وساهمت بعض التحرّكات الاجتماعية في تسليط الضوء على الهواجس الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ«المسألة الاجتماعية»، مثل ما يُعرَف بـ«ثورة الدواليب» في العام 1992، أو «الانتفاضات» الشعبية في ضاحية بيروت الجنوبية بسبب انقطاع الكهرباء (فيردي 1/30/2008؛ كاتوس 2020) في العام 2008، أو احتجاجات سائقي السيّارات العمومية في العام 2010 بسبب زيادة الضرائب الحكومية على المحروقات (أبي ياغي وكاتوس 2011). ولكنْ، لطالما تمّ «التعتيم» على هذه التحرّكات المتفرّقة - رغم استمرارها وتكرارها - وبقيت «في الظلّ» مقارنةً بالتحرّكات الحزبية والطائفية، واللجوء إلى العنف السياسي، والصدامات بين الطوائف (أبي ياغي وكاتوس 2011). ورغم ذلك، تطوَّرَت هذه المطالب الاجتماعية (أبي ياغي وكاتوس 2011) في لبنان بعد الحرب لتتحوّل إلى موجة استنكار مفتوحة ضدّ الفساد والأزمات الاجتماعية، وذلك خلال التحرّكات التي انطلقت في العام 2015 احتجاجًا على «أزمة النفايات»، وخاصّةً خلال تظاهرات 17 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019 حيث تمّ التعبير عن المعاناة الاجتماعية والاقتصادية تحت راية النضال من أجل العدالة الاجتماعية (أبي ياغي ويمّين 2020؛ حريري وسكالا 2019). إذًا، أتت التحرّكات في العام 2019 لـ(تُعيد) تفعيل المطالب الاجتماعية القديمة، فاحتلّت موقع الصدارة على الساحة السياسية.
بعبارة أخرى، المسألة الاجتماعية ليست جديدة، ولا يمكن قراءة المطالب المتزايدة بشأن الحماية والعدالة الاجتماعية باعتبارها نتيجة سببية للأزمات الضاغطة والمتداخلة على الصعيد الاقتصادي والصحّي والاجتماعي والسياسي التي يشهدها لبنان حاليًا. لكنَّ بروزها كأولوية سياسية هو ربّما إحدى النتائج الرئيسية للتحرّك الذي انطلقَ في 17 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019 (أي الثورة).
نشأة المسألة الاجتماعية في لبنان
في السياقات الأوروبية، ترتبط المسألة الاجتماعية ارتباطًا وثيقًا بالقوّة العاملة المأجورة أو «أصحاب الرواتب» (كاستيل 1995) وبمصير الحركة العمّالية (فان دير ليندن 2008)، بينما تمّ تكريس المسألة الاجتماعية في الشرق الأوسط للكفاح في سبيل الوحدة الوطنية وبناء الدولة (هاريس 2019) – ولطالما اعتُبِرَت مسألةً ثانوية بالنسبة إلى هذه القضية (كاتوس 2020).
في السياق اللبناني، يُعَدّ عهد الرئيس فؤاد شهاب (1958-1964)، الذي ركَّزَ على تطوير المؤسّسات العامّة وتعزيز البيروقراطية في الدولة، أساس النظام الوطني للحماية الاجتماعية (قرم 2012). وبشكلٍ عام، تُعتبَر برامج الحماية الاجتماعية التي طُرِحَت في العام 1963 للموظّفين/ات في القطاع العام جزءًا من خطّة شهاب الإنمائية، وقد تمثّلت بإنشاء تعاونيات منفصلة لموظّفي/ات القطاع العام والقوى الأمنية، إلى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لموظّفي/ات القطاع الخاصّ (القانون المُنفَّذ بالمرسوم رقم 13955 بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 1963). وكما يُشير نبيل عبدو، «شكَّلَ إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خطوة جريئة في العهد الشهابي، وليسَ ثمرة عقد اجتماعي بين العمّال والرأسمالية والدولة» (عبدو 2014، 10). علاوةً على ذلك، أُنشئت خلال فترة حكم الرئيس شهاب وزارة التخطيط العام أو مكتب التنمية الاجتماعية (أبي ياغي 2014). رغم ذلك، لا يمكن التغاضي عن مساهمة التحرّكات العمّالية والاجتماعية في بلورة السياسات الاجتماعية.
على مرّ التاريخ، تشكّلت السياسات الاجتماعية في لبنان بفعل قوّتَيْن أساسيّتَيْن: الأولى هي النخبة في إطار تبادل القوى الطائفية (أي ما يُعرف بـ«التوافقية»)، والثانية هي الأشكال المختلفة للتحرّكات الشعبية التي انبثقت من رحم المعاناة على الصعيدَيْن الاجتماعي والاقتصادي.
فيما يتعلّق بسياسات الدولة، وُضع نموذج أوّلي لنظام الحماية الاجتماعية في عهد الانتداب الفرنسي وحدّد أُسُس إدارة الأحوال المدنية المرتبطة بالطوائف وأوكل إليها تقديم الخدمات الاجتماعية عن طريق «الجمعيات الخيرية» (يحيى 2015، 119 وما يتبع). كذلك، شهدت فترة الانتداب الملامح الأساسية الأولى للحماية تحت مظلّة الضمان الاجتماعي للعاملين/ات (طومسون 2005، 156-163)، التي أُدخلت حيّز التنفيذ بواسطة تعديلات لبنودٍ محدّدة من قانون الموجبات والعقود الموروث عن العهد العثماني (القانون الصادر في 9 آذار/مارس 1932). وتمّ الحفاظ على هذا النمط الثنائي في تقديم الخدمات وتوسَّعَ نطاقه بشكلٍ إضافي في الفترة التي تلت الاستعمار والتي شهدت تحسُّن خدمات الحماية الخاصّة بالعمّال، عبر إقرار قانون العمل لعام 1946 (القانون الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 1946)، وترسيخ مبدأ الرعاية الطائفية كمصدر رئيسي للخدمات الاجتماعية. وبين الاستقلال (1943) وعام 1960 على سبيل المثال، تمّ تأسيس 150 جمعية خيرية، أيْ ما يوازي 40% من إجمالي عدد الجمعيات الخيرية التي أُنشئت بين 1860 و1964 (يحيى 2015، 402). واستغَلَّ الزعماء هذه الجمعيات الخيرية الطائفية لبسط سيطرتهم ضمن النظام السياسي، إدراكًا منهم بأنَّ «المساعدة هي أقوى وسيلة للبروباغاندا» (يحيى 2015، 403). وبالتالي، تلاشت الخطوط الفاصلة بين العمل الخيري والزبائنية. كانت مقاربة فؤاد شهاب الإنمائية واستراتيجيته للتوحيد الوطني من خلال إنشاء المؤسّسات العامّة بمثابة محاولة مباشرة للتصدّي لهيمنة الزعماء ضمن السياق السياسي اللبناني (هوتينجر 1966) وتقليص حجم الرعاية الطائفية التي تعتمد على ما أطلقت عليه ميلاني كاميت (Melani Cammett) اسم «الطائفية التعاطفية» (كاميت 2014). فضلًا عن ذلك، شكَّلَ تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في عهد الرئيس شهاب قضية سياسية تنظيمية مقابل النضالات العمّالية القائمة منذ وقت طويل. شملت هذه النضالات في البداية نقاباتٍ عمّالية غير قانونية ولكنْ مُنظَّمة، انبثقت خلال عهد الانتداب، وساهمَ كفاحُها إلى حدّ كبير في ولادة قانون العمل في عام 1946 (كولاند 1970؛ توفارو 2021). واعتُبر إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام 1963 إنجازًا ضخمًا للحركة العمّالية التي استمرّت بالنضال في سبيل تطبيقه على أرض الواقع لسنواتٍ لاحقة. خلال ستّينات وسبعينات القرن الماضي، ثابرت النقابات العمّالية المُنظَّمة في مطالبتها بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، ووسّعت نطاق هذه المطالب لتشمل مطالب اجتماعية إضافية، مثل ضمّ عمّال القطاع الزراعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحقّ في الإسكان، وإلغاء المادّة 50 من قانون العمل التي تسمح بالصرف التعسُّفي (توفارو 2021). وخلال الحرب الأهلية اللبنانية، نظّمت نقابات السائقين العموميين دورات مختلفة من التحرّكات احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات جرّاء رفع الدعم. وفي هذا السياق، نجح اتّحاد نقابات السائقين العموميين، الذي أُنشئ في العام 1986، بإلحاق المنتسبين إليه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل قبوله بارتفاع سعر المحروقات بحكم الأمر الواقع (أبي ياغي وكاتوس 2011، 82). ونتيجةً لذلك، أصبح تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي، والاستفادة الفعلية منها، قضيةً يتمّ التفكير فيها وطرحها ضمن إطار المسألة الاجتماعية الأوسع، وكجزء من النضال في سبيل العدالة الاجتماعية، حيث تلعب الحركة العمّالية دورًا رئيسيًا. يمكن أن تساعد الأولوية الشهابية الساعية إلى بناء المؤسّسات العامّة على فهم السبب وراء إنشاء برامج الضمان الاجتماعي الرامية إلى توفير المزيد من الحماية لموظّفي/ات القطاع العام والسلك العسكري، أي «موظّفي/ات الدولة»، مقارنةً ببرامج الضمان الاجتماعي التي تُغطّي موظّفي/ات القطاع الخاصّ. وكما أشارَت لونغونيس وآخرون، إنَّ «نموذج ’أصحاب الرواتب‘ المُهيمن» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الذي يُعتبَر في هذا السياق بمثابة مؤسّسة سياسية واجتماعية واقتصادية تُوفّر الحماية مقابل التبعية - (كاستيل 1995، سوبيوت 2000؛ بولاني 2015) «هو [ولطالما كان] أكثر من أيّ وقت مضى، يتجسّد بالوظيفة العامّة» (لونغونيس وآخرون 2005، 22). في سياقات أخرى مثل أوروبا، ارتبطت ولادة «ظاهرة أصحاب الرواتب» (أو القوى العاملة) بشكلٍ وثيق بتطوُّر العلاقات الصناعية والنضالات العمّالية، في حين أنَّها تبِعَت مسارَها الخاصّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وارتبطت بشكلٍ منهجي بتطوُّر الوظيفة العامّة. وهنا تجدرُ الإشارة إلى أنَّ مصطلح «الموظَّف/ـة» لطالما ارتبط أصلًا وتاريخيًا بالوظيفة العامّة قبل أن يتوسّع تعريفه ليشمل أيّ نوع من الوظيفة باللغة العامّية، سواء في القطاع العام أو الخاصّ (لونغونيس وآخرون 2005، 21؛ فيوروني 2018، 148).
شهدَ نموذج الحماية الاجتماعية الشهابي عملية تفكيك كبرى خلال فترة ما بعد الحرب، في إطار إعادة التنظيم النيوليبرالي الواسع النطاق الذي خضعَ له النظام الاقتصادي اللبناني وبدأ من خلال سياسات إعادة الإعمار التي أطلقها رئيس الوزراء في ذلك الوقت، رفيق الحريري (ديبه 2005). وكانَ الدافع الأهمّ لهذا التفكيك ارتفاع قيمة الدين العام بشكلٍ ملحوظ، ما استدعى اعتماد ميزانيات أكثر تقشُّفًا وترشيد نفقات القطاع العام. وما يوازي ذلك أهميةً هو أنَّ ارتفاع قيمة الدين العام أدّى إلى زيادة اعتماد لبنان على المؤسّسات المالية الدولية التي لعبت دورًا أساسيًا في ترسيخ برامج المساعدات الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات والمرتبطة بالمعونة الطارئة كوسيلة مفضّلة لمعالجة الثغرات الاجتماعية والاقتصادية. وكانَ هناك أيضًا دور مهمّ لظاهرة الاستقطاب التدريجي للحركة العمّالية (بو خاطر 2019) والأزمات الإنسانية التي عصفت بالبلد بشكلٍ دوري. نتيجةً لذلك، تشتّتت آليات الحماية الاجتماعية في مجموعة من البرامج المُجزَّأة والمُفكَّكة، التي لا تستطيع توفير استجابة ملائمة لاحتياجات مجمل الشعب اللبناني.
تطوُّر برامج الضمان الاجتماعي المرتبطة بالعمل النظامي
إذًا، رُبِطَت نشأة المسألة الاجتماعية، في إطار السياسات العامّة، بمصير الدولة وبنائها في لبنان. أمّا بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، تمحورَ مسارُهما حول مسار دولة الرفاه «التي لم تُبصِر النور»، والاقتصاد السياسي اللبناني.
يمكن القول بأنَّ برامج الضمان الاجتماعي في لبنان مستوحاة من النموذج البسماركي لأنَّ «الأشخاص المضمونين هم موظّفون/ات يموّلون النظام، إلى جانب أصحاب العمل، من خلال اشتراكات قائمة على الأجور أو الرواتب» (عبدو 2014، 10). باختصار، المقصود بذلك هو التالي: إذا أردتَ/أردتِ أن تتلقّى/ي الحماية، يجب أن تكون/ي مُنتِجًا/مُنتِجةً. وبما أنَّ برامج الضمان الاجتماعي مرتبطة بالاشتراكات، فهي حُكمًا مرتبطة بالعمل النظامي.
ولكنْ، أدّى التوجّه الليبرالي للاقتصاد السياسي في لبنان، والنيوليبرالي منذ فترة ما بعد الحرب، إلى نشوء سوق عمل غير نظامي على نطاقٍ واسع - من بين أمور أخرى:
«إنَّ التعايش المضطرب بين نظام الضمان الاجتماعي القائم على العمل النظامي والنموذج الاقتصادي الحرّ الذي يتّصف بتدخُّل محدود من الدولة، قد ولَّدَ نزعةً ازدواجية وثنائية ملحوظة في سوق العمل: العمل النظامي مقابل العمل غير النظامي، والعاملين/ات الذين يحصلون على الامتيازات مقابل العاملين/ات المحرومين/ات منها؛ والعمالة المُسَلْعَنَة مقابل العمالة غير المُسَلْعَنَة نسبيًا، والمواطنون/ات الذين يستفيدون من الحماية الاجتماعية مقابل المواطنين/ات المحرومين/ات منها» (عبدو 2014، 11).
تُبيِّن هيكلية سوق العمل في لبنان بوضوح أنَّ اليد العاملة النظامية التي تتقاضى الأجور وتستفيد من الحماية (أصحاب الرواتب) لا تُشكِّل - ويبدو أنَّها لم تُشكِّل يومًا - القاعدة السائدة في العلاقات العمّالية كما هو الحال في أوروبا أو في أميركا الشمالية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ «الوظيفة المعيارية [أي وظائف أصحاب الرواتب] تُمثّل حالة شاذّة تاريخيًا في إطار الرأسمالية» (فان دير ليندن 2014، 19) وكانت تخصّ بشكل رئيسي دولَ الشمال ذات الدخل المرتفع بعد الحرب العالمية الثانية (1946-1975). بالتالي، «كانَ [لها] أثر عميق في جزء محدود من العالم ولفترة قصيرة نسبيًا من الزمن (بريمان وفان دير ليندن 2014، 920). إنَّ 61,2% من القوى العاملة تعمل في القطاع غير النظامي اليوم حول العالم، بينها 85,8% من الوظائف في أفريقيا، و68,6% في البلدان العربية، و68,2% في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، و18% في «البلدان المتقدّمة» (منظّمة العمل الدولية 2019، 13). وفي لبنان، القطاع الذي يُسمّى «القطاع غير النظامي» نادرًا ما يكون «الاستثناء»، ولطالما استقطبَ معظم اليد العاملة. كما أنَّ الطابع غير الرسمي للعلاقات العمّالية هي ظاهرةٌ لها جذور سياسية عميقة، وتمّ استثناء العديد من الفئات العمّالية من قوانين العمل التنظيمية على مرّ التاريخ، ممّا دفعَ بها إلى مجال العمل غير النظامي. ويمكننا أن نفهم الاستثناء الشكلي أو الواقعي (أي التاريخي) لبعض الفئات المهنية من قانون العمل عبر دراسة الإطار الإيديولوجي الذي انبثق عنه هذا الاستثناء وطُبِّقَ فيه.
نصَّ الدستور في مقدّمته على الهوية الليبرالية للـ«جمهورية التجارية» (غايتس 1998)، وذلك منذ نسخته الأولى في العام 1926، وبقيت الأمور على حالها في نسخة العام 1990: «النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصّة» (مقدّمة الدستور اللبناني [1990]، البند واو). ويمكن لوجهة نظر ميشال شيحا (1881-1954)، الداعم لـ«مغامرة الحرّية» اللبنانية في السوق الحرّة، أن تُفسِّر كيف أثّرت المقاربة الليبرالية على قوانين العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية. فقد كتبَ شيحا أنَّ لبنان يجب ألّا يؤمّن الحماية للعاملين/ات في قطاعَيْ الزراعة والبناء كونه لا يرقى إلى مستوى تنافسيّ في هذين المجالَيْن على الصعيد الإقليمي. ومن هذا المنطلق، قالَ إنَّ: «حاملي/ات الشهادات والخرّيجين/ات والدكاترة هم مَن يجب التركيز عليهم. فبطالتهم هي البطالة الوحيدة التي لها أثر دراماتيكي» (شيحا 1964، 113). وتؤكّد صياغة قانون العمل في العام 1946 على هذه المقاربة. فهؤلاء العمّال غير مشمولين بأحكامه، سواء كان ذلك شكليًا أيْ بحكم القانون، كما هو الحال بالنسبة للعمّال الزراعيين غير المشمولين بقانون العمل في المادّة 7، أو بحكم الأمر الواقع كما هو الحال بالنسبة للعاملين في قطاع البناء. فهذه الفئات لطالما كانت، على مرّ التاريخ وعلى نطاق واسع، تتألّف من عمّال مياومين وغير نظاميين، وسوريين بالتحديد (شالكرافت 2009).
قبل أزمات العام 2019، واستنادًا إلى بيانات منظّمة العمل الدولية، هناك عامل واحد (1) فقط من بين كلّ 10 عمّال في مجالَيْ البناء والزراعة يستفيد من التأمين الاجتماعي المرتبط بالعمل (منظّمة العمل الدولية 2021، 7). علاوةً على ذلك، وكما سنوضّح لاحقًا، يبدو أنَّ هذه البيانات لا تعكس الأرقام الحقيقية لشريحة العمّال غير المضمونين في هذه القطاعات. في الواقع، تستند الحسابات إلى استطلاعٍ لا يأخذ بالاعتبار العمّال الأجانب الذين يعيشون في «مساكن غير رسمية» (منظّمة العمل الدولية 2021، 14)، والذين تقوم استراتيجياتهم لكسب لقمة العيش بشكلٍ أساسي على العمل اليومي و/أو الموسمي في قطاعَيْ البناء والزراعة (شالكرافت 2009؛ عجلوني وكوار 2015؛ أوبين-بولتانسكي 2018).
تقاطع الديناميّات الإقصائيّة في برامج الضمان الاجتماعي
الاستبعاد من برامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر فقط على العاملين/ات في القطاع غير النظامي. فالهويات الاجتماعية والسياسية المتداخلة والمرتبطة بالجنسية أو الهوية الإثنية أو الطبقة الاجتماعية أو النوع الاجتماعي أو العمل أو وضع الإقامة، تُساهِم في حرمان الأفراد والمجموعات من تقديمات الضمان الاجتماعي.
تأثَّرَ سوق العمل والنسيج الاجتماعي في البلد جرّاء الأزمات الإقليمية المتتالية والمختلفة وما أعقبها من توافد دفعات متنوّعة من اللاجئين/ات من فلسطين والعراق وسوريا واليمن. دخلت أجيال اللاجئين/ات هذه بشكلٍ جزئي ضمن القطاع غير النظامي ودُفِعَت إلى هامش الحياة في المُدُن والأرياف. وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات لا يمكنهم/هنّ العمل في 70 مهنة وفقًا للمرسوم الوزاري 289/1 الصادر في العام 1982 (أبي ياغي 2014) ولا يمكنهم/هنّ حيازة الممتلكات (عقارات)، ممّا يزيد من تهميشهم/هنّ ويحدّ من فُرَصهم/هنّ في العمل. كذلك، فإنَّ مشاركة اللاجئين/ات السوريين/ات في سوق العمل محكومة بتعاميم وزارية، تصدر بشكل سنوي تقريبًا، وتحصر عملهم/هنّ في ثلاثة مجالات فقط - الزراعة والبناء والخدمات - وجميعها مُستثناة من قانون العمل أو تتّصف إلى حدّ كبير بطابعٍ غير نظامي.
علاوةً على ذلك، بلغَ استيراد اليد العاملة الأجنبية في نهاية التسعينات ثلاثة أضعاف رقمه الأساسي، وغالبيتهم من العمّال الأجانب النساء والرجال، من الدول الأفريقية جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا (دو بيل اير 2017، 10)، وخصوصًا في القطاعات التي تتطلّب عمّالًا بمهارات متدنّية (لونغونيس وطبر 2014). يعمل الذكور الأجانب في القطاع الخدماتي، ولم يخصّص الباحثون/ات والأخصّائيون/ات قدرًا كافيًا من الدراسات حول ظروف عمل هذه الشريحة؛ لكنَّ بعض الأبحاث، إلى جانب التفتيش الخاصّ بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام 2012، أشارَت إلى الانتهاكات التي تطال حقوقهم كعمّال وعدم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي في قطاع البيع بالتجزئة (حسين 2019؛ سكالا 2020). أمّا بالنسبة للنساء، فغالبًا ما يتم تشغيلهنّ كعاملات منزليات، ويُستَثنَيْن من قانون العمل وفقًا للمادّة 7، علمًا أنَّ المادّة 7 تستثني أيضًا العاملين/ات في الزراعة والمياومين/ات في المؤسّسات العامّة والشركات والإدارات. بالتالي، تُستثنى هذه الفئات المهنية الثلاث من برامج الضمان الاجتماعي.
وكما يتبيّن من خلال هذه الأمثلة القليلة، لا يرتبط الضمان الاجتماعي الوظيفي بالعمالة النظامية فحسب، بل هو مرهون أيضًا بالفئات المهنية التي ينتمي إليها الأفراد. ولكنْ، تلعب بعض الخصائص الأخرى دورًا في الوصول إلى الوظائف «المحميَّة»، أو الاستبعاد منها. إذا ألقينا نظرة سريعة على سوق العمل اللبناني، يتبيّن لنا أنَّ الفئات المهنية المُستبعَدة من برامج الضمان الاجتماعي هي فئات ترتبط باعتبارات جندرية وإثنية، وترجح فيها كفّة الأفراد ذوي المهارات المتدنّية و/أو ذوي المدخول المنخفض. فالعمل المنزلي بغالبيته (ومنذ فترة طويلة) هو مجال يطغى عليه الطابع الجندري والإثني كونه يتألّف بشكلٍ أساسي من عاملات سوريات ومصريات وكرديات وفلسطينيات قبل توافد العاملات من جنوب شرق آسيا في مطلع الألفية، ومن الدول الأفريقية جنوب الصحراء لاحقًا (جريديني 2009). فضلًا عن ذلك، تخضع العاملات المنزليات الأجنبيات لنظام الكفالة الذي يربط تصريح الإقامة ورخصة العمل بالكفيل، ما يُعيق قدرة العاملة على التحرّك والتنقّل ضمن سوق العمل والاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي. يعمل عدد كبير من السوريين/ات في القطاع الزراعي، في حين تدفع بهم/هنّ القيود المفروضة على الفلسطينيين والسوريين للتوجّه إلى قطاع العمل غير النظامي. نتيجةً لذلك، تتقاطع عوامل عدّة، مثل النوع الاجتماعي والهوية الإثنية، والإقامة والعمل أيضًا، بطرق مختلفة وتؤدّي إلى استبعاد الأفراد من آليات الضمان الاجتماعي.
يُعتبَر ذلك برهانًا على أنَّ الإدماج والإقصاء من الحماية الاجتماعية يتبع أنماطًا متداخلة لا يُمكن فهمها من منظور العمل وحده. فالهويات الاجتماعية، مثل الهوية الإثنية والنوع الاجتماعي والطبقة الاجتماعية وغيرها، يجب أن تؤخذ بالاعتبار ضمن إطار واحد لفهم آليات الإقصاء من الحماية الاجتماعية. إذًا، وكما سنُبيِّن أدناه، يسمح لنا إطار التقاطع (كرينشو 1991) بالتفكير في آليات الإقصاء هذه من منطلق تقاطعها مع خصائص وهويات اجتماعية مختلفة، مثل الطبقة الاجتماعية أو النوع الاجتماعي أو العرق أو الجنسية أو الهوية الإثنية أو وضع الإقامة أو الوضع الوظيفي، بالإضافة إلى السنّ و/أو الإعاقة أيضًا.
تقييم الثغرات المتقاطعة في نظام الحماية الاجتماعية اللبناني
يستند نظام الحماية الاجتماعية حاليًا إلى نظامٍ مُشتَّت قائم على الاشتراكات والمساعدة الاجتماعية الظرفية والمؤقّتة والمُخصَّصة للمجموعات السكّانية الهشّة، وصدرت حوله دراسات تحليلية كثيرة منها، على سبيل المثال لا الحصر، الدراسات التقنية. وفقًا للبيانات المتوفّرة المتعلّقة بفترة ما قبل الأزمة (2018)، 1 من أصل كلّ 3 مواطنين/ات لبنانيين/ات بالإجمال (ما يوازي 34,3%) مُستبعَد(ة) تمامًا من نظام الحماية الاجتماعية (منظّمة العمل الدولية 2021، 10)، في حين أنَّ النصف تقريبًا (52,8%) من المجموعة السكّانية غير اللبنانية (التي شملها مسح منظّمة العمل الدولية نفسه) لا يستفيد من أيّ نوع من أنواع تقديمات الحماية الاجتماعية (المرجع نفسه، 14).
في هذا السياق، تُقدِّر منظّمة العمل الدولية أنَّ 1,2 مليون عامل(ـة) (من أصل 2,1 مليون نسمة من السكّان الناشطين/ات اقتصاديًا) كانوا غير مضمونين قبل أزمة 2019. وغالبية العمّال المضمونين كانوا يعملون ضمن شركات كبيرة وهم من الجنسية اللبنانية. كما أنَّ 80% من العاملين/ات اللبنانيين/ات في الشركات الكبرى يستفيدون من الضمان، مقابل 31% فقط من العمّال غير اللبنانيين في شركات من الحجم نفسه. وفي الشركات التي تضمّ أقلّ من 5 موظّفين/ات، 67,7% من الموظّفين/ات الذين يتقاضون رواتب شهرية كانوا غير مضمونين (منظّمة العمل الدولية 2021، 7). وكمعدّل وسطي، ضمن عيّنة العمّال غير النظاميين الذين شملهم مسح منظّمة العمل الدولية، 1,7% فقط منهم كانوا مضمونين، مقابل 50,4% في سياق العمالة النظامية، وهي نسبة تُشكّل فرقًا شاسعًا.
ولا شكَّ في أنَّ هذه الأرقام قد تفاقمت بشكلٍ فادح مع تدهور الوضع الاقتصادي خلال السنتَيْن الماضيتَيْن، في ظلّ إغلاق الكثير من الشركات وصرف عدد كبير من العمّال، بالإضافة إلى الاقتطاعات التعسُّفية من الأجور أو تعليقها بشكلٍ مؤقّت (ديراني 2021).
يرتبط فشل نظام الحماية الاجتماعية بشكلٍ وثيق بهيكليته القائمة على العمالة. وترتبط برامج الضمان الاجتماعي بالعمالة النظامية في بلدٍ حيث تُشير التقديرات قبل الأزمة أنَّ العمالة «غير النظامية» تُشكِّل بين 55% (منظّمة العمل الدولية وإدارة الإحصاء المركزي 2018/2019) و66% (البنك الدولي 2011) من إجمالي معدَّل العمالة، في حين يُمثّل القطاع غير النظامي المزعوم 36% من الناتج المحلّي الإجمالي (البنك الدولي 2011) ويستأثر بـ65% من القطاع المُنتج (منظّمة العمل الدولية وإدارة الإحصاء المركزي 2018/2019).
ولكنْ، إلى جانب الهيكلية القائمة على العمالة، يمكن لأنماط التمييز المتقاطعة المرتبطة بالطبقة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والهوية الإثنية أن تُساعِد على تفسير الثغرات المنهجية في نظام الحماية الاجتماعية اللبناني.
وكما ظهرَ في التقييم الصادر عن منظّمة العمل الدولية حول مكامن الضعف والثغرات في الحماية الاجتماعية، فإنَّ التقديمات التي تحصل عليها الشريحة الأكثر ثراءً في العيّنة التي شملتها دراسة المنظّمة هي أعلى بـ100 ضعف مقارنةً بالتقديمات التي تحصل عليها الشريحة السفلى (الأكثر فقرًا):لا تُحدَّد فعّالية الحماية الاجتماعية بنسبة التغطية فحسب، بل ترتبط أيضًا بحجم التأثير الذي تُحقّقه. فغالبية الفئات الهشّة إجمالًا - أي التي لديها دخل منخفض - هي الأقلّ استفادةً من برامج الضمان الاجتماعي القائمة حاليًا. وفي الأنظمة القائمة على الاشتراكات فعليًا، تُوزَّع التقديمات بشكلٍ متناسب مع الدخل عمومًا. تُشكِّل التقديمات القائمة على الاشتراكات الجزء الأكبر من تغطية الضمان الاجتماعي في لبنان. بالتالي، يُعزِّز النظام الحالي عدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية نتيجة ارتباطه بالدخل الفردي، أي بالقدرة الفردية على الاشتراك والانتساب. باختصار، يستبعِد هذا النظام الأفراد غير القادرين على الاشتراك في برامج الضمان الاجتماعي. ونتيجةً لذلك، يفشل هذا النظام إلى حدّ كبير في حماية أغلبية الفئات الهشّة، ما يزيد من ديناميات الإقصاء على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع اللبناني.
«ما يزيد عن 90% من إجمالي التقديمات الموزَّعة عبر برامج الحماية الاجتماعية مؤلّفة من تقديمات مُموَّلة بواسطة الاشتراكات مثل المعاش التقاعدي والتأمين الصحّي، وأكثر من 70% من المنتسبين/ات إلى برامج التأمين الاجتماعي ينتمون إلى النصف الأعلى من سُلَّم المداخيل» (منظّمة العمل الدولية 2021، 14).
وهذا يعني أنَّ أكثر من 60% من مجمل تقديمات الحماية الاجتماعية (باستثناء التأمين الخاصّ) ذهبَ لأفرادٍ ينتمون إلى الشريحة الأكثر ثراءً ضمن العيّنة التي شملَها بحث منظّمة العمل الدولية.
كما أشرنا أعلاه، إنَّ مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأُسَر (LFHLCS) لعامَيْ 2018-2019، الصادر عن منظّمة العمل الدولية وإدارة الإحصاء المركزي، والذي يستند إليه تقييم منظّمة العمل الدولية بشأن مكامن الضعف والثغرات في الحماية الاجتماعية الذي ذكرناه، لا يأخذ بالاعتبار «المساكن غير الرسمية» (أي مخيّمات اللاجئين والأماكن غير الرسمية)، ولا يشمل العاملات الأجنبيات في المنازل (منظّمة العمل الدولية 2021، 14). فيبدو بالتالي أنَّ البيانات المتوفّرة قبل الأزمات لا تعكس بشكل دقيق واقع الحماية الاجتماعية واحتياجات المجموعات السكّانية غير اللبنانية، خاصّةً الذين يعيشون في المخيّمات، بالإضافة إلى المجموعات السكّانية اللبنانية وغير الموثَّقة، مثل الدومريين الذين يسكنون ضمن أماكن غير رسمية. فإذًا، لا يوفّر هذا المسح سوى جزء بسيط جدًا من المعلومات المتعلّقة بالوصول إلى الحماية الاجتماعية لبعضٍ من أكثر الفئات هشاشةً في البلد. وتشهد هذه المجموعات نفسها اليوم المزيد من الإفقار المُدقع في ظلّ الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان منذ خريف 2019.
الطبقة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والهوية الإثنية
رغم ذلك، إنَّ البيانات الجزئية المُجمَّعة من خلال مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأُسَر (LFHLCS) لعامَيْ 2018-2019، الصادر عن منظّمة العمل الدولية وإدارة الإحصاء المركزي، تُشير إلى العلاقة المتقاطعة بين الطبقة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والهوية الإثنية. ويُشير تقرير التقييم الصادر عن منظّمة العمل الدولية (2021) إلى أنَّ نسبة عدم المساواة بين الجنسَيْن أعلى لدى الُأسَر غير اللبنانية ذات الدخل المنخفض التي تعيش ضمن أماكن سكنية. وبالمقارنة النسبية مع مجموع العيّنة، تنتمي 67,2% من النساء إلى أقلّ فئتَيْن من فئات الدخل الخماسية، مقابل 59,8% من الرجال. أمّا على صعيد الأُسَر اللبنانية، يبدو الرابط بين الفقر والنوع الاجتماعي متساويًا. في الواقع، ضمن العيّنة اللبنانية، ينتمي 22,7% من الرجال إلى أقلّ فئتَيْن من الفئات الخماسية، مقابل 23,5% للنساء (منظّمة العمل الدولية 2021، 3).
وبالنسبة إلى الأُسَر غير اللبنانية ذات الدخل المنخفض والمنخفض جدًا (أي الجزء الأكبر من السكّان غير اللبنانيين)، تُمثّل التدخّلات الإنسانية وبرامج شبكات الأمان المصدر الرئيسي للحماية الاجتماعية.
ولكنْ، كما يُشير تقرير منظّمة العمل الدولية المذكور سابقًا، فإنَّ الأُسَر التي لا تضمّ أيّ عاملين/ات تحصل على فُرَص أكبر للاستفادة من تقديمات البرامج الصحّية التابعة لمفوّضية اللاجئين وغيرها من وكالات الأمم المتّحدة والمنظّمات غير الحكومية (منظّمة العمل الدولية 2021، 16)، مقارنةً بالأُسَر الأخرى. بالتالي، تقلّ فُرَص استفادة كلّ العمّال غير اللبنانيين وغير النظاميين تقريبًا من برامج الحماية الاجتماعية التي تُقدّمها مفوّضية اللاجئين أو الأمم المتّحدة أو المنظّمات غير الحكومية إذا صرّحوا أنّهم يعملون (في القطاع غير النظامي). وهذا يُفسّر، من بين أمور أخرى، التحايُل والاستراتيجيات التي تلجأ إليها هذه الفئات الثانوية خلال المقابلات والاستطلاعات لإخفاء وقائع حياتها وظروفها الاجتماعية والمهنية في محاولةٍ للالتفاف على معايير الأهلية التي تفرضها المنظّمات، ولتتمكّن من الوصول إلى الموارد المحدودة المُقدَّمة من المنظّمات الدولية وغير الحكومية. وهذه الروايات المحبوكة والمدروسة التي تقدّمها المجموعات الفرعية للوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي والمساعدات الإنسانية يمكن أن تُفهَم في إطار «اقتصاد الكذب الأخلاقي» (بينيدوتشي 2015؛ مارانكوني وكرباج-حريري 2017). هنا، يُشكِّل الكذب ممارسة «شرعية» طالما أنّه، على ما يبدو، الطريقة الوحيدة للحصول على أشكال الحماية الاجتماعية التي تشتدّ الحاجة إليها والتي لا يمكن الوصول إليها بخلاف ذلك.
تساؤلات حول المقاربات التي تستهدف "الفقراء"
تشكو شبكات الأمان من عدّة قيود وثغرات، أوّلها القيود والثغرات النظرية. في الواقع، لا تنظر شبكات الأمان إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًّا من حقوق الإنسان، بل تُركِّز على الاستجابة للفقر من منظورٍ «طارئ» وليس من منظور هيكلي. فضلًا عن ذلك، يتمّ تمويلها في معظم الأحيان من خلال تدخّلات محدودة زمنيًا من الجهات المانحة الخارجية، كما هو الحال بالنسبة لبرامج شبكات الأمان الرئيسية في لبنان، وهما: البرنامج الوطني لدعم الأُسَر الأكثر فقرًا (NPTP) المدعوم من البنك الدولي، وشبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ (ESSN) المُموَّلة من البنك الدولي والاتّحاد الأوروبي. وتَبيَّن أيضًا أنَّ نطاق شبكات الأمان محدود جدًا (كما ذكرنا سابقًا، وصلَ البرنامج الوطني لدعم الأُسَر الأكثر فقرًا في آذار/مارس 2021 إلى ما يُقارِب 1,5% من سكّان لبنان)، كما أنَّ هامش الخطأ فيها مرتفع جدًا، بسبب معايير الإقصاء والإدماج. فبرامج الأمان الاجتماعي لا تستهدف سوى «المجموعات السكّانية الأكثر حرمانًا»، وذلك بسبب محدودية الموارد، ما يؤدّي إلى تقسيم هيكلي لأشكال الفقر والمعاناة البشرية وفقًا لتسلسلٍ هرميّ. على سبيل المثال، يعطي برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ (ESSN) الأولوية للأُسَر التي تضمّ الأطفال وذوي الإعاقات الشديدة والكبار في السّن (فوق 70 عامًا) وتلك التي تُعيلها نساء. بالتالي، تُستثنى الأُسَر التي تتضمّن أفرادًا بلغوا سنّ التقاعد (64 عامًا) أو الأُسَر التي تضمّ أفرادًا يعانون من إعاقات لا تُصنَّف كإعاقات «حادّة»، وغيرها من الحالات الكثيرة. والأهمّ أنَّ استهداف برامج شبكات الأمان للمجموعات السكّانية اللاجئة قد يزيد من التوتُّرات الاجتماعية بين المجتمعات المضيفة واللاجئة المتساوية في الفقر. في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ، غالبًا ما تُساهِم الأزمات الناشئة في تهميش المجموعات السكّانية المحتاجة الأخرى، كما حصلَ بالنسبة للمجتمع الفلسطيني في لبنان. وكما أشارَ منتدى المنظّمات غير الحكومية الدولية الإنسانية في لبنان (LHIF)، تمّ توقيف برنامج شبكة الأمان الاجتماعي (SSNP) للّاجئين/ات الفلسطينيين/ات في لبنان منذ ستّة أعوام، بالتزامن مع اندلاع الأزمة السورية (منتدى المنظّمات غير الحكومية الدولية الإنسانية في لبنان 2021). وخلال أزمة العام 2019، صدرت تقارير أعادت تقييم احتياجات المجموعات السكّانية الهشّة، لكنَّ نسبةً قليلة منها سلّطت الضوء على الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين (منتدى المنظّمات غير الحكومية الدولية الإنسانية في لبنان 2021، 9). علاوةً على ذلك، خفَّضَت الجهات المانحة الدولية مساهمتها في تمويل «وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأنروا) بشكلٍ ملحوظ. على سبيل المثال،، في مطلع العام 2020 وفي موازاة اتّفاق التطبيع بين الإمارات العربية المتّحدة وإسرائيل بدعمٍ أميركي (ما يُسمّى بـ«اتّفاق أبراهام»)، أوقفت دولة الإمارات تمويلَها للأنروا؛ وهذا دليلٌ على أنَّ البرامج المُخصَّصة لغايات محدّدة قد تتأثّر أيضًا بالأولويات والترتيبات الجيو-سياسية (منتدى المنظّمات غير الحكومية الدولية الإنسانية في لبنان 2021، 16، الملاحظة رقم 13).
إضافةً إلى ذلك، يبقى أثر شبكات الأمان محدودًا على المستفيدين/ات على أرض الواقع. وتُظهِر البيانات أنَّ المدخول الإضافي الذي تُقدِّمه للمستفيدين/ات لا يتعدّى 0.5% في لبنان (منظّمة العمل الدولية 2021، 12). كما أنَّ نسبة قليلة جدًا من الأفراد الأكثر هشاشةً يمكنهم/هنّ الوصول إلى المساعدات غير القائمة على الاشتراكات وفقًا للبيانات المتوفّرة من فترة ما قبل 2019. وبتعبيرٍ أدقّ، 62,3% من المجموعات السكّانية الأكثر هشاشةً لا تتلقّى أيّ مساعدات؛ و33% يتلقّون المساعدات القائمة على الاشتراكات؛ بينما 6,8% يتلقّون المساعدات غير القائمة على الاشتراكات، الصادرة عن برامج شبكات الأمان الاجتماعي.
بالتالي، إنَّ تجزئة نظام الحماية الاجتماعية والاعتماد على استراتيجيات التخفيف من الفقر مع أثرها الاجتماعي المحدود؛ كلّها عوامل تؤدّي إلى تفاقم ظاهرة عدم المساواة في المجتمع: أوّلًا، عبر توفير أشكال أفضل من الحماية للأفراد القادرين على الاشتراك في برامج الضمان الاجتماعي من خلال وظيفتهم أو عملهم؛ وثانيًا، عبر تهميش الأفراد غير القادرين على إيجاد - أو ممارسة - الوظائف النظامية. وفي الوقت نفسه، تكشف هذه التجزئة عن أنماط راسخة من التمييز على أساس عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية. وأولئك الذين لا يستفيدون إلّا بالقليل من نظام (أو أنظمة) الحماية الاجتماعية المتفكّكة في البلد هم بأمسّ الحاجة إليها في نهاية المطاف: أي الفئات الهشّة المعرّضة لأشكال مختلفة، وأحيانًا متداخلة، من التمييز، بينهم اللاجئين/ات وغيرهم من السكّان غير اللبنانيين/ات، ولكنْ أيضًا النساء والمسنّين وذوي الإعاقات، فضلًا عن العاملين/ات اللبنانيين/ات وغير اللبنانيين/ات في القطاع غير النظامي.
التسلسل الهرمي على أساس الجنسية
بين الأشخاص المستفيدين/ات من برامج الضمان الاجتماعي عبر العمل النظامي، تختلف التقديمات تبعًا للانتماءات الوطنية والإثنية.
وكما أشارَت جواد وآخرون:
«إنَّ برامج الرعاية الاجتماعية ليست مجرّد أنظمة لتقديم الخدمات، بل تعكس أيضًا التوجّهات السياسية والثقافية والمؤسّسية التي تحمل أهميةً سياسية على نطاقٍ أوسع بالنسبة للهوية الوطنية والانتماء، وإعادة توزيع الثروات، والتصوّرات الذاتية حول الرفاه الشخصي» (جواد وآخرون 2019، 1).
بالتالي فإنَّ أنماط التمييز المتقاطعة تطال أيضًا الأفراد الذين يعملون في الإطار النظامي ويحصلون على الضمان الاجتماعي.
وهنا يبرز التسلسل الهرمي للمُواطَنة والهويات الإثنية. فالمواطنون/ات الذين يحملون الجنسية البلجيكية والفرنسية والإيطالية والبريطانية يستطيعون الاستفادة من كلّ تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يسري عليهم/هنّ شرط المعاملة بالمثل في دولهم تجاه اللبنانيين. في المقابل، يقدّم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصولًا غير متساوٍ إلى برامج الضمان الاجتماعي للعاملين/ات اللبنانيين/ات وغير اللبنانيين/ات في القطاع النظامي، ما يعكس تفاوتًا اجتماعيًا كبيرًا على أساس الجنسية والهوية الإثنية، وبالأخصّ تجاه الفلسطينيين/ات الذين تمّ إقصاؤهم/هنّ مباشرةً من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظلّ غياب دولة نظيرة للدولة اللبنانية، وعدم التمكُّن بالتالي من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. تمّ تعديل قانون العمل (المادّة 59) وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادّة 9) على التوالي في 1995 و2005 و2010 بهدف السماح للعاملين/ات الفلسطينيين/ات في القطاع النظامي بالحصول على تقديمات الصندوق (أبي ياغي 2014). ولكنْ، رغم إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل للفلسطينيين/ات، لم تشمل التعديلات الحقّ في الحصول على ضمان الأمومة والمخصّصات العائلية. لذلك، لا يستفيد الفلسطينيون/ات حتّى اليوم سوى من تعويضات نهاية الخدمة. ولكنَّ العديد من العوائق بحكم الواقع تَحول دون حصول الفلسطينيين/ات على عقود العمل، ما يمنعهم من اكتساب صفة العمل النظامي والاستفادة من المخصّصات المرتبطة بالعمل (طرّاف-نجيب 2005؛ الناطور 1993). يبرز ذلك من خلال التحرّك الاجتماعي للعمّال الفلسطينيين/ات وعائلاتهم/هنّ، الذي بدأ قبل بضعة أشهر من تحرُّك 17 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، حيث عبّر الفلسطينيون/ات تحديدًا عن المطالب المرتبطة بالعمل. وخلال ما سُمِّيَ بـ«جمعة الغضب» (الأخبار، 20 تمّوز/يوليو 2019)، طالبوا بالدرجة الأولى بحقّهم/هنّ في دخول سوق العمل النظامي.
يمكن ملاحظة ديناميّات مشابهة عند تحليل الوصول غير المتساوي للّاجئين/ات السوريين/ات إلى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب غيرهم من «اللّاجئين/ات المنسيين/ات» (السعدي، 25 آب/أغسطس 2021) مثل اللّاجئين/ات العراقيين/ات واليمنيين/ات. فجميعهم يُواجِهون عراقيل عملية واجتماعية تمنعهم من دخول سوق العمل النظامي، ولا يحصلون على تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالعمّال اللبنانيين. وفي الواقع، لا يحقّ لجميع العمّال الأجانب النظاميين إلّا بالاستفادة من تعويضات نهاية الخدمة، باستثناء الجنسيات الأوروبية الأربع التي ذُكرت سابقًا. وتجدر الإشارة كذلك أنَّه رغم حصولهم على تعويضات نهاية الخدمة فقط لا غير، لا يزال يتوجّب عليهم وعلى أرباب عملهم تسديد الاشتراك المالي نفسه الذي يدفعه العمّال اللبنانيون النظاميون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (25,5% من الراتب، لا يُخصَّص منها سوى نصفها تقريبًا لتغطية تعويضات نهاية الخدمة). وهذا يعني أنَّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستفيد من اشتراكات العاملين/ات غير اللبنانيين/ات (في حال تمكّن هؤلاء من الوصول إلى قطاع العمل النظامي، وهو أمر نادرًا ما يحصل). لكنَّ القاسم المشترك بين العاملين/ات اللبنانيين/ات وغير اللبنانيين/ات في القطاع الرسمي النظامي هو محدودية تعويض نهاية الخدمة، إذا ما تمكّنوا من الحصول عليه: فهو بالكاد يوازي راتب ثلاثة سنوات لعاملٍ يستطيع أن يبرهن عن عملٍ متواصل لمدّة 45 سنة (مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية 2020).
الأشخاص ذوو الإعاقة
يُشكِّل الأشخاص ذوو الإعاقة مثالًا نموذجيًا عن عدم قدرة النظام الحالي للحماية الاجتماعية في لبنان على توفير الحماية اللازمة. فالأشخاص ذوو الإعاقة، الذين لا يمكنهم الحصول على عمل من خلال نظام الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات، يُستهدَفون عبر برامج شبكات الأمان التي تُقدِّم المساعدة الاجتماعية والتي تَبيَّنَ أنَّها غير كافية كونها لا تُتيح سوى زيادة ضئيلة على الدخل (0,4% بحسب تقديرات منظّمة العمل الدولية [منظّمة العمل الدولية 2021، 12]). بالإضافة إلى ذلك، 60% فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة، أي ما يساوي 103,262 شخصًا (اليونيسيف ووزارة الشؤون الاجتماعية 2019، 8)، يتلقّون أجهزة مُساعِدة ويحصلون على إعفاء من الرسوم عبر برنامج المساعدة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة (منظّمة العمل الدولية واليونيسيف 2021، 9).
تجدر الإشارة أنّه نتيجة الأزمة الحالية، تَبيَّنَ (وفقًا لصحيفة لوريان لوجور) أنَّ المدرسة الخاصّة «الوحيدة» للأطفال المصابين بالتوحُّد في لبنان، أي مدرسة «One Two Three Autism School» في الضبيّة، قد اضطُرَّت لإقفال أبوابها في أيلول/سبتمبر 2021 بسبب الضائقة المالية (لوريان لوجور، 9 حزيران/يونيو 2021).
الاتّجاهات الحالية: تراجُع المكانة الاجتماعية لموظّفي/ات القطاع العام ذوي «الامتيازات»
أثّرت الأزمة الحالية على آليات نظام الحماية الاجتماعية بشكلٍ فادح ومتفاوت على مختلف الفئات الاجتماعية. بحسب البنك الدولي، انخفضَ الناتج المحلّي الإجمالي بصورة ملحوظة، من 55 مليون دولار عام 2018 إلى 20,5 مليون دولار عام 2021، في حين بلغَ التضخُّم 131,9% خلال الأشهر الستّة الأولى من سنة 2021. وفي ظلّ السياق المتقلّب الذي يشهد أسعار صرف متعدّدة وتقديمات اجتماعية متفاوتة، تُقدَّم المخصّصات والمدفوعات من قِبَل الجهات الضامنة الخاصّة والعامّة وفقًا لقيمة العملة وسعر الصرف الذي كانَ مُعتمَدًا أثناء إبرام عقد التأمين. وما يعنيه ذلك عمليًا هو أنَّ غالبية المستشفيات العامّة والخاصّة مثلًا لا تقبل الدفعات من المؤسّسات العامّة للضمان الاجتماعي (أي تعاونية موظّفي الدولة وصناديق الجيش والقوى الأمنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) لأنَّها تدفع مخصّصات الضمان الاجتماعي وفقًا لسعر الصرف الرسمي، أي 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، في حين أنَّ سعر الصرف في «السوق السوداء» تخطّى عتبة الـ20,000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. ونتيجةً لذلك، يطلب العديد من المستشفيات من موظّفي/ات القطاع العام والمتقاعدين/ات إيداع مبالغ طائلة من المال (مقارنةً برواتبهم/هنّ) للقبول بإدخالهم/هنّ إلى المستشفى في الحالات الطارئة والحصول على العلاج. بالتالي، فإنَّ الأشخاص القادرين على تسديد تكاليف التأمين الخاصّ، بالدولار ونقدًا، يحصلون على تغطية أفضل من تلك التي يقدّمها الضمان الاجتماعي العمومي.
يبرز بالتالي اتّجاهان: أوّلًا: تراجُع المكانة الاجتماعية للأفراد الذين كانوا من ذوي «الامتيازات» سابقًا، أي موظّفي/ات القطاع العام الرسمي، الذين يخرجون تدريجيًا من الطبقة الوسطى للانتقال إلى الطبقات المتدنّية في المجتمع. ثانيًا: تزداد وتترسّخ أوجه عدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية. وفي هذا السياق، تلعب الواسطة دورًا رئيسيًا إذ تسمح للأفراد بالحصول على خدمات يتعذّر الوصول إليها بأيّ طريقة أخرى، إلى جانب إعادة تشكيل الانتماءات المذهبية والزبائنية، التي وُضِعَت تحت المجهر خلال التحرُّك الشعبي عام 2019.
وحتّى قبل الأزمات المتعدّدة خلال السنتَيْن الماضيتَيْن، كانت الأحزاب السياسية الطائفية تُقدِّم عددًا كبيرًا من الخدمات، إمّا بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وخصوصًا من خلال الرعاية الصحّية.
«في العام 2006، ومن أصل 160 مستشفى، كانَ هناك 5 فقط تُديرها الحكومة [...]. وفي المقابل، 71% من ميزانية وزارة الصحّة العامّة مُخصَّصة للاستشفاء، وأغلبية المستشفيات، التابعة لمذاهب معيّنة، متعاقدة مع الوزارة [...]، ما يعني أنَّ الجزء الأكبر من ميزانية وزارة الصحّة العامّة يُصرَف على مقدّمي الرعاية من القطاع الخاصّ، أيْ المستشفيات التابعة للمذاهب بشكل أساسي. إضافةً إلى ذلك، يعمد هؤلاء إلى زيادة الأسعار ووصف عدّة أدوية للمرضى الذين تُغطّيهم وزارة الصحّة، [...] من أجل مضاعفة أرباحهم. فضلًا عن ذلك، ارتفعت أقساط التأمين بين عامَي 1991 و2000 من 57 مليون دولار إلى 355 مليون دولار، مع ارتباط جزء كبير منها بأُسَر الطبقة الحاكمة، التي تملك أيضًا وكالات استيراد حصرية للأدوية، وفقًا لفوّاز طرابلسي.» (عبدو 2014، 16).
ولا تزال الأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية تُدير الكثير من المستشفيات حتّى يومنا هذا، وتُقدِّم خدماتها تحت راية العمل الخيري، في حين أنَّها قائمة فعليًا على أساس الزبائنية. بمعنى آخر، أنشأت الرعاية الطائفية أُسُس «الزبائنية التقليدية» الفعلية (كاميت وإيسار 2010) المؤلَّفة من مستشفيات وجمعيات خيرية من تأسيس الأحزاب وبإدارتها، وجزء كبير منها مُموَّل من النفقات العامّة.
الخلاصة
إنَّ النظام المُستوحى من النزعة «البسماركية» يستثني بشكلٍ منهجي شرائح مهمّة من السكّان ويحرمهم من الحماية، نتيجة عدّة عوامل: سوق العمل الذي يطغى عليه الطابع غير النظامي، والأحكام الإقصائية في قانون العمل، ووجود يد عاملة أجنبية بأعداد كبيرة. وقد ساهمَ ذلك بتعزيز ثلاث ديناميّات على الأقلّ: أوّلًا، نشوء حالة من «الهشاشة الاجتماعية» و«انعدام الأمن الاجتماعي» بشكل هيكلي ومتقاطع (كاستيل 1995، 2003) عبر إقصاء قسم كبير من السكّان اللبنانيين وغير اللبنانيين من أيّ شكل من أشكال الحماية الرسمية المرتبطة بالعمل. ثانيًا، إنشاء أحكام عامّة مخصّصة، وتدخُّلات المنظّمات الدولية والمنظّمات غير الحكومية الإنسانية التي تستند إلى مقاربة يتمّ تفعيلها في حالات الطوارئ وتستهدف الفقراء، في محاولةٍ لتلبية احتياجات الأفراد والمجموعات السكّانية الأكثر هشاشةً. ثالثًا، بروز شبكات غير رسمية من الحماية، والرعاية الطائفية، وتقسيم الموارد على أساس زبائني، التي أصبحت عنصرًا هيكليًا، بدلًا من أن تكون خللًا، في نظام الحماية الاجتماعية اللبناني. في الختام، يُشير هذا الموجز إلى أنَّ برامج الحماية الاجتماعية تُشكّل مدماكًا أساسيًا للعدالة الاجتماعية في أيّ مجتمع، لكنَّ ذريعة عدم فعّاليتها و/أو استغلالها، تُستخدَم، ولطالما استُخدِمَت، كوسيلة للارتقاء بأجندات الأحزاب السياسية في السياق اللبناني.
التوصيات
أثبت النظام الحالي للحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات أنَّه غير قادر على تأمين الحماية للبناني واحد/لبنانية واحدة على الأقلّ (1) من أصل كلّ 3 لبنانيين، ومواطن واحد غير لبناني/مواطنة واحدة غير لبنانية (1) من أصل كلّ مواطنَيْن غير لبنانيَّيْن (2)، في ظلّ تفاقم أوجه عدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية والتمييز المتعدّد الجوانب على أساس النوع الاجتماعي أو الأصل العرقي أو الإعاقة. وتَبيَّنَ أنَّ نطاق شبكات الأمان الاجتماعي محدودٌ كما أنَّها لا تُقدِّم سوى حماية محدودة للفئات الأكثر حرمانًا. علاوةً على ذلك، ترتكز هذه الشبكات على نهج المساعدة في حالات الطوارئ بدلًا من النهج القائم على حقوق الإنسان، وبالتالي لا تُعالِج الأسباب الهيكلية لظاهرة عدم المساواة والفقر. ويبدو أنَّها تعتمد على دعم الجهات المانحة الخارجية وترتبط بالمشاكل السياسية والاقتصادية التي ما زالت تُعرقل تنفيذها حتّى اليوم.
إذًا، تُشير كلّ نتائج الأبحاث إلى أهمية اتّخاذ الإجراءات على مستوى الدولة، كونها الجهة الرئيسية المُكلَّفة بواجب حماية المواطنين/ات اللبنانيين/ات والسكّان غير اللبنانيين/ات المقيمين/ات في البلد. يجب تنفيذ خطّة شاملة وموحَّدة للضمان الاجتماعي، كركيزة للسياسة الاجتماعية القائمة على الحقوق في البلد، لتأمين الحماية ضدّ الأزمات والصدمات على المدى القريب، وتوفير الرخاء والازدهار على المدى البعيد. فنظام الضمان الاجتماعي هذا يفصل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن القدرة على الدخول إلى سوق العمل النظامي، وهو مُصمَّم ليكون متعدّد المستويات ومُموَّلًا بالضرائب، إلى جانب برامج قائمة على الاشتراكات تكفل حصول الجميع على التقديمات، فضلًا عن المساعدة الاجتماعية الموجّهة والمُستهدَفة.
التوصيات الخاصّة بالدولة اللبنانية:
- وضع إطار شامل ووطني للضمان الاجتماعي، بالتعاون مع النقابات والمجموعات العمّالية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وغيرهم من الجهات المعنيّة. ويجب أن يتضمّن ذلك إصلاحًا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تأمين التغطية الشاملة ومعاشات التقاعد ومخصّصات البطالة.
- تشكيل هيئة وطنية موحَّدة لتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، بمشاركة الوزارات والإدارات العامّة والمنظّمات المعنيّة.
- إصلاح قوانين العمل التنظيمية تماشيًا مع الاتّفاقيات الدولية التي تنصّ على إدماج جميع الفئات العمّالية، والحرص على تمكينها من تنظيم صفوفها والمشاركة في الإصلاحات السياساتية.
-
ينبغي أن تشمل عملية إصلاح قانون العمل: 1) إلغاء المادّة 7 التي تستثني العاملين/ات في الزراعة، والعاملين/ات في الخدمة المنزلية، والمياومين/ات في القطاع العام من الأنظمة القانونية ومن الانتساب إلى برامج الضمان الاجتماعي؛ 2) إلغاء المادّة 86 التي تُخضِع إنشاء النقابات العمّالية للموافقة الوزارية؛ 3) تعديل المادّتَيْن 91 و92 بشأن مشاركة الأجانب بشكل كامل وتمثيلهم/هنّ ضمن النقابات العمّالية.
-
إلغاء التحفُّظات بشأن الفلسطينيين/ات والسوريين/ات التي تُحدِّد القطاعات والمِهَن التي يمكنهم/هنّ العمل فيها.
-
إلغاء سياسات الإقامة المرتبطة بالعمل، وتحديدًا نظام الكفالة الذي يربط العامل(ـة) الأجنبي(ـة) بربّ عمل واحد، ما يحدّ من قدرته(ـا) على التنقُّل الحرّ في سوق العمل ويشجّع مختلف أشكال التمييز والاستغلال ضدّ العمّال الأجانب، وبالأخصّ، على سبيل المثال لا الحصر، العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية.
التوصيات الخاصّة بالجهات المانحة والمنظّمات غير الحكومية الدولية:
- دعم الدولة اللبنانية في عملية إصلاح السياسات من أجل توحيد البرامج الإقصائية والمجزَّأة القائمة حاليًا وتحويلها إلى برنامج شامل ومُوحَّد يؤمّن الحماية الاجتماعية للجميع.
- توجيه السياسات والبرامج والتمويل نحو إصلاحات سياساتية هيكلية ترتكز على الحقوق الاجتماعية بدلًا من تقديم الخدمات بشكل مُجزَّأ ومُشتَّت.
- الالتزام بالشفافية الكاملة لدى تخصيص وتوزيع التمويل إلى الدولة اللبنانية أو وزاراتها أو المؤسّسات الخيرية وقطاع الجمعيات، ورفع التقارير عن هذا التمويل فيما يخصّ البرامج والتدخّلات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي.
- الحرص على أن تكون المسارات الاستشارية قائمة على المشاركة الفعّالة والفعليّة، ويُتاح فيها المجال للتعبير عن أولويات واحتياجات الجهات الفاعلة في القطاعَيْن العمّالي والمدني.
التوصيات الخاصّة بالمجتمع المدني:
- استعادة جهود المناصرة وكسب التأييد، والمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتحديدًا الوصول إلى الضمان الاجتماعي، بشكلٍ يتكامل مع الخدمات الاجتماعية التي يقدّمها هذا القطاع.
- المناصرة وكسب التأييد في سبيل وضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تُخفِّف من تداعيات الأزمات الحالية المتراكمة وتسعى إلى تطبيق برنامج شامل للضمان الاجتماعي على المدى البعيد.
قائمة المراجع
المُؤلَّفات
Al-Boueiri, Élias. 1986. تاريخ الحركة النقابية في لبنان. Beirut: Dar Al-Farabi.
Abdo, Nabil. 2014. “Social protection in Lebanon: From a System of Privileges to a System of Rights.” Beirut: Arab NGO Network for Development.
AbiYaghi, Marie-Noëlle. 2014. “لبنان والحماية الاجتماعية: ما بين الإحسان والسياسة.” تقرير الراصد العربي (Report of the Arab Monitor). Beirut: Arab NGO Network for Development.
AbiYaghi, Marie-Noëlle, and Myriam Catusse. 2011. “’Non à l'État holding, oui à l'État providence !’ Logiques et contraintes des mobilisations sociales dans le Liban de l'après-guerre.” Revue Tiers Monde. HS (5): 67.
AbiYaghi, Marie-Noëlle, and Léa Yammine. 2020. “The October 2019 Protests in Lebanon: Between Contention and Reproduction.” Civil Society Knowledge Centre. https://civilsociety-centre.org/paper/october-2019-protests-lebanon-between-contention-and-reproduction [last accessed on 9 August 2021].
Alijouni, Salem and Mary Kawar, Mary. 2015. “Towards Decent Work in Lebanon: Issues and Challenges in Light of the Syrian Refugee Crisis.” Beirut: ILO.
Aubin-Boltanski, Emma. 2018. “‘Ummal, Mou’allim w Shawîsh : Travailler dans le tabac : ressources et contraintes.” Intervention at the seminar Aux marges du salariat ? Travailler et contester au Liban. Du travail migrant à la grande distribution. Institut français du Proche-Orient (Ifpo), Beirut, 23 March 2018.
Beneduce, Roberto. 2015. “The Moral Economy of Lying: Subjectcraft, Narrative Capital, and Uncertainty in the Politics of Asylum.” Medical Anthropology. 34 (6): 551-571.
Breman, Jan and Marcel Van Der Linden. 2014. “Informalizing the Economy: The return of the Social Question at the global Level.” Development and Change. 45 (5): 920-940.
Bou Khater, Lea. 2020. “Poverty Targeting is not the Solution for Much Needed Social Policy.” Beirut: Lebanese Center for Policy Studies.
_____ , 2019. "Understanding State Incorporation of the Workers' Movement in Early Post-War Lebanon and its Backlash on Civil Society." Civil Society Knowledge Centre. DOI: 10.28943/CSR.003.003
Castel, Robert. 2003. L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé. Paris: Seuil.
_____ 1995. Les métamorphoses de la société salariale. Une chronique du salariat. Paris: Fayard.
Catusse, Myriam. 2020. Le temps du social. Du Maroc au Liban : une grande transformation, HDR (Habilitation à diriger des recherches) thesis. Paris: EHESS.
Cammett, Melani. 2014. Compassionate Communalism: Welfare and Sectarianism in Lebanon, Ithaca: Cornell University Press.
Cammett, Melani and Sukriti Issar. 2010. “Bricks and Mortar Clientelism: Sectarianism and the Logics of Welfare Allocation in Lebanon.” World Politics. 62 (3): 381-421.
Chalcraft, John. 2009. The Invisible Cage, Syrian Migrant Workers in Lebanon. Stanford: Stanford University Press.
Chaib, André. 1983. L’aventure de la liberté: essai sur le libéralisme économique au Liban. Beirut: Publishing and Marketing House.
Chiha, Michel. 1964. Politique intérieure. Beirut: Éditions du trident.
Corm, Georges. 2003. Le Liban contemporain. Histoire et société. Paris: La Découverte.
Couland, Jacques. 1970. Le mouvement syndical au Liban, 1919-1946: son évolution pendant le mandat français de l’occupation à l’évacuation et au Code du travail. Paris: Éditions sociales.
Crenshaw, Kimberle. 1991. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color.” Stanford Law Review. 43 (6): 1241-1299.
De Bel Air, Françoise. 2017. “Migration Profile: Lebanon.” Robert Shuman Center for Advanced Studies Policy Briefs, 1-21. Florence: European University Institute.
De Vito Christian, G. 2018. “Passato precario. Flessibilitá e precarietá del lavoro come strumenti concettuali per lo studio storico delle interazioni tra rapporti di lavoro.” In Lavoro e coercizione: Il lavoro in una prospettiva di lungo periodo edited by Giulia Bonazza and Giulio Ongaro, 123-162. Palermo: SISLav/NDF.
Dibeh, Ghassan. 2005. “The Political Economy of Post-War Reconstruction in Lebanon.” Series: WIDER Research Paper, No.2005/44. Helsinki: The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER). http://www.rrojasdatabank.info/unurp05/rp2005-44_1.pdf
Dirani, Ahmad. 2021. “Pre- and post-explosion analysis of the Lebanese labor market.” In Évaluation d’impact de l’explosion du port de Beyrouth edited by Bou Nader, Raymond & Hariri, Nizar, 91-107. Beirut: Institut français du Proche-Orient (Ifpo).
El-Nattour, Souheil. 1993. Les Palestiniens du Liban. La situation sociale, économique et juridique. Beirut: Dar al-Taqaddum al-Arabi.
Fioroni, Claudie. 2018. “Micro-politique des revendications pour l’emploi dans le bassin
minier du Sud jordanien.” In Quand l'industrie proteste.
Fondements moraux des (in)soumissions ouvrières edited by Allal Amin et al. 143-164. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
Gates, Carolyn. 1998, The Merchant Republic of Lebanon: Rise of an Open Economy. London: I.B. Tauris.
Hariri, Nizar and Michele Scala. 2019. “Le mouvement syndical libanais à l’épreuve de l’Intifâda du 17 octobre 2019.” Confluences Méditerranée. 111 (4): 135.
Harris, Kevan. 2019. “The Social Question in the Middle East. Past and Present.” In Social Policy in the Middle East and North Africa. The New Social Protection Paradigm and Universal Coverage, edited by Rana Jawad et. al. 188-207. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Hottinger, Arnold. 1966. “Zu'ama' in Historical Perspective.” In Politics in Lebanon edited by Leonard Binder, 85-105. New York: John Wiley & Sons.
Hussein, Walid. 2019. “الحمالون على أبواب السوبرماركت” Legal Agenda Special Issue (July). ليس بالوطنية وحدها تحمي العمالة.
Jawad, Rana, Nicola Jones, and Mahmood Messkoub. 2019. “Introduction.” In Social Policy in the Middle East and North Africa. The New Social Protection Paradigm and Universal Coverage, edited by Rana Jawad et. al. 1-15. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Jureidini, Ray. 2009. “In the Shadows of Family Life: Toward a History of Domestic Service in Lebanon.” Journal of Middle East Women’s Studies. 5 (3): 74-101.
Jureidini, Ray and Nayla Moukarbel. 2004. “Female Sri Lankan Domestic Workers in Lebanon: A Case of ‘Contract Slavery’?” Journal of Ethnic and Migration Studies. 30 (4): 581-607.
Kochuyt, Thierry. 2004. “La misère du Liban : une population appauvrie, peu d'État et plusieurs solidarités souterraines.” Revue Tiers-Monde. 45 (179): 515.
Longuenesse, Élisabeth and Paul Tabar. 2014. “Migrant Workers and Class Structure in Lebanon: Class, Race, Nationality and Gender.” https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01305367/document [last consulted on 11 December 2021].
Longuenesse, Élisabeth, Myriam Catusse and Blandine Destremau. 2005. “Le travail et la question sociale au Maghreb et au Moyen Orient.” REMMM. 1: 15-46.
Marranconi, Filippo Maria and Hala Kerbage Hariri. 2017. “Les services de santé mentale pour les réfugiés syriens. Entre politiques de l’humanitaire et politiques du soin.” Hommes & Migrations 1319 (4): 87-94.
Ne’meh, Adib. 1996. “Slipping through the cracks: Social Safety nets in Lebanon.” Beirut: UNDP.
Picard, Élizabeth. 2001. “Une sociologie historique du za‘īm libanais.” In Mélanges en l’honneur de Toufic Touma edited by Charles Chartouni, 157-172. Paris: Geuthner.
Polanyi, Karl. 2015 (1944). La grande transformation. Paris: Gallimard.
Scala, Michele. 2020. Le clientélisme au travail. Une sociologie de l’arrangement et du conflit au Liban (2012-2017). Ph.D. in Arab and Muslim World. Aix-en-Provence: Aix-Marseille University.
Slaiby, Ghassan. 1999. « في الاتحاد كوّة. بحث عن مشكلات الاتحاد العمالي العام في لبنان . Beirut: Moukhtarat.
Supiot, Alain. 2000. “Les nouveaux visages de la subordination.” Droit social 2: 131-145.
Tarraf-Najib, Souha. 2005. “Travail et déni de travail: les Palestiniens de Tripoli et des camps de réfugiés (Nahr al Bared, Beddawi) au Nord du Liban.” Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 105-106: 283-305.
Thompson, Elizabeth. 2005. Colonial Citizens: Republic and Rights, Paternal Privilege, and Gender in French Syria and Lebanon. New York: Columbia University Press.
Tufaro, Rossana. 2021. “A Historical Mapping of Lebanese Organized Labor. Tracing Trends, Actors and Dynamics.” Civil Society Knowledge Centre.
_____ 2018. Labor and Conflict in pre-War Lebanon: a retrieval of the political experience of the Factory Committees in the industrial district of Beirut (1970-1975). Ph.D. dissertation in History. Venice: Ca’ Foscari University.
Van der Linden, Marcel. 2014. “San Precario: A New Inspiration for Labor Historians.” Labor: Studies in Working-Class History of the Americas. 10 (1): 9-21.
_____ 2008. Workers of the World: Essays Toward a Global Labour History. Leiden: Brill.
Verdeil, Éric. “Émeutes et électricité au Liban.” Le Monde diplomatique, 30 January 2008. 1/30/2008. https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2008-01-30-Liban, [last consulted on 20 August 2019].
Yehya, Hossam. 2015. La protection sanitaire et sociale au Liban (1860-1963). Ph.D. dissertation in Law. Nice: University Sophia Antipolis.
التقارير والمراجع الصحافية
Al-Akhbar. 20/07/2019. جمعة الغضب دعماً للفلسطينيين: بوادر حل حكومي لأزمة العمال (“Angry Friday” in support of Palestinians: signs of government solution to labor crisis”).
Al-Monitor. 7/10/2021. “Lebanon implements ration card program as economic crisis worsens.” https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/lebanon-implements-ration-card-program-economic-crisis-worsens#ixzz7ADbt4jBP [last consulted on 8 October 2021.]
______ 8/1/2021. “Lebanon’s parliament backs $556M cash subsidy.” https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/lebanons-parliament-backs-556m-cash-subsidy [last consulted on 8 October 2021.]
Centre for Social Sciences Research and Action. 2020. “Social Protection in Lebanon: The National Social Security Fund (NSSF).” https://civilsociety-centre.org/content/social-protection-lebanon-national-social-security-fund-nssf-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 [last consulted on 20 October 2021]
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 2021. “Multidimensional Poverty in Lebanon (2019-2021). Painful Realities and Uncertain Prospects.” https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/21-00634-_multidimentional_poverty_in_lebanon_-policy_brief_-_en.pdf
International Labor Organization (ILO). 2021. “Vulnerability and Social Protection Gaps Assessment – Lebanon.” ILO Prospects.
___ 2019. “Femmes et hommes dans l’économie informelle: Un panorama statistique (troisième édition).”
___ 2017. “Employer-Migrant Worker Relationships in the Middle East: Exploring Scope for Internal Labour Market Mobility and Fair Migration.” White Paper, ILO, Beirut.
ILO and UNICEF. 2021. “Towards a Social Protection Floor for Lebanon.” Policy note, Beirut.
ILO and CAS. 2018-2019. “Labour Force and Household Living Conditions Survey 2018-2019, Lebanon.”
Khalifeh, Paul. 9/24/1997. “État-CGTL : cinq années de confrontation (I) Le traumatisme des émeutes du 6 mai 1992.” L’Orient-le jour.
Lebanon Humanitarian INGO Forum (LHIF). 2021. “Slipping through the Cracks. The Limitations of Response in Palestinian Communities in Lebanon.” https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FINAL-Slipping%20Through%20The%20Cracks-LHIF%20Briefing%20Paper-June%202021.pdf [last consulted on 10 October 2021]
Lebanese Labor Watch (LLW). 2013. المياومون في الإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات. انتهاك لحقوق العمال وتجاوز للقوانين (Daily-workers within public administrations, autonomous offices and municipalities. Rights Violations and Law Circumvention). Beirut: Lebanese Labor Watch-Diakonia.
L’Orient-le jour. 2/12/2021. “Nouveau faux départ pour la carte d’approvisionnement.”
_____ 9/6/2021. “La seule école pour autistes met la clé sous la porte.”
_____ 10/23/2021. “As import subsidies gradually end, delays mire two major programs to support the country’s most vulnerable.”
Terre des Hommes. 2014. “The Dom People and their Children in Lebanon.” https://www.insanassociation.org/en/images/The_Dom_People_and_their_Children_in_lebanon.pdf [last consulted on 4 October 2021]
United Nations Children's Fund (UNICEF) and the Ministry of Social Affairs (MOSA). 2019. “Social Protection in Lebanon: A Review of Social Assistance.”
World Bank (WB). 2020. “Lebanon Economic Monitor. The Deliberate Depression. Fall 2020.”
___ 2019. “Rapport sur le développement dans le monde: Le travail en mutation.”
___ 2011. “The Challenge of Informality in the Middle East and North Africa.”






