تم تطوير موجز السياسات هذا بالاستناد إلى تقرير معمٍق بعنوان: ”بين إقصاء الكيانات السياسية وأعباء األدوار االجتماعية للنساء: دراسات حالة من لبنان“؛ بالإضافة إلى مناقشات وأفكار جمعت أثناء ورشة عمل تشاورية أقيمت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وتميزت بمشاركة النساء اللواتي شاركن في البحث، بالإضافة إلى ناشطات وممثلات عن منظّمات المجتمع المدني وأكاديمييات.
استناداً إلى هذه الدراسة، الهدف من موجز السياسات المعروض هنا مزدوج. فهو أولا يعرض النتائج الرئيسية للدراسة، وثانياً يقترح توصياتٍ عملية للفاعلين على المستوى الكلّي (الحكومة اللبنانية، النخبة السياسية) والمستوى المتوسط (المجتمع المدني المحلّي والدولي الأوسع في لبنان؛ منظّمات المجتمع المدني؛ الحركات؛ النقابات) والمستوى الجزئي (تجارب النساء الفردية)، للمساعدة في التصدي للعوائق التي تواجهها المرأة.
بالإضافة إلى ذلك، طوّر مركز دعم لبنان رسم بياني مبني على نتائج البحث:"العوائق التي تعرقل المشاركة السياسية الكاملة للمرأة في لبنان"
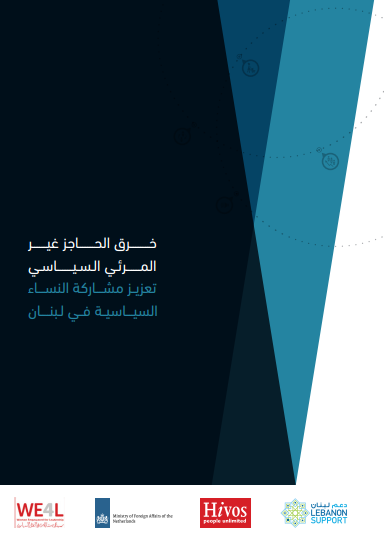
مقّدمة
لقد مر أكثر من ستين عاماً منذ أن اكتسبت المرأة في لبنان الحق في الانتخاب في العام ١٩٥٣،1 لكن لم يتجاوز عدد النساء اللواتي ُفزن في آخر انتخابات نيابيةٍ لبنانيةٍ ست نساء من أصل ١٢٨ نائباً، وهي الانتخابات التي جرت في السادس من شهر أيار/مايو ٢٠١٨، ويشكلن نسبة صاعقة بلغت ٤٬٦ بالمئة.2 على نحو مماثل، ُذكر بأن نسبة النساء في المواقع الوزارية كانت ٣٬٤ بالمئة3. في العام ٢٠١٧، إحتل لبنان المرتبة ١٣٧ بين ١٤٤ بلداً ـ والمرتبة ١١ بين ١٤ بلداً عربياً ـ في مؤشر الفجوة بين الجنسين.4 تظهر هذه الأرقام والمؤشرات أن السياسة اللبنانية تواصل كونها عالماً ذكورياً متحيزاً ضد المرأة، تمثيل النساء فيه ناقص. عموماً، ُنسب عدم قدرة المرأة على اختراق الحاجز غير المرئي السياسي في لبنان إلى عوامل بنيوية كلية، بما فيها النظام اللبناني الطائفي،5 وتفشي النزعة العائلية السياسية6 والزبائنية، ونجد نظام الزعامة بوصفه أحد آلياتها.7 ويمكن المجادلة في أن هذه العوامل الثلاثة تساهم معاً في توسيع الفجوة بين الجنسين بطريقتين. أولاً، إنها تعيق تشكيل برامج الرعاية الاجتماعية التي ترعاها الدولة، وتعزز دور الجهات الفاعلة الخاصة والأحزاب الطائفية في توفير الرعاية الاجتماعية.8 إن توزيع الأحزاب الطائفية للمنافع الاجتماعية في لبنان محددٌ بحساباتها الخاصة بالاعتبارات الانتخابية وقدرتها على الحشد.9 وتقلص الأنماط غير المنتظمة للحماية الاجتماعية من احتمالات مشاركة المرأة 10في السياسة، ولاسيما عندما تواصل العمل بشروطٍ هشةٍ وترغم على ترك عملها من أجل مسؤولياتها في رعاية الأطفال.
ثانياً، تحول العلاقات الزبائنية المقامة على طول الخطوط النسَبية الأبوية والمذهبية دون تجديد النخبة السياسية 11 ، وتمنع بالتالي دخول المرأة إلى المجال السياسي (باستثناء بعض النساء اللواتي ينتمين إلى عائلاتٍ سياسية، يسمح وجود قرابةٍ ذكريةٍ فيها بصعودهنّ إلى السلطة).
إضافةً إلى ذلك، تواصل السلطات الدينية تحكّمها بقوانين الأحوال الشخصية، فتنظّم شؤوناً كالزواج والطلاق والوصاية الأمومية، وتجعل الرجال في كثيرٍ من الأحيان قوّامين على النساء 12 . تقترح دراساتٌ أخرى تفسيراتٍ ثقافية لنقص تمثيل النساء 13 ، ولاسيّما المعايير الاجتماعية البطريركية التي تحكم المجتمع اللبناني وتقيّد المرأة بأدوارها الأكثر “تقليديةً” 14 . وفي حين أنّ هذه التفسيرات تقدّم رؤىً متعمّقةً في البنى على المستوى الكلي، فهي تفشل في تسليط الضوء على تجارب المرأة الشخصية لهذه البنى ضمن المؤسّسات السياسية.
لمعالجة هذه الثغرة ومن أجل مزيدٍ من الكشف عن العناصر الكامنة التي تعيق مشاركة المرأة السياسية في لبنان على المستويين الدستوري (المتوسط) والفردي (الجزئي)، أجرى مركز دعم لبنان ونشر دراسةً متجذرةً وتشاركيةً بعنوان “بين إقصاء الكيانات السياسية وأعباء الأدوار الاجتماعية للنساء: دراسات حالة من لبنان” 15 . تفحّصت الدراسة أربعة كياناتٍ في لبنان: حزباً سياسياً (القوات اللبنانية) وحركةً اجتماعية (“طلعت ريحتكم(”ونقابةً (نقابة المعلّمين) ومنظّمة مجتمع مدني (الاتّحاد اللبناني للأشخاص ذو إعاقات جسديّة) 16 . عبر مراجعة الوثائق الرسمية الخاصّة بهذه البنى والخطاب العام والممارسات، وكذلك التجارب والتحدّيات الخاصّة بالنساء المنخرطات في هذه الكيانات، حلّلت الدراسة العراقيل التي تعيق ممارسة النساء السياسية الكاملة. وبذلك، استخدم البحث منهجية دراسة الحالة باستخدام مقابلاتٍ شبه منظّمة ( 35 ) ومجموعات مناقشة ( 7) من أجل جمع البيانات بين تموز/يوليو 2017 ونيسان/أبريل 2018
استناداً إلى هذه الدراسة، الهدف من موجز السياسات المعروض هنا مزدوج. فهو أوّلاً يعرض النتائج الرئيسية للدراسة، وثانياً يقترح توصياتٍ عمليةً للفاعلين على المستوى الكلّي (الحكومة اللبنانية، النخبة السياسية) والمستوى المتوسّط (المجتمع المدني المحلّي والدولي الأوسع في لبنان؛ منظّمات المجتمع المدني؛ الحركات؛ النقابات) والمستوى الجزئي (تجارب النساء الفردية)، للمساعدة في التصدّي للعوائق التي تواجهها المرأة.
العوائق التي تعرقل المشاركة السياسية للمرأة: التمييز والإقصاء والإبعاد
أظهرت الدراسة أنّ ثلاثاً من البنى السياسية المختارة حزب القوات اللبنانية وحركة “طلعت ريحتكم” ونقابة المعلّمين غير مرحّبة عموماً بالنساء في ما يخصّ تسهيل وصولهنّ إلى الأدوار القيادية.
أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1990)، كان معظم النساء اللواتي انتسبن إلى القوّات اللبنانية مقيّداتٍ بدوري ربّة المنزل وتقديم الرعاية ضمن الأدوار التقليدية للمرأة. تضمّنت المسؤوليات التي تولّينها الطبخ وتقديم الإسعافات الأوّلية وإدارة مراكز رعاية الأطفال 17 . وعلى الرغم من تزايد أهمّية الأدوار للبعض، فإنّ بعض شخصيات نساء القوات اللبنانية احتللن مواقع تتعلّق بالأمن 18 والتنظيم المباشر للحراكات عندما أصبحت الحركة السياسية التابعة للحزب محظورةً ( 1994 - 2005 )، فإنّ المرأة الوحيدة التي شاركت في قيادة الحزب كانت ستريدا جعجع، زوجة قائد الحزب سمير جعجع. وهذا يبرِز دور الروابط السياسية العائلية وعلاقات القربى في تسهيل صعود النساء المتزوّجات من رجالٍ سياسيين إلى مواقع قيادية.
حتى بعد أن تمأسست القوات اللبنانية كحزبٍ رسمي ذي برنامجٍ سياسي في العام 2012 ، بقيت فرص حصول النساء على مواقع قيادية فيه محدودة. على سبيل المثال، يحتلّ الرجال معظم المواقع على مستوى القواعد من قبيل “مسؤول مركز” أو “مسؤول منطقة” في مكاتب الحزب في أرجاء لبنان، فقيادة الحزب تفضّلهم استناداً إلى قدرتهم المزعومة على تحصيل أصواتٍ أكثر، ولاسيّما أثناء المواسم الانتخابية 19 . إضافةً إلى ذلك، تعتمد تسمية النساء في الانتخابات على تحالفات الحزب الانتخابية والمذهبية، ما أدّى إلى تسمية الحزب لمرشّحين كانوا قريبين من الفوز بالمقاعد البرلمانية؛ في معظم الحالات، هؤلاء المرشّحون رجال20.
“إذا أثبتت امرأةٌ ما وجودها على الأرض، فسوف يضمن الحكيم تسميتها في موقعٍ قيادي”
ممثّلة عن القوات اللبنانية في الاجتماع التشاوري، بيروت، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
على وجه العموم، ومن منظورٍ خارجي، تبدو القوّات اللبنانية تقدّميةً من حيث المساواة بين الجنسين، نظراً لأنّ لديهم امرأةً عضواً في البرلمان، وقدّموا عدّة مرشّحاتٍ أثناء انتخابات العام 2018 النيابية، ولأنّ امرأةً تحتلّ منصب الأمين العامّ. علاوةً على ذلك، تدافع القوّات اللبنانية علناً عن إجراء إصلاحاتٍ تشريعيةٍ تتعلّق بحقوق المرأة، بما في ذلك تعديل المادّتين 503 و 504 من قانون العقوبات اللبناني بخصوص الاغتصاب الزوجي، وتدعم مشروع قانونٍ ضدّ تزويج الأطفال والطفلات. في الوقت عينه، يبدو الخطّ السياسي للحزب كأّنه يقوّض بوضوحٍ إصلاحاتٍ أخرى، كإصلاح قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الجنسية. إضافةً إلى ذلك، ليس للقوّات اللبنانية موقفٌ واضحٌ حول تطبيق مبدأ الحصص النسائية 21 ، ما يُظهر عدم التجانس المتأصّل في موقف الحزب من قضايا المرأة.
هذا التنافر ملموسٌ أيضاً عبر تحدّياتٍ أخرى تواجهها النساء المنخرطات في حزب القوّات اللبنانية. ففي حين يحاولن الموازنة بين واجباتهنّ المنزلية ونشاطاتهنّ السياسية، تجد بعض النساء أنفسهنّ أمام الاختيار بين أعبائهنّ العائلية (بما في ذلك رعاية الأطفال) والتزامهنّ بحضور الاجتماعات الحزبية التي عادةً ما تنعقد في ساعاتٍ متأخّرة وتدوم وقتاً طويلًا.
لقد نظرنا إلى نمطٍ آخر من المنظّمات، فأردنا قياس ما إن كانت الحركات الاجتماعية تقدّم بيئةً أكثر ملاءمةً لمشاركة المرأة. وقد تركّز اهتمامنا على إحدى آخر حركات الاحتجاج في لبنان: “طلعت ريحتكم”. تبنّت هذه المجموعة نموذجاً أفقياً للتنظيم بهدف السماح بقيادةٍ وتمثيلٍ تشاركيين، ولتجنّب تحدّيات التراتبية التي تحصر صنع القرار بقلّةٍ محدودة 22 . غير أنّ ديناميات السلطة ضمن المجموعة أدّت إلى استبعاد الشباب، ولاسيّما الشابّات، على غرار البنى الأفقية التي دُرست سابقاً 23 وفي مواقع أخرى 24 . هكذا يبدو أنّ النموذج الأفقي المتبنّى فشل في تحقيق أهدافه العريضة في مشاركةٍ أوسع وأكثر شمولًا 25 : سيطر الرجال الذين لديهم تجارب التزامٍ سياسيٍّ سابقٍ على صنع القرار ضمن الجماعة. وقد تفاقم هذا الميل عندما انضمّت شخصياتٌ سياسيةٌ وممثّلون عن الأحزاب إلى الحملة، حيث هيمنوا على النقاش في السجالات وقاطعوا مداخلات النساء واستخفّوا بمداخلاتهنّ وشكاويهنّ .26
“كان من الضروري صرف النظر عن قضايا وحوادث التحرّش الجنسي لأنّنا خشينا من أنّها ستهدّد الحركة ككلٍّ وتخيف الناس من التحرك والانضمام إلى الحركة”.
ممثّلة في “طلعت ريحتكم” في اللقاء التشاوري، بيروت، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .
تحتاج هذه القضايا إلى معالجةٍ على مستوىً هيكلي، وليس على مستوىً شخصي غير رسمي. ففي حين أنّ النساء في الحملة قد لعبن أدواراً ملموسةً في نقل البيانات الإعلامية 27 وفي مواجهة قوّات الأمن أثناء المظاهرات، قالت الناشطات اللواتي قوبلن بأنّ النساء قد مُنحن أدواراً باديةً للعيان لإدامة فكرة أنّ الحملة تشمل النساء. وقد اعتبرت الناشطات هذا الشمول تجميلياً لأنّ النساء نادراً ما كنّ يُمنحن الفرصة للمساهمة في هذه البيانات 28 . فضلًا عن ذلك، وخلال مشاركة النساء في الحملة، قابلن خطاباً أكّد على هشاشتهنّ وضعفهنّ وحاجتهنّ لحماية الرجال لهنّ، ولاسيّما أثناء المواجهات مع قوّات الأمن في الاحتجاجات.
هنالك بنيةٌ تنظيميةٌ أخرى تفحّصناها هي نقابة المعلّمين. فعلى الرغم من أنّ النساء يشكّلن 75 بالمئة 29 من بين أعضاء النقابة، فلم تُنتَخب سوى امرأة واحدة إلى المجلس التنفيذي 30 . وهذا يكشف الفجوة الواسعة في التمثيل الجندريٍ داخل الاتّحاد. على سبيل المثال، تفتقر النقابة إلى لوائح وإجراءاتٍ داخليةٍ واضحة؛ والتواصل بين مجلسها التنفيذي ومجالس مكاتب الفروع متوتّر؛ كما أنّ الانتخابات الداخلية استندت أساساً على التحالفات الحزبية والطائفية 31 ؛ إضافةً إلى تدخّلاتٍ أخرى، ولاسيما من إدارات المدارس. ففي حين أنّ إدارات المدارس لا تشجّع المعلّمين على الانضمام إلى النقابة كيلا يتحرّكوا ضدّها، فإنّ الأحزاب السياسية تسيطر على كيفية تشكيل التحالفات الانتخابية في النقابة 32 ، إلى درجة الطلب من المرشّحات الانسحاب إن لزم الأمر 33.
واجهت المعلّمات تحدّياتٍ ترتبط بالخطاب. فأثناء اجتماعات النقابة، نادراً ما أخذ زملاؤهنّ من الرجال وجهات نظرهنّ واقتراحاتهنّ بالحسبان، وكثيراً ما علّقوا على لباسهنّ أو حديثهنّ.
“كثيراً ما امتُدحنا على أنّ حضورنا ‘يجمّل’ الاجتماعات”
معلّمة أثناء مقابلة، بيروت، 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .
لقد عبّرت النساء الناشطات سياسياً في النقابة عن أّنهنّ كثيراً ما يتعرّضن للانتقاد من محيطهنّ، من قبيل أنّ التزامهنّ يصرف انتباههنّ عن واجباتهنّ المنزلية. وكثيراً ما يرغمهنّ الضغط المتزايد الذي يواجهنه إلى الانسحاب من المشاركة السياسية أو البقاء من دون فعّاليةٍ في النقابة. وثمة تحدّياتٌ أخرى عبّرن عنها، بما فيها الموازنة بين التزامهنّ وبين أدوارهنّ الرعائية في المنزل؛ والضغط الذي تمارسه إدارات المدارس كيلا ينضممن بنشاطٍ إلى النقابة؛ وافتقارهنّ الشخصي للثقة في النقابة للدفاع عن حقوقهنّ.
أخيراً، خضنا في تفحّص الاتّحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً، بوصفه هيئةً غير حكومية. يمكن اعتبار هذا الاتّحاد أكثر الهيئات شمولًا لمشاركة المرأة، سواءٌ خارج المنظّمة أم داخلها. وبالفعل، تضمّ المنظّمة كثيراً من النساء، كما أنّ رئيستها امرأة. غير أنّ الرجال سيطروا على مجالسها التنفيذية؛ فمن أصل اثني عشر عضواً، لم يتجاوز عدد النساء على مرّ السنوات امرأةً أو اثنتين 34 . وقد نسبت الناشطات من الاتّحاد هذا الإقصاء إلى “انعدام الخبرة السياسية” المزعوم لدى النساء، وهي الحجّة التي يقدّمها عادةً الأعضاء الذكور في المجلس 35 . عاوةً على ذلك وعلى الرغم من توسّع الاتّحاد عبر الأراضي اللبنانية وإقامة مكاتب له في الشمال والجنوب، تبقى نشاطاته متمركزةً في بيروت. وهذا الأمر يعرقل مشاركة النساء، بما في ذلك ذوات الدخل المنخفض، من المناطق الهامشية، ويعزلهنّ عن عملية اتّخاذ القرار.
يظهِر البحث أنّ النساء والفتيات ذوات الإعاقة يختبرن تمييزاً مزدوجاً أوّلًا لأّنهنّ نساء، وثانياً لأّنهنّ ذوات إعاقة ما يؤّثر في رغبتهنّ في المشاركة في الحياة السياسية والعامّة لتجنّب وصمهنّ اجتماعياً 36 . يتجلّى هذا التمييز المزدوج في البيت بخاصّة. وقد شرحت النساء من ذوات الإعاقة كيف يمكن أن يمنعهنّ التحكّم الذي تمارسه عائلاتهنّ/أو شركاؤهن من اتّخاذ قراراتٍ شخصية، ويؤّثر بالتالي في قدرتهنّ على الالتزام سياسياً 37 . يبدو أنّ الدعم العائلي حاضرٌ وباقٍ طالما أنّ المرأة تقوم بعملٍ مأجورٍ وتستطيع مساعدة عائلتها مالياً، لكنّه يتوقّف عندما تريد المرأة ذات الإعاقة التطوّع في نشاطاتٍ عامّةٍ أو سياسية. يُنظَر إلى هذه النشاطات كمصدرٍ للخطر المحتمل لأّنها تقتضي السفر والخروج من المنزل، ما يجعل المرأة ذات الإعاقة أكثر عُرضةً للتحرّش الجنسي. تشير نتائج البحث الذي اتُّخذ في هذه الكيانات الأربع إلى أنّ قضية العنف على أساس النوع الاجتماعي، ولاسيّما التحرّش الجنسي، لم تعالج معالجةً كافيةً في الوثائق الداخلية والخطابات العامّة العلنية. على سبيل المثال، تجاهلت حملة “طلعت ريحتكم” حوادث التحرّش الجنسي كيلا تتعرّض الحكومة بالسوء لسمعة الحركة. كذلك، لم يضع الاتّحاد اللبناني للأشخاص ذو الإعاقات الجسدية أيّ تدابير أو إجراءاتٍ لمعالجة حوادث التحرّش الجنسي تجاه النساء ذوات الإعاقة، على الرغم من أّنهنّ يُعتبَرن من بين أكثر المجموعات تعرّضاً للتحرّش الجنسي.
التوصيات
استناداً إلى التحليل النوعي المتعمّق، بالإضافة إلى مناقشة نتائج البحث مع المشاركين فيه أثناء ورشة عملٍ تشاورية، يقترح موجز السياسات هذا التوصيات التالية لمختلف الفاعلين المعنيين. التوصيات أدناه منظّمةٌ على مستوى السياسات؛ وعلى المستوى المؤسساتي؛ وعلى المستوى الفردي. غير أنّ موجز السياسات هذا يرغب في التشديد على أنّ اقتراح التوصيات على المستوى الفردي يجب أن يُقرأ ضمن سياق التقييدات المؤسساتية والسياسية، وكذلك بوصفه دينامياتٍ وتكيّفاً للقوّة تستند إلى النوع الاجتماعي.
التوصيات على مستوى السياسات
على المدى القصير، يجب على الحكومة اللبنانية:
- توفير بياناتٍ كمّيةٍ ونوعيةٍ محدّثة عن التمييز بين الجنسين ومؤشّراتٍ خاصّةٍ بالنوع الاجتماعي في لبنان، بما فيها بياناتٌ حول النساء في سوق العمل وقطاع التعليم 38 . سوف يوفّر ذلك تدخّلاتٍ أفضل توجيهاً وتأثيراً بتركيزها على التمكين السياسي للنساء.
- إبطال و/أو مراجعة كافّة القوانين التمييزية ضدّ النساء والفتيات، كالقوانين التي تتعلّق بالحوكمة السياسية، ولاسيّما قانون الجمعيات وقانون الانتخابات وقانون العاملين في الخدمة المدنية، وذلك بهدف ضمان أن تكون مراعيةً لمسألة النوع الاجتماعي. كما يجب أن تخضع قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والتي لا تزال تميّز بين النساء والرجال لإصلاحاتٍ صارمة، وكذلك القوانين والقواعد التي تؤثّر في شروط المرأة الاجتماعية الاقتصادية، كالقوانين التي تستهدف القطاعات غير المشمولة بالضمان كالزراعة وإجازة الأمومة والضمان الصحّي وغيرها. عاوةً على ذلك، يجب إصدار قانونٍ يجرّم التحرّش الجنسي في الفضاءين الخاصّ والعامّ (كأماكن العمل(.
- القيام بالإصلاحات القانونية اللازمة لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تقديم حصّة نسائية )مؤقّتة)، ولاسيّما في الانتخابات المحلّية والبرلمانية ووضع آلياتٍ فعّالة وذات كفاءة لضمان تطبيقها، وكذلك بالتوافق مع المعاهدات الدولية.
- حثّ الأحزاب المستندة إلى الدين على دعم مثل هذه الحصص. سيؤدّي ذلك إلى تحسين صورتها الدولية 39 ، وكذلك مكاسبها الانتخابية على المستوى الوطني.
- تقدير وتقييم الأثر المترتّب على البرامج التي وضعتها الحكومة اللبنانية والتي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية (برعاية وزارات الشؤون الاجتماعية والصناعة والعمل)، والنساء (برعاية اللجنة الوطنية للنساء اللبنانيات ووزارة شؤون المرأة(؛
- البدء بإدراج الإجراءات الرامية إلى تعميم المنظور الجندري 40 المستندة إلى الحاجات المنهجية في كافّة المؤسّسات والوكالات الحكومية للمساعدة، في غرس شمولية النوع الاجتماعي عبر مقاربةٍ من القمّة إلى القاعدة.
- تسريع عملية دمج النظام التعليمي في لبنان لضمان الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، بمن فيهم النساء، ما سيساهم في تمكينهم الشخصي والسياسي على المدى الطويل.
على المدى القصير، يجب على المانحين الدوليين:
- الربط بين الدعم التمويلي المستمرّ وتطبيق تغييرات السياسات والتعديات القانونية المتعلّقة بالعدل والمساواة بين الجنسين.
- دعم الحكومة اللبنانية في إقامة برامج حماية اجتماعية عادلة ومنصفة وشاملة، تأخذ بالحسبان النساء والأقلّيات )الأشخاص المعوّقين حركياً والأقلّيات الجنسية والعمّال المهاجرين وغيرهم(.
- دعم منظّمات المجتمع المدني المحلّية في زيادة تمثيل المرأة عبر تمويل برامج تمكين المرأة، ولاسيّما في المناطق اللبنانية المهمّشة؛ دعم البرامج المتعلّقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسهم النساء والأطفال.
- تقييم تدفّقات التمويل الذي تقدّمه وجدول أعمالها بصورةٍ مستمرّةٍ ومدروسة، وكذلك توافقها مع الحاجات على أرض الواقع.
“يرى كثيرٌ من الرجال المسنّين ممّن قاتلوا في السابق في الحزب مواقعهم الحالية بوصفها مكافأةً على سنوات التزامهم، وهم يشعرون بأن الشابات الأكثر تأهياً لهم تهدّدهم”.
ممثّلة عن القوّات اللبنانية في الاجتماع التشاوري، بيروت، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .
على المدى القصير، يجب على الأحزاب السياسية:
- إتاحة بياناتٍ كمّيةٍ ونوعيةٍ محدّثة حول التمييز بين الجنسين في عضوية الحزب.
- وضع سياساتٍ وإجراءاتٍ داخليةٍ للتبليغ عن التحرّش والإساءة الجنسيين والتحقيق فيهما ومعالجتهما، ولخلق فضاءٍ آمنٍ للنساء داخل الحزب.
- تعميم منظور النوع الاجتماعي 41داخلياً، ولاسيّما عبر وضع حصّةٍ للمرأة لتعزيز تمثيلها ومساعدتها في مراكمة الخبرة المطلوبة للمناصب البلدية والبرلمانية. كما يمكن أن يتمّ ذلك عبر توسيع فرص المرأة في شغل مناصب قاعديةٍ للمساعدة في كسر الحواجز المجتمعية حول السياسة بوصفها “عالماً للرجال”، وذلك عبر تخصيص حصصٍ مؤقّتة لمثل هذه المناصب. ثمة مثالٌ آخر على تعميم منظور النوع الاجتماعي ومراعاته، وهو وضع جدولٍ زمنيٍّ للنشاطات والاجتماعات والمناسبات في أوقاتٍ تناسب الرجال والنساء معاً، لتسهيل حضور النساء ومشاركتهن.
- توعية أعضاء هذه الأحزاب بالمقاربات والمبادئ المستندة إلى حقوق الإنسان، وكذلك على تعميم منظور النوع الاجتماعي .42
- إشراك الرجال، ولاسيّما من الأجيال الأكبر سنّاً، في قضايا تتعلّق بحقوق المرأة وكذلك بمشاركتها السياسية.
- تعزيز مشاركة الشباب في سياسة الحزب عبر إقامة ترتيباتٍ وآلياتٍ لاتّخاذ القرار تكون أكثر شمولًا لهم. التعاون مع المنظّمات النسوية، وكذلك الأحزاب السياسية الأخرى، في مجال المطالب والأولويات النسوية الواسعة بعيداً عن الخطوط والانتماءات المذهبية.
"تتعثّر هيئاتٌ شعبيةٌ كثيرةٌ بقضية التحرّش الجنسي وتتفكّك بعد حصول مثل هذه الحوادث. يجب عدم التعامل مع هذا الأمر بطريقةٍ غير رسمية، بل معالجته على المستوى الهيكلي".
مشارِكة نسوية في الاجتماع التشاوري، بيروت، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .
على المدى القصير، يجب على منظّمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية:
- إتاحة بياناتٍ كمّيةٍ ونوعيةٍ محدّثة عن التمييز بين الجنسين بين الأعضاء والعاملين.
- تعميم منظور النوع الاجتماعي 43 وإعادة النظر في بنية الحملة الأفقية وتقييمها. يمكن فعل ذلك عبر إعداد الأدوار والتكليفات، وكذلك عبر آليات التحقّق والتوازنات، وذلك لضمان إنجاز أهداف هذه البنى في المساواة والمشاركة. يجب أن يتمّ ذلك بخاصّةٍ عبر تبنّي قواعد سلوكية (حتّى في البنى غير الرسمية) تضمن معالجة قضايا المرأة بخاصّةٍ في استراتيجياتها ووضع برامجها ومشاريعها، سواءٌ على نحوٍ شامل أم بطريقةٍ أكثر استهدافاً. كذلك، ينبغي إتاحة إجراءاتٍ وترتيباتٍ تحمي المرأة من العنف الجنسي، ولاسيّما أثناء مشاركتها في النشاطات في الشارع، وخلق قنوات دعمٍ للناجيات.
- توعية أعضائها وقواعدها بالمقاربات والمبادئ المستندة إلى حقوق الإنسان، وكذلك تعميم منظور النوع الاجتماعي.
- تبنّي مقاربةٍ تستند إلى حقوق الإنسان عبر بنيتها واستراتيجيتها ووضع برامجها ومشاريعها وتواصلها، وكذلك مع جمهورها والمستفيدين منها. يمكن فعل ذلك عبر تبنّي حصصٍ نسبيةٍ تضمن المشاركة العادلة للجميع، بمن فيهم النساء والأقلّيات الأخرى.
- إلغاء المركزية عن النشاطات وتفضيل حضور الأعضاء من المناطق المهمّشة لضمان إشراك كافّة الأعضاء.
- الاعتراف بالتمييز المزدوج الذي تتعرّض له النساء ذوات الإعاقة الجسدية ومعالجته، وإدماجهنّ في برامجها وخططها واستراتيجياتها.
- التعاون مع حركاتٍ اجتماعيةٍ واتّحاداتٍ وأحزابٍ سياسيةٍ أوسع لتحسين الشروط البيئية لمشاركة النساء السياسية، بما في ذلك منحهنّ وصولًا مفتوحاً لأدوار القيادية.
على المدى القصير، يجب على النقابات:
- إتاحة بياناتٍ كمّيةٍ ونوعيةٍ محدّثة عن التمييز بين الجنسين بين أعضاء النقابة.
- وضع وتبنّي هيكليةٍ تنظيميةٍ داخليةٍ فيها أدوارٌ ومسؤولياتٌ وواجباتٌ واضحة. تحتاج هذه الهيكلية إلى أن تكون مراعيةً للنوع الاجتماعي بحيث تضمن منح النساء فرصاً متساوية في القيادة، وكذلك تبنّي حصّةٍ جندريةٍ واضحة
- إعادة تحديد العلاقة بين المجلس التنفيذي للنقابة وفروعها لضمان حقوق التصويت لأعضاء مختلف الفروع وضمان التمثيل العادل وتجنّب تمركز السلطة.
- تعميم منظور النوع الاجتماعي 44 عبر وضع سياساتٍ وإجراءاتٍ كفيلةٍ بمعالجة التحيّز الجنسي والتحرّش الجنسي والإساءة ضمن النقابة.
- تفعيل دور النقابة في معالجة المطالب الأوسع الاقتصادية وغيرها من المطالب للمعلّمين، ولاسيّما المعلّمات.
- ضمان إدراج المطالب الخاصّة بالنساء في جدول أعمال النقابة، وكذلك في استراتيجيتها ونشاطاتها في الضغط (الأجر المتساوي، إجازة الأمومة، الحماية الاجتماعية، الحماية من الصرف التعسّفي، ساعات العمل بشكلٍ مخالفٍ للقانون، التمييز في المستحقّات المالية، رعاية الأطفال، الأجور المتدنّية، الصرف من العمل في حالة الحمل، مخالفة القانون في ما يتعلّق بإجازة الأمومة (بعض المدارس لا تعطي المعلّمة أكثر من 15 يوم إجازة)، التمييز ضدّ النساء في ما يتعلّق بضمان الزوج أو الأولاد، التمييز في ما يتعلّق بالتنزيل الضرائبي، الحصول على تعويض التقاعد من صندوق التعويضات وإلزام أن تكون المعلّمة متزوّجة، عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي والصحّي، وغيرها من القضايا(.
- تأسيس وحدةٍ أو حلقة اتّصالٍ تعالج بفعاليةٍ الانتهاكات التي تستهدف النساء في المدارس. الانخراط في التجارب النقابية الحديثة غير المتحزّبة والبناء على الدروس المستفادة من مثل هذه التجارب. الوصول إلى جمهورٍ أوسع لتوسيع قاعدة العضوية وتفعيل الأعضاء الحاليين عبر التعاون معهم خارج إطار المواسم الانتخابية.
- تفعيل دور فروع النقابة ومدخلاتها في المناطق اللبنانية لضمان مشاركةٍ أكبر من المناطق المحيطية.
- تسوية وضع الأعضاء من ذوي العضوية المزدوجة في النقابة وفي حزبٍ سياسي، وذلك لضمان عدم تغلّب المصالح الحزبية على مصالح النقابة.
“نحن نحتاج إلى مأسسة النوايا ‘الحسنة’، لأنّ الحلول لا يمكن أن تكون فردية”.
ممثّلة عن منظّمة مجتمع مدني محلّية في الاجتماع التشاوري، بيروت، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .
توصيات على المستوى الفردي
على المدى القصير، يجب على المرأة في لبنان:
- السعي للحصول على دعمٍ نفسي عندما تتعرّض لأشكالٍ من العنف والتحرّش الجنسيين.
- التبليغ عن حوادث التحرّش الجنسي التي تتعرّض لها في مكان العمل والفضاءات الخاصّة، وكذلك في الفضاءات العامّة عبر الآليات المتاحة (المنظّمات غير الحكومية التي تقدّم الدعم القانوني والمأوى، ومراكز الاستماع والاستشارة التابعة للمنظّمات غير الحكومية، وخطوط الطوارئ التطوّعية، وكذلك القنوات القانونية عندما يكون ذلك ممكناً، وما إلى ذلك(.





